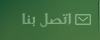درس الفقه | 082
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
هنا عدة تنبيهات:
التنبيه الأول: يمكن القول بأن التوقيع الذي نقله محمد بن جعفر الأسدي ليس صغرى للكبرى التي طرحها السيد الصدر «قده». باعتبار ان ظاهر ما نقله الصدوق في إكمال الدين: أن الناقل للتوقيع هو نفسه محمد بن جعفر الاسدي، وليس هناك واسطة بينه وبني الإمام أو السفير. حيث عبارة إكمال الدين، هكذا: «عن محمد بن جعفر الاسدي، قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدر، ألخ...» وليست العبارة: «كان فيما ورد على الشيخ ابي جعفر». وليس: «في جواب مسائلي». اذن الناقل محمد بن جعفر الاسدي وهو ثقة بحسب نص النجاشي عليه، والواسطة بين محمد بن جعفر وبين الصدوق اربعة من مشائخه، فإذا وثقناهم تمت سند الرواية بلا شيء آخر. فنقول: بما ان هؤلاء المشائخ ممن ترتضى عليهم الصدوق جميعا، فلا يحتمل ان لا يكون في أحدهم ثقة. فلأجل ذلك: نحرز تمامية سند هذا التوقيع، مع غض النظر عمّا ذكره السيد «قده». لأن السيد الخوئي قال: واضحة الضعف، كأنه لا يوثق جميع المشايخ الاربعة.
التنبيه الثاني: يمكن توثيق جميع رواة التوقيعات بكلام الشيخ في الغيبة، بلا حاجة لما أفاده السيد الشهيد «قده». حيث ورد في الغيبة: «إن التوقيعات من صاحب الأمر لا ترد الا على الاتقياء الورعين» فهذه شهادة عامة من الشيخ بأن الواسطة في نقل التوقيع عن صاحب الأمر ثقة، فمتى ما ثبت لنا وثاقة الطريق إلى ذاك الواسطة فلا حاجة إلى ان نثبت إلى وثاقة الواسطة بما ذكره السيد الشهيد، بل يكفي عندنا في إثبات وثاقته الكبرى العامة التي ذكرها الشيخ في الغيبة، من ان التوقيعات لا ترد الا على الاتقياء الورعين. ولكن، يقع الكلام: في ان مصب هذه الشهادة: «لا ترد التوقيعات من صاحب الامر الا على الاتقياء الورعين». هل مصب هذه الشهادة الواسطة في النقل أو من سأل؟ أي الرواي. فمثلا عندنا «إسحاق بن يعقوب» فهو سأل الامام  عن مسائل: اجابه الإمام. فمن اخبرنا بالتوقيع هو اسحاق، لكن اسحاق ليس الواسطة بينه وبين الإمام، بل هناك واسطة اخرى نقلت التوقيع من الإمام إلى اسحاق، فمن هو المنظور في كلام الشيخ الطوسي؟ هل المنظور في كلام الشيخ الطوسي: ان التوقيعات من صاحب الامر لا ترد الا على الاتقياء الورعين على الواسطة؟ الذي يأخذ التوقيع من الإمام إلى السائل؟ أو ان المقصود هو السائل الذي أخبر بوصول التوقيع إليه؟ فقد يقال: بأن مصب هذه الشهادة: الواسطة في النقل، لا السائل الذي روى لنا هذا التوقيع كي يكون توثيقا له ويرتفع الشك في ذلك. لذلك وقع البحث عندهم من القديم في وثاقة اسحاق بن يعقوب، مع انه مشمول لعبارة الشيخ لعبارة الشيخ «قده» لو كان المنظور اليه من كان سائلا أو من كان راوياً. وبناء على ذلك: لا يصلح كلام الشيخ في الغيبة، لا دليلا على الوثاقة ولا مؤيدا لما ذكره السيد الشهيد «قده».
عن مسائل: اجابه الإمام. فمن اخبرنا بالتوقيع هو اسحاق، لكن اسحاق ليس الواسطة بينه وبين الإمام، بل هناك واسطة اخرى نقلت التوقيع من الإمام إلى اسحاق، فمن هو المنظور في كلام الشيخ الطوسي؟ هل المنظور في كلام الشيخ الطوسي: ان التوقيعات من صاحب الامر لا ترد الا على الاتقياء الورعين على الواسطة؟ الذي يأخذ التوقيع من الإمام إلى السائل؟ أو ان المقصود هو السائل الذي أخبر بوصول التوقيع إليه؟ فقد يقال: بأن مصب هذه الشهادة: الواسطة في النقل، لا السائل الذي روى لنا هذا التوقيع كي يكون توثيقا له ويرتفع الشك في ذلك. لذلك وقع البحث عندهم من القديم في وثاقة اسحاق بن يعقوب، مع انه مشمول لعبارة الشيخ لعبارة الشيخ «قده» لو كان المنظور اليه من كان سائلا أو من كان راوياً. وبناء على ذلك: لا يصلح كلام الشيخ في الغيبة، لا دليلا على الوثاقة ولا مؤيدا لما ذكره السيد الشهيد «قده».
التنبيه الثالث: قوله في النبوي: «لا يحل دم امرأ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه»، وقوله في التوقيع: «فإنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه» ف «لا يحل» كناية عن مطلق الحرمة التكليفية؟ أو عن مطلق الحرمة ولو كانت وضعية، بمعنى: ان من تصرف حسّاً بغير إذن صاحب المال، أو غير رضاه، فبناء على انه ارتكب محرماً فهو ضامن، فلو كان لهذه التصرفات الحسية قيمة سوقية فإنه يضمنها، كما لو فرضنا انه دخل داره ونام هناك والنوم بهذا المقدار له قيمة سوقية، لأجل ذلك مضافاً إلى ارتكابه للحرمة يكون ضامناً، هل المستفاد من جملة «لا يحل ذلك» هو ذلك أم لا؟ فربما يقال: ان سياق النبوي سياق بيان الحرمة التكليفية، حيث تحدث النبي  عن حرمة الشهر، وقال: «إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»، ومن الواضح ان حرمة اليوم والشهر والبلد حرمة تكليفية، فيقال: بأن هذا السياق يمنع من احراز اطلاق الحرمة في هذه الرواية لما يشمل الحرمة الوضعية.
عن حرمة الشهر، وقال: «إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»، ومن الواضح ان حرمة اليوم والشهر والبلد حرمة تكليفية، فيقال: بأن هذا السياق يمنع من احراز اطلاق الحرمة في هذه الرواية لما يشمل الحرمة الوضعية.
ولا يبعد ان يقال: ان اسناد الحرمة إلى المال «إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» فإن اسناد الحرمة إلى المال: ظاهر في أن لمال المسلم حرمة، ومقتضى حرمة مال المسلم ان لا يذهب هدراً، فمقتضى ذلك استفادة الضمان من هذه الرواية كاستفادة الحرمة التكليفية.
الجهة الثالثة: هل المدار في الجواز على الرضا الفعلي؟ أم يكفي الرضا التقديري؟ أم يكفي الرضا التعليقي ولم يكن رضى تقديريا؟ فهنا اتجاهان لمفاد الأدلة:
الاتجاه الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني «قده» في «ج2، حاشية المكاسب، ص80»، قال: المناط في المقام على الرضا بما بمعنى خلو التصرف عن المنافرة في الغرض الشخصي. وبيان مطلبه بوجهين:
الوجه الاول: قال: الرضا له معنيان:
المعنى الاول: هو الحب والإقبال. «رضيت به ربا، أو نبياً» يعني أحببته واقبلت عليه، والحب لا يتصور وجودانا الا مع عود منفعة إلى المحب، فبما انه منوط بعود المنفعة من المحبوب إلى المحب، وإلا فلا حب، لأجل ذلك، لو كان المراد بالرضا في هذه الروايات الشريفة هو الحب والإقبال للزم ان نلتزم باعتبار المنفعة، لأن الحب ملازم للمنفعة، فنقول: لا يجوز التصرف الذي فيه منفعة لصاحب الدار الا برضاه، لأن المراد به الحب، والحب متقوم بالمنفعة، إذن المحرم خصوص التصرف الذي يعود بمنفعة لصاحب الدار، وهذا النوع من التصرف لا يجوز لا برضاه، وهذ لم يلتزم به احد. إذن المراد بالرضا: الخلو، أي خلو التصرف من المنافرة للغرض الشخصي من المالك. حيث إن المالك قد يكون له غرض عقلائي وقد يكون له غرض شخصي. كفتحه لباب الدار، لكن عنده غرض عقلائي من فتح باب الدار وهو ان يؤجرها ويربح من ورائها. وعنده غرض شخصي وهو ان تكون الدار نظيفة أو تكون عامرة. فهذا غرض شخصي. فلو دخل شخص الدر ونام، فإن كان في تصرفه منافرة لغرضه الشخصي فيعتبر في ذلك رضاه، فالمراد بالرضا: ان لا يكون في التصرف منافرة لاغراضه الشخصية وان كان منافراً عن اغراضه العقلائية. المهم ان لا يكون منافرا للغرض الشخصي.
الوجه الثاني: إن طيب النفس، المراد به: الخلو عن القذارة، فلذلك إذا قيل: اللحم طيب. يعني خال من الأمراض، وخال من الأوبئة. فليس المراد من الطيب الا الخلو، فكما ان الطيب المستخدم في اللحوم بمعنى الخلو، هنا ايضاً المراد بالطيب في الرواية: الخلو: «لا يحل دم امرأ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه» أي بخلو نفسه عن المنافرة والمنافاة مع هذا التصرف المنافي لغرضه الشخصي. إذن فعلى كلام المحقق الاصفهاني: يقول انه هذا هو المراد بالرضا. وهذا الرضا دائماً فعلي، متى لم يكن التصرف منافراً للغرض الشخصي فالخلو موجود، فيقال: النفس خالية من المنافرة مع هذا التصرف، لأن هذا التصرف لا يضر بالأغراض الشخصية، فخلو النفس من المنافرة والإباء أمر واقعي فعلي وإن لم يلتفت صاحب الدار لتصرفك، فالذي ليس فعليا هو التفاته للموضوع لا رضاه، ليس ملتفتا بالفعل، لا انه ليس راضيا بالفعل، بل هو راضي، لأنه في افق نفسه يوجد خلو، فخلو النفس عن هذا الاباء لهذا التصرف موجود واقعاً وإن كان التفاته للتصرف غير فعلي.
ثم قال: فاذا كان ظاهر لفظ الطيب هو هذا، كان ظاهر لفظ الترضي في قوله: «إلا ان تكون تجارة عن تراضي» هو ذلك، فما يعتبر في حلية المعاملات هو المعتبر في حلية التصرفات، يعني ما يعتبر في التصرفات الاعتبارية هو المعتبر في التصرفات الحسية. لذلك لو اجريت معاملة على مال شخص لا احتاج إلى ان اسمع اذنه، لا احتاج إلى ان يبرز لي رضاه، يكفي ان احرز ان تصرفي في مالي في بيعي ليس منافيا لغرضه الشخصي. ويلاحظ على ما افاده «قده»: أولاً: بأن عنوان طيب النفس ظاهر عرفا في المعنى الوجودي لا المعنى السلبي، فليس ظاهراً في القناعة والقبول، فمن لم يكن في نفسه قناعة وقبول لشيء لا يقال: طابت نفسه به، فإن طيب النفس ظاهر في هذه المعنى، ولذلك في قوله: «أحل لكم الطيبات» لا يراد بالطيبات مجرد خلوها من المرض، بل يراد من المرض ما كان فيه عنصر يفيد المقبولية والتوافق لا مجرد خلوه من الأمراض كالحجر مثلا. فإن الطيب مضافا إلى خلوه من الامراض فيه عنصر ايجابي يقتضي القبول به والإقبال عليه. ثانياً: على فرض التسليم فيما افاد فلا يكفي في حلية المعاملات مجرد إحراز الخلو، بل لابد من ابراز، والسر في ذلك: أن عنوان التراضي ظاهر في ذلك: ﴿إلا ان تكون تجارة عن تراضي﴾، يعني ان يبرز كل من الطرفين للآخر رضاه، هذا هو الظاهر، لذلك عبر الفقهاء عنه بالتراضي المعاملي، وهو غير التراضي الوجداني أو الرضا الوجداني.
الاتجاه الثاني: ما ذهب اليه السيد اليزدي «قده» في حاشيته على المكاسب، وتبعه الاعلام منهم سيد المستمسك والسيد الخوئي: من ان المدار في جواز التصرف على الرضا التقديري. بلا حاجة إلى الرضا الفعلي ولا يكفي الرضا التعليقي.
بيان ذلك: انه لا نحتاج إلى ان نحرز انه راضي فعلا لأن الرضا الفعلي منوط بالالتفات بأن يلتفت لي انني اتصرف في ماله ومع ذلك يقبل. لا حاجة في جواز التصرف إلى الرضا الفعلي، أي إلى الرضا المنوط بالالتفات، بل يكفي الرضا التقديري، بمعنى ان اقول: لو التفت لرضي، كأن يكون عدم رضاه لأنه غير متلفت لأنه نائم، مثلا، وإلا لو التفت لرضي قطعاً، فالرضا المنوط بالالتفات يكفي فيه هذه الشرطية: انه لو التفت لرضي.
يقول السيد الخوئي: يكفينا في ذلك ملاحظة بناء العقلاء والسيرة المتشرعية القائمة على الجواز في مثل ذلك بلا إشكال، فإن الأخ يدخل دار اخيه والصديق يدخل دار صديقه أو أحد اقاربه ويقطع برضاه لو التفت، فيتصرف فيه كيف يشاء. إذن سيرة عقلائية قائمة على ذلك، وهذه السيرة إحدى القرائن على ظهور كلمة «الطيب» في الرضا التقديري. يرضى لو التفت. نعم، لا يكفي الرضا التعليقي، وهو الرضا المعلق على سبب وجودي غير الالتفات، كما لو افترضنا انه واقف على باب الدار، وأبى دخولي إلى الدار، لكن لو التفت ان في دخولي مصلحة له لرضي، فهو الآن رضاه متوقف ليس على الالتفات، بل على اعتقاده بالمصلحة في دخولي داره. فهل الرضا التعليقي وهو المعلق على سبب وجودي آخر غير الالتفات يكفي؟ فيقولون بأن هذا الرضا التعليقي لا يكفي. إذن المدار على الرضا التقديري بمعنى لو التفت لرضي، ولا يكفي الرضا التعليقي بمعنى لو تم هذا السبب لرضي، ولا حاجة إلى الرضا الفعلي، بأن يكون ملتفتا إلى التصرف. فنقول: لو كنا نحن والقاعدة، لكان ظاهر المشتق هو الفعلية، ولكن حيث إن هذه النصوص محفوفة بالمرتكزات العقلائية كانت قرينة على أن المراد بالطيب هنا الطيب التقديري. يعني لو التفت لطابت نفسه بذلك.
والحمد لله رب العالمين.