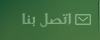كيفية التوجه إلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾
صدق الله العلي العظيم
النقطة الأولى: معنى التوجه إلى الله تبارك وتعالى.
علماء العرفان يقولون التوجه إلى الله له بعدان: بعد نظري، وبعد عملي وسلوكي.
البعد الأول: البعد النظري.
هو أن يعتقد الإنسان أن الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى، كثير من الأشياء نعبر عنها بالوجود، مثلا أقول: أنا موجود، السماء موجودة، الشمس موجودة، الشجر موجود، ولكن في دعاء يا مجير الذي يقرأ في الأيام البيض من شهر رمضان المبارك: ”تعاليت يا موجود“، يخاطب الله تبارك وتعالى بأنه موجود، لا خلاف بأن الله موجود، والبشر موجود، والأرض موجودة، والشمس موجودة، فما معنى هذه الفقرة؟
علماء العرفان يقولون: المقصود هو الوجود الحقيقي، يعني الوجود الذي لا يشوبه نقص، ولا حد، ولا جهة، وجود مطلق لا حد له، ولا نقص فيه، ولا شائبة فيه إطلاقا، وجود الإنسان هو وجود محدود، قدرته محدودة، علمه محدود، حياته محدودة، طاقة الإنسان محدودة، وجود الإنسان محدود من كل الجهات، أينما يتجه يكون وجوده محدود غير ممتد، فوجود الإنسان لأنه محدود ليس وجودا حقيقيا، الوجود الحقيقي هو الوجود اللامحدود، المطلق، لا يحده حد، ولا يشوبه نقص، ولا تقيده جهة، وجود خارج عن إطار الحدود والقيود، وبما أن الوجود الحقيقي، الخارج عن الحدود والقيود هو وجود الله تبارك وتعالى، لذلك يقول الدعاء: ”تعاليت يا موجود“ يعني يا من هو موجود بالوجود الحقيقي.
وأما غيره فوجوده وجود وهمي وليس وجودا حقيقيا. المخلوقات مظاهر لوجود الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم يقول ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ إذا لاحظت الآفاق، ولاحظت نفسك تجد هذا الوجود بأسره مظهرا ودليلا على وجود الله تبارك وتعالى.
| فواعجبا كيف يعصى الإله وفي كل شيء له آية |
أم كيف يجحده الجاحد تدل على أنه واحد |
هذا الوجود بأكمله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة مظهر لآيات الله وقدرته وحكمته، فهو آية على وجود الله تبارك وتعالى، وكلما كان الموجود أقوى في الوجود، كانت مظهريته لله أقوى، مثلا لو أخذت ذرة من شعاع الشمس، هذه الذرة فيها مقدار من الضوء، الحرارة، الحياة، هي تدل على وجود الله تبارك وتعالى، ولكن عندما تنظر إلى الشمس بنفسها، فدلالة الشمس على وجود الله ومظهرية الشمس لوجود الله أقوى من مظهرية هذه الذرة الصغيرة، لأن الوجود في الذرة أضعف من الوجود في الشمس.
كذلك بالنسبة إلينا نحن والأئمة  ، الإنسان العادي مظهر لوجود الله، ودال على وجود الله، لكن هذا الإنسان العادي مظهر لوجود الله بعلم، وقدرة، وطاقة محدودة، عندما يكون هذا الإنسان عالم كبير متضلع في العلم، وماهر في المعرفة، تكون دلاليته ومظهريته على وجود الله تبارك وتعالى أعظم من مظهرية الإنسان العادي، عندما تصل إلى الإمام المعصوم الذي ملك من العلوم والطهارة والعصمة والطاقة والقدرة والولاية ما لم يملكه غيره، تكون مظهريته لله تبارك وتعالى أقوى مصاديق المظهرية.
، الإنسان العادي مظهر لوجود الله، ودال على وجود الله، لكن هذا الإنسان العادي مظهر لوجود الله بعلم، وقدرة، وطاقة محدودة، عندما يكون هذا الإنسان عالم كبير متضلع في العلم، وماهر في المعرفة، تكون دلاليته ومظهريته على وجود الله تبارك وتعالى أعظم من مظهرية الإنسان العادي، عندما تصل إلى الإمام المعصوم الذي ملك من العلوم والطهارة والعصمة والطاقة والقدرة والولاية ما لم يملكه غيره، تكون مظهريته لله تبارك وتعالى أقوى مصاديق المظهرية.
لذلك في بعض الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم  : ”من أراد أن ينظر إلى الله فلينظر إلى علي بن أبي طالب“ قد تستغرب كيف يكون الإمام علي
: ”من أراد أن ينظر إلى الله فلينظر إلى علي بن أبي طالب“ قد تستغرب كيف يكون الإمام علي  شبيها بالله، ولكن ليس هذا المقصود، بل المقصود كما أن الشمس مظهر وآية من آيات الله في ضوئها وحرارتها ودفئها والحياة التي تبعثها وتبثها على وجه الأرض وعلى جميع الكائنات، كذلك علي بن أبي طالب أقوى المظاهر لله تبارك وتعالى، وإلا نحن لا ندعي المشابهة بين شكل الإمام علي
شبيها بالله، ولكن ليس هذا المقصود، بل المقصود كما أن الشمس مظهر وآية من آيات الله في ضوئها وحرارتها ودفئها والحياة التي تبعثها وتبثها على وجه الأرض وعلى جميع الكائنات، كذلك علي بن أبي طالب أقوى المظاهر لله تبارك وتعالى، وإلا نحن لا ندعي المشابهة بين شكل الإمام علي  والله تبارك وتعالى، هذا عند غيرنا.
والله تبارك وتعالى، هذا عند غيرنا.
راجع صحيح البخاري في كتاب الاستئذان باب بدء السلام يقول: عن أبي هريرة إن الله خلق آدم على صورته، طوله ستون ذراعا، وراجع كتاب التوحيد في تفسير قوله تعالى ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ يقول: إن لله أصابع، وراجع في كتاب التوحيد باب ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ يقول بأنه يوم القيامة الله يضع رجله في النار، كلما وضع فيها جماعة من الناس لا تشبع، فيضع رجله في النار، فتقول: قط قط بمعنى اكتفيت بعزتك وجلالك وينزوي بعضها على بعض، وراجع كتاب التهجد، باب الدعاء آخر الليل، تجد أن الله ينزل آخر الليل إلى سماء الدنيا، ويقول: أيها الداعي استجبت لك، وأيها المستغفر غفرت لك، وما إلى ذلك.
أما نحن فلا نعتقد بذلك، نحن نقول معنى أن من رأى عليا فقد رأى الله، أو من قد رأى الرسول فقد رأى الله، يعني أن هؤلاء مظاهر لوجود الله، للقدرة الإلهية، للحكمة الإلهية، للعلم الإلهي، للصنع الإلهي، هذا هو المقصود. فإذن البعد النظري هو أن تعتقد أن الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى، وجود غير محدود.
البعد الثاني: البعد العملي.
يقول علماء العرفان أن هذا الاعتقاد وحده لا يفيد، هذا الاعتقاد لابد أن يتحول إلى وجدان، مثلا: أنا أتصور المجاعة، يقول لي هناك مجاعة في جنوب إفريقيا، فأتصور أن هناك جوع وعطش وآلام وآهات، لكن هذا التصور لم يصل إلى مرحلة الوجدان، لم يصل إلى مرحلة الإحساس والشعور الداخلي، مجرد تصور، لكن لو ابتليت أنا بنفس الحالة، حالة من الجوع أو العطش، او ابتليت بحالة من الحرمان والآلام، فتتحول تلك الصورة إلى واقع وشعور وجداني، إلى إحساس داخلي، هناك فرق بين التصور الذهني، وبين الإحساس الوجداني، تصور الجوع شيء، والإحساس بالجوع شيء آخر، تصور الفرح شيء والإحساس بالفرح شيء آخر، نحن عندما نتصور الموت، القبر، عالم البرزخ، لأننا لم نجرب، لكن إذا وقعنا في هذه الأمور يتحول التصور إلى إحساس وجداني وشعور داخلي لهذا الأمر.
علماء العرفان يقولون: أنت تعتقد بأن الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى، وتعتقد أن جميع الكائنات آيات على الله، ومظاهر لله تبارك وتعالى، لكن هذا التصور شيء والإحساس شيء آخر، المطلوب منك أن تصل إلى مرحلة الإحساس، أن تشعر بداخلك بوجود الله، أن تشعر بوجدانك بحضور الله، أن تشعر في داخل نفسك بالله تبارك وتعالى، كلنا نعتقد بالله، ونعتقد أن الوجود الأتم لله تبارك وتعالى، لكن هذا الاعتقاد إنما يتحول إلى إحساس داخلي ووجداني بوجود الله تبارك وتعالى نتيجة أعمال رياضية، وتوفيقات إلهية يمد الله بها عبده ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ولذلك يذكر علماء العرفان أن هناك ثلاث درجات للتوجه نحو الله: الشريعة، والطريقة، والحقيقة.
المرحلة الأولى: مرحلة الشريعة.
يعني أن تلتزم بالأوامر الشرعية، تقوم بالواجبات وتجتنب المحرمات، بل تجتنب حتى المكروهات، وتواظب حتى على المستحبات، بل تتورع حتى عن الشبهات، كما ورد في الحديث الشريف: ”حلال بين، حرام بين، شبهات بين ذلك، فمن تورع في الشبهات نجا من المحرمات“ وورد في الحديث عن الرسول الأعظم محمد  : ”في حرامها عقاب، وفي حلالها حساب، وفي شبهاتها عتاب“ فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى المرحلة الحقيقية للتوجه إلى الله لابد أن يجتنب المحرمات، ويفعل الواجبات، ويترك المكروهات، ويواظب على المستحبات، ويجتنب حتى عن الشبهات.
: ”في حرامها عقاب، وفي حلالها حساب، وفي شبهاتها عتاب“ فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى المرحلة الحقيقية للتوجه إلى الله لابد أن يجتنب المحرمات، ويفعل الواجبات، ويترك المكروهات، ويواظب على المستحبات، ويجتنب حتى عن الشبهات.
المرحلة الثانية: مرحلة الطريقة.
يعني أن يوجه قلبه دائما نحو الله، يرى قلبه منشرح إلى الله تبارك وتعالى، يحب الصلاة، الصوم، العبادة، النوافل، قراءة القرآن، الدعاء، يحب دائما ذكر الله، لا يفتر عنه ولا يتغافل، ولذلك ورد في الحديث الشريف: ”لا يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها“ يعني أن الإنسان إذا ترك المحرمات، وفعل الواجبات، وحافظ على المستحبات، واجتنب المكروهات، وتورع عن الشبهات، يملأ الله قلبه، ووجدانه، وشعوره، فدائما يرى نفسه مقبل على الله تبارك وتعالى، دائما مقبل على العبادة، النافلة، الدعاء، قراءة القرآن يشعر بلذة في قراءة القرآن، في الصلاة، في الدعاء ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾.
المرحلة الثالثة: مرحلة الحقيقة.
الذي يصل إلى هذه المرحلة ليس فقط يحب الله، بل أكثر من هذا، يشعرون بحضور دائم لله في قلوبهم وفي أنفسهم، شعور داخلي، شعوري بنفسي شعور حضوري، يعني أني أشعر بأن نفسي حاضرة عندي لا تغيب عني أبدا، ولا أغفل عنها ولا ثانية أو لحظة، هؤلاء يصلون إلى مرحلة يشعرون بحضور الله في قلوبهم، كما يشعر الإنسان بحضور نفسه التي لا تغيب عنه أبدا، وهذه المرحلة لا يصل إليها إلا الأئمة من أهل البيت  الشعور بالحضور الإلهي الذي لا يغيب عنهم لحظة ولا ثانية في قلوبهم وفي أنفسهم، هؤلاء هم الذي وصلوا إلى مرحلة معرفة النفس ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ معرفة النفس أنفع المعرفتين، معرفة النفس هي أن تشعر بالحضور الإلهي في نفسك شعورا لا يغيب ولا يغفل ولا يخطئ ولا ينسى.
الشعور بالحضور الإلهي الذي لا يغيب عنهم لحظة ولا ثانية في قلوبهم وفي أنفسهم، هؤلاء هم الذي وصلوا إلى مرحلة معرفة النفس ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ معرفة النفس أنفع المعرفتين، معرفة النفس هي أن تشعر بالحضور الإلهي في نفسك شعورا لا يغيب ولا يغفل ولا يخطئ ولا ينسى.
ولذلك ورد عن الإمام علي  : ”ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه“ ولذلك يقول الإمام الحسين
: ”ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه“ ولذلك يقول الإمام الحسين  في دعاء يوم عرفة ”أيستدل على وجودك بما هو في وجوده مفتقر إليك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك“، نحن الناس العاديين نقول: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ نستدل بالآثار على المؤثر، على الله تبارك وتعالى، أما الإمام المعصوم لا يستدل بالآثار، الإمام المعصوم يقول: ”بك عرفتك“، ”يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجالسة مخلوقاته“، ”متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عقد لم تجعل له من ودك نصيبا“.
في دعاء يوم عرفة ”أيستدل على وجودك بما هو في وجوده مفتقر إليك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك“، نحن الناس العاديين نقول: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ نستدل بالآثار على المؤثر، على الله تبارك وتعالى، أما الإمام المعصوم لا يستدل بالآثار، الإمام المعصوم يقول: ”بك عرفتك“، ”يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجالسة مخلوقاته“، ”متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عقد لم تجعل له من ودك نصيبا“.
إذن المسألة هي مسألة أن التوجه إلى الله، هناك توجه فكري وهذا يستطيع عليه كثير من البشر، وهناك توجه نفسي وداخلي وهذا يختص بالأولياء، بل بالأئمة المعصومين  إذن إبراهيم عندما يقول ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لم يكن يعني أنه توجه إلى القبلة، بل المقصود أن جميع مشاعره، وعواطفه، وكيانه، وجميع شؤونه الداخلية متوجهة إلى الله تبارك وتعالى.
إذن إبراهيم عندما يقول ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لم يكن يعني أنه توجه إلى القبلة، بل المقصود أن جميع مشاعره، وعواطفه، وكيانه، وجميع شؤونه الداخلية متوجهة إلى الله تبارك وتعالى.
النقطة الثانية: تربية الدوافع وإصلاحها.
ماسلو يقسم الدوافع إلى: دوافع أولية، ودوافع ثانوية. الدوافع الأولية هي التي تنبع من حاجات عضوية، مثلا دافع الإنسان نحو تناول الطعام والشراب، هذا دافع أولي ينبع من حاجة جسمية، دافع الإنسان نحو الأمن، شعور الإنسان بالخوف، بالضعف، بالنقص، هذا شعور أولي عند كل إنسان، فهو يحتاج إلى الأمن حاجة أولية.
أما الدوافع الثانوية: مثل حاجة الإنسان إلى الجنس، فلو لم يشبع الإنسان هذه الغريزة فإنه لا يموت، قد يصاب بإعياء عصبي، يصاب بحالة نفسية، مرض نفسي مزمن إذا لم يتمكن من إشباع غريزة الجنس، حاجة الإنسان إلى الجنس حاجة ثانوية وليست حاجة أولية، حاجة الإنسان إلى التقدير الاجتماعي، إنسان يحتاج إلى أن يحترمه المجتمع ويحبه هي حاجة ثانوية، هناك حاجات أولية وحاجات ثانوية.
الإسلام والقرآن الكريم يربيان الدوافع، سواء كانت دوافع أولية، أو دوافع ثانوية على أن تكون دوافع إلهية، نضرب أمثلة لثلاثة دوافع:
الدافع الأول: دافع الإنسان نحو الأمن.
لا يوجد إنسان لا يخاف، لأن القرآن يقول ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً﴾ كل إنسان يخاف، البعض يخاف من المرض، والبعض من القوة، والبعض يخاف من الحوادث الطبيعية، فكل إنسان يخاف من شيء، ولا يوجد إنسان لا يخاف، كل إنسان يخاف يحتاج إلى الأمن، إلى جهة مؤمنة تؤمنه من الخوف، تقلل من ثورة وغليان الخوف عند الإنسان.
الإسلام يقول أنت لديك دافع الأمن، تحتاج إلى من يؤمنك، تحتاج إلى من يزيل الخوف والقلق من نفسك، المؤمن الوحيد هو الله تبارك وتعالى، الطبيب يعالجك، الشخص القوي يحميك من الشياطين، لكن قد يصل إليك خطر كبير لا يستطيع الطبيب ولا القوي ولا أي إنسان أن يخلصك من ذلك الخطر، لا ملجأ إلا لله تبارك وتعالى ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ خصوصا نحن في هذا العصر، العصر الحديث، كثرت فيه الأمراض الخطيرة، الحوادث، الاعتداءات، كثرت فيه مناشئ الخوف والقلق لذلك إذا أردت أن تربي هذا الدافع وأن تصلح هذا الدافع فوجهه نحو الله تبارك وتعالى، عليك أن تثق ثقة تامة أن لا مخلص إلا الله، فالجأ إلى الله، ورد عن الإمام أمير المؤمنين  يخاطب ابنه الحسن: ”يا بني، والجأ في أمورك كلها إلى ربك؛ فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز“.
يخاطب ابنه الحسن: ”يا بني، والجأ في أمورك كلها إلى ربك؛ فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز“.
الدافع الثاني: دافع الإنسان نحو السيطرة.
كل إنسان لديه هذا الدافع، هذا ما يقره علماء النفس، كل إنسان يملك دافع نحو أن يبرز ويسيطر على الآخرين، نحو أن يمتد وجوده للآخرين، هذا الدافع الطبيعي الموجود عند الإنسان، الإسلام يأمرك بإصلاحه وتوجيهه، التوجيه نحو الله تبارك وتعالى، ورد عن الإمام الحسن الزكي  : ”إذا أردت عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله، إلى عز طاعته“ كل إنسان يطمح للبروز والسيطرة، يقول له إذا أردت هذا الطريق فاسلك به طريق الله، البروز والشهرة، لتكون دافعا إلهيا.
: ”إذا أردت عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله، إلى عز طاعته“ كل إنسان يطمح للبروز والسيطرة، يقول له إذا أردت هذا الطريق فاسلك به طريق الله، البروز والشهرة، لتكون دافعا إلهيا.
خير الناس أنفعهم، عندما تريد أن تصل إلى منصب كبير، حاول أن تخدم الناس وتنفعهم به، وبهذه الوظيفة قربة إلى الله تبارك وتعالى، فتحصل على غايتك، ورد في الحديث الشريف: ”من قضى لأخيه المؤمن حاجة، قضى الله حاجته، ونودي من بطنان العرش علي جزاؤك ولا أرضى لك بدون الجنة“ يجب خدمة المؤمن سواء كان مواطنا أو غير مواطن أو أجيرا ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.
الدافع الثالث: أن الإنسان يندفع نحو الغضب.
هذا طبيعي في الإنسان ويسمى دافع الانتقام، والناس يتفاوتون في درجة الغضب، لكن مع ذلك الغضب له جانب إيجابي، وله جانب سلبي، الجانب السلبي، الغضب لأدنى سبب ولأمور شخصية وتافهة، هذا ما ذمته الأحاديث، ورد في الحديث: ”الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم“ وورد في الحديث: ”الغضب نوع من الجنون وذلك لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم“ لذلك ورد أن الإنسان إذا غضب وكان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فليقم ويصب على وجهه ماء بارد لكي يهدأ غضبه، وإذا غضب على رحم له يمس يده، فإذا مس جسده فإنه يهدأ غضبه.
خصوصا الغضب على الأرحام، في مجتمعاتنا بمجرد أن يختلف مع الرحم لا يتنازل ونتيجة الغضب السباب، الشتم، قطيعة الرحم، إساءة الظن بالآخرين ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أفضل أنواع الإحسان هو الإحسان إلى الرحم، إذا أغضبك الرحم، وأساء إليك اغتفر له إساءته، سامحه على خطئه من باب القربى إلى الله تبارك وتعالى، من باب صلة الرحم ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ فالإنسان يتجاوز عن سيئات أرحامه وأخطائهم قربة إلى الله ومن باب أداء صلة الرحم.
الإمام زين العابدين جاء ابن عم له - من أبناء الحسن - وقف على رأس الإمام وشتمه، فقال الإمام أتحبون أن تعرفوا ردي عليه؟ فقالوا: نعم، فقال: قوموا معي، فقاموا، فقال: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وصل إلى باب بيت ابن عمه، طرق الباب، فسأل: من الطارق؟ قال: علي ابن الحسين، فخرج ابن عمه متوسدا للشر، فلم يرد  ، قال يا ابن العم إنك وقفت على رأسي وقلت ما قلت، فإن كان ما قلته في، فأستغفر الله، وإن كان ما قلته ليس في، فغفر الله لك، ووصله بمنحة من منحه.
، قال يا ابن العم إنك وقفت على رأسي وقلت ما قلت، فإن كان ما قلته في، فأستغفر الله، وإن كان ما قلته ليس في، فغفر الله لك، ووصله بمنحة من منحه.
أما الجانب الإيجابي من الغضب، فهو الغضب لله تبارك وتعالى، ولذلك ورد في الحديث ”من أُغْضِبَ ولم يغضب فهو حمار“ يعني من أُغْضِب في دينه وعقيدته ومبادئه، فالغضب لله وللمبادئ هو غضب إيجابي ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الغضب لله وللمبدأ وللعقيدة من أعظم مظاهر وخصال الإيمان.