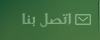المدرسة الروحية والتعبدية في الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾
صدق الله العلي العظيم
توجد في علم الفقه مدرستان، يتبنى كل واحدة منهما مجموعة من فقهائها، أولاهما: المدرسة الروحية، ومن أبرز الفقهاء الذين يتبنونها: الإمام الخميني «قدس سره»، والأخرى: المدرسة التعبدية، ومن أبرز الفقهاء الذين يتبنونها: سيدنا الخوئي «قدس سره».
المدرسة الروحية مضمونها - بشكل إجمالي - يركز على أنَّ التشريعات والفتاوى والأحكام الفقهية يجب أن تكون في إطار روح الحكم، فجميع الفتاوى لا بد وأن تنطلق من روح الحكم، لا أن تنطلق من ظواهر الألفاظ ومن الحدود الظاهرية للأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية تتضمن وراءها روحًا، أي: تتضمن وراءها مصالح ومفاسد، فهذه الأحكام لم تشرع إلا لكي تضمن للمجتمع مصالح معينة، ولكي تجنب أبناء المجتمع مفاسد معينة، فالأحكام الإسلامية تتضمن روحًا وراءها، ولا بد من أن نحافظ على تلك الروح من خلال الفتاوى والأحكام الشرعية.
مثلًا: يجوز للنساء في ليلة الزفاف الغناء. هذا الحكم يراه الكثير من فقهائنا، إلا السيد السيستاني، فإن الأحوط وجوبًا عنده الترك، ولكن المشهور عند فقهائنا هو الجواز، بشرط عدم استخدام أدوات اللهو، من عود وقيثارة ونحوهما، فلو أن المرأة أرادت أن تعوض عن أداة اللهو، وقامت باستخدلم سلة المهملات مثلاً، فحينئذٍ يجوز لها ذلك عند بعض الفقهاء؛ لأن سلة المهملات ليست بأداة لهو، بخلاف الطبلة. الذي يرى المدرسة التعبدية يجري وراء ظواهر الألفاظ، فالألفاظ التي وردت عن الرسول وأهل بيته الطاهرين «صلوات الله عليهم أجمعين» قالت: يمنع استخدام أدوات اللهو، وهذا ليس أداة لهو، بل هو شيء لجمع الأوساخ ليس إلا.
أما من يتبنى المدرسة الروحية فيقول: ليس المهم هو ظاهر اللفظ، فمحل المنع والحظر والحرمة وإن كان هو أداة اللهو، وهذا ليس أداة لهو، لكن المشكلة ليست هي مشكلة لفظ، بل هي مشكلة روح، فهذا الحكم وراءه روح، فعندما يقول المشرع الحكيم: لا تستخدم أداة لهو، فلهذا الحكم روح، وهذه الروح هي أن تعتاد نفس الإنسان على التعلق بأدوات العزف واللهو والغناء، وهذا الملاك وهذه الروح لا تتغير سواء استخدمت الطبلة أم استخدمت سلة المهملات، فالمفسدة باقية.
المدرسة الروحية: تركز على روح الحكم، وتقول أن هناك ملاكاتٍ ومصالحَ ومفاسدَ للأحكام، وهذه الأحكام يجب أن تكون في إطار هذه الملاكات والمصالح والمفاسد، لا أن تخرج عنها، ويجب أن يكون اتجاهنا في الفتوى وفي تقنين الأحكام الشرعية منطلقًا من روح الحكم، لا أن نجمد على ظواهر الأدلة، إذ ليس الفقه - كما يعبر السيد الإمام في كتابه البيع - علمًا يمارس فيه الفقيه مهارته العلمية، ويبدع فيه قدرته الفنية، ليتوصل إلى مختلف الوجوه والاحتمالات، وإنما الفقه طريقٌ يسير فيه الفقيه إلى حفظ المصالح، والابتعاد عن المفاسد، وذلك من خلال المحافظة على روح الحكم التي هي وراء هذه التشريعات كلها.
المدرسة التعبدية: يقولون نحن لا نعلم شيئًا عن روح الحكم، إذ أن جميع القوانين والتشريعات التي وصلت إلينا عن طريق الروايات والأدلة التي وردت إلينا عن طريق النبي والأئمة الطاهرين  تحمل ملاكات، أي أنها مشرعة على طبق مصالح ومفاسد، وهذا أمر مسلَّم لا ينكره أحد؛ لأن الله تعالى حكيمٌ، والحكيم لا يشرّع قانونًا جزافيًا، فلا شك في أن القوانين السماوية شرّعت لحفظ المصالح والإبعاد عن المفاسد، ولكن الكلام في أننا - نحن البشر المحدود - لا نستطيع الوصول إلى تلك المصالح والمفاسد، فلا نستطيع تحديد روح الحكم حتى نتمكن من الحفاظ عليها، ولذلك ليس أمامنا إلا ظواهر الألفاظ، فإذا لم يكن أمامنا طريق لتحديد المصالح والمفاسد إلا هذه الظواهر فوظيفتنا هي المشي على طبق هذه الظواهر، بحيث تكون فتاوانا ومنطلقاتنا الفقهية في ضمن هذا الإطار، فإن اللفظ الصادر عن الشارع هو الباب الوحيد الذي يكشف عن روح الحكم، وعن ملاكات الحكم، وعن المصالح والمفاسد التي هي وراء الحكم.
تحمل ملاكات، أي أنها مشرعة على طبق مصالح ومفاسد، وهذا أمر مسلَّم لا ينكره أحد؛ لأن الله تعالى حكيمٌ، والحكيم لا يشرّع قانونًا جزافيًا، فلا شك في أن القوانين السماوية شرّعت لحفظ المصالح والإبعاد عن المفاسد، ولكن الكلام في أننا - نحن البشر المحدود - لا نستطيع الوصول إلى تلك المصالح والمفاسد، فلا نستطيع تحديد روح الحكم حتى نتمكن من الحفاظ عليها، ولذلك ليس أمامنا إلا ظواهر الألفاظ، فإذا لم يكن أمامنا طريق لتحديد المصالح والمفاسد إلا هذه الظواهر فوظيفتنا هي المشي على طبق هذه الظواهر، بحيث تكون فتاوانا ومنطلقاتنا الفقهية في ضمن هذا الإطار، فإن اللفظ الصادر عن الشارع هو الباب الوحيد الذي يكشف عن روح الحكم، وعن ملاكات الحكم، وعن المصالح والمفاسد التي هي وراء الحكم.
فلنطبق ما ذكرناه حول هاتين المدرستين على ما نحن مبتلون به في زماننا، وهو مسألة الحيل البنكية للتخلص من الربا، كبيع المرابحة، ومسألة التورق، والمضاربة، ونحو ذلك، وكذلك يطرح فقهاؤنا - كما في منهاج الصالحين، ج1 - عندما يتحدثون عن أحكام البنوك يذكرون حيلاً للتخلص من الحيل الربوية. مثلًا: يقول البنك: بدل أن أقرضك مئة ألف بمئة وأربعة آلاف فإنني أبيعك مئة ألف ريال نقدًا بثلاثين ألف دولار مؤجلاً وعلى أقساط، والنتيجة واحدة، حيث حصل البنك على الزيادة، وحصل الطرف الآخر على المبلغ الذي يريده من خلال البيع بدل القرض. مثال آخر: يطرح السيد الخوئي في منهاج الصالحين حرمة إقراض مئة ألف بمئة وأربعة آلاف وجواز بيع مئة ألف مع قلم بمئة وأربعة آلاف مؤجلاً وعلى أقساط.
ولكن السيد الإمام «قدس سره» في كتاب البيع حمل حملة شعواء بألفاظ قوية جدًا على هذه الحيل التي طرحها الفقهاء للتخلص من الربا، وقد ذكر ثلاثة وجوه لمنع هذه الحيل برمتها:
الوجه الأول: الحيل لا تلغي اقتران الربا بمحذور الظلم.
الربا ليس كلمة حتى نغيرها بكلمة أخرى، بل هو محذور معين، وهذا المحذور لا يتغير بتغيير الصياغات والألفاظ، وهذا المحذور هو الظلم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. بيان ذلك: القروض الربوية تؤدي إلى سيطرة البنوك على موارد الإنتاج والاستهلاك، فمن أراد أن يقوم بمشروع إنتاجي - مثلاً - ولم يكن عنده رأس مال فإنه يقترض من البنك مالاً، ثم يأخذ البنك عليه فوائد، ومعنى أخذ الفوائد أن ربح عمل هذا الإنسان وجهده يأخذه البنك، فهذا المشروع الذي قام بفتحه وتعب عليه وبذل فيه غاية جهده في سبيل إنتاجيته جزء من إنتاجه يأخذه البنك عبر الفوائد الربوية، ومن الواضح أن أخذ فوائد جهد الإنسان وتعبه ظلمٌ واضحٌ له.
وكذلك الحال في موارد الاستهلاك، فمن أراد بناء بيت أو شراء سيارة مثلاً، ولم يكن يملك مالاً كافيًا، فأخذ من البنك قرضًا، فإن البنك يأخذ عليه فوائد ربوية، وهذا يعني أن البنك مسيطر على موارد الاستهلاك كما أنه مسيطر على موارد الإنتاج، وكل ذلك نتيجة القروض الربوية.
والأدهى من ذلك، أن نتيجة القروض الربوية هي سيطرة الدول الكبرى على الدول النامية؛ لأن الدولة الفقيرة لا تستطيع أن تبني بنيتها التحتية ولا تستطيع بناء قوامها إلا بواسطة لاقروض من الدول الغنية، وهذه القروض تعني الفوائد الربوية، فتكون نتيجة فتح باب الربا سيطرة الدول الكبرى على جميع الدول النامية باقتصادها وسياستها وجميع أمورها، فأي ظلم أوضح من هذا الظلم؟! وخلاصة هذا الوجه: أن الربا محذور اسمه الظلم، وليس مجرد كلمة، والظلم لا يتغير بتغيير الألفاظ والصياغات والطرق حتى نقول بأن هذا الطريق جائز وذاك الطريق غير جائز.
رأي المدرسة التعبدية في هذا الوجه:
السيد الخوئي لم يتعرض لهذا البحث، ولم يناقش هذا الوجه، ولكنني أتصيد كلماته وأحاول بلورة فحوى آرائه من هاهنا وهاهنا، فأقول: هذا الوجه يمكن أن يناقَش من قِبَل المدرسة التعبدية بأنه لا فرق بالنتيجة بين فتح باب الربا أو إغلاقه؛ لأننا إذا فتحنا باب الربا وسيطر المقرِض على المقترِض وانتزع منه الفوائد الربوية فهذا ظلم، وفي المقابل أيضًا إغلاق باب الربا يكون ظلمًا للمقرِض؛ فإن المقرض يقول: أنا عندي قدرة مالية ضمن مليون ريال مثلاً، وهذه القدرة المالية أنا أجمّدها لدى المقترِض لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، وبهذا التجميد أضيع على نفسي فرض استثمار هذه الأموال، فإذا لم أعط أي فائدة مقابل ذلك فسوف يكون هذا ظلمًا لي، فأي فرق بين الأمرين؟! إذا كان فتح باب الربا ظلمًا فإغلاق طرق التخلص من الربا ظلم آخر؛ فإنَّ تجميد القدرة المالية للمقرِض وتضييع فرص الاستثمار لمدة مديدة - خصوصًا مع كون النقد في معرض التضخم وكون القوة الشرائية في معرض النقص والانحدار - من غير مقابل ولا عوض ظلمٌ له.
وهذا يكشف عن أن الظلم في الآية المباركة ظلمٌ تعبديٌ وليس ظلمًا واقعيًا حقيقيًا، فإن أخذ الفائدة مقابل الأجل أو مقابل الإنساء الزمني - كما يعبر الفقهاء - فهذا يعتبره الشارع ظلمًا، وإلا لو أننا نظرنا إلى الملاكات والمرتكزات العقلائية فإن العقلاء كما يرون هذا ظلمًا يرون ذاك ظلمًا آخر، وهذا منبه على أننا بعقولنا لا نستطيع أن نحدد ملاك الحكم وروحه التي يجب أن تكون التقنينات والفتاوى في إطارها.
الوجه الثاني: الحيل تخالف مصالح الشارع المقدس.
قال السيد الخميني «قدس سره» بأن الفقيه وارث الأنبياء والمرسلين، فقد ورد أن العلماء ورثة الأنبياء، وورد في الحديث الشريف: «مجاري الأمور بيد العلماء أمناء الله على حلاله وحرامه»، فالفقه ما هو إلا طريق لحفظ الشريعة، فإذا كان كذلك فيجب أن يكون منطلقه حماية المصالح والملاكات التي أراد المشرّع الحكيم حفظها وحمايتها، فكيف نقول بعدم جواز بيع مئة ألف بمئة وأربعة آلاف ولكن يجوز بيع مئة ألف مع قلم بمئة وآربعة آلاف؟! هل في هذا حفظ لمصالح الشارع ولروح الأحكام الشرعية؟!
مثال آخر: جميع فقهاء المسلمين يقولون بحرمة الكذب، لكنهم يقولون بجواز التورية، والمقصود بالتورية استخدام لفظ له معنيان: يفهم المستمع منه المعنى القريب، ويقصد المتكلم منه المعنى البعيد، كما لو أتى شخصٌ وطرق باب بيت أحد الأشخاص، ولم يكن صاحب البيت يريد استقباله، فيأمر ابنه بألا يكذب عليه ولكن يأمره باستخدام التورية، بأن يقول مثلاً: ”أبي ليس هنا“ مشيرًا إلى مكان معين قريب من الباب مثلاً، فيفهم الزائر أن المزور ليس موجودًا في البيت، والحال أنه موجود ولكن الابن قصد أنه ليس في المكان الذي أشار إليه، فهو لم يكذب ولكنه استخدم التورية، وهذا من قبيل قول الشاعر الشيعي:
| وسائل كم خلفاء النبي أجبته في لغز قائلاً |
وما هم والله بالمضيعة أربعة أربعة أربعة |
فاقتنع السائل ظنًا منه أن المقصود أن عدد الخلفاء أربعة فقط، وإنما التكرار مجرد توكيد لفظي، والحال أن الشاعر قصد مجموع هذه الأربعات، مشيرًا إلى عقيدة الشيعة الاثني عشرية، فهو لم يكذب، ولكنه استخدم التورية. وكذلك لو سئل شخصٌ مثلاً: من هو أفضل أصحاب رسول الله  ؟ فقال: ”من ابنته في بيته“، فيفهم السائل أن المقصود من هذه العبارة: من ابنة هذا الصاحب في بيت النبي، وهذا ينطبق على الخليفة الأول، بينما المتكلم يقصد: من ابنة الرسول في ابنة ذاك الصاحب، فهو يعني الإمام علي
؟ فقال: ”من ابنته في بيته“، فيفهم السائل أن المقصود من هذه العبارة: من ابنة هذا الصاحب في بيت النبي، وهذا ينطبق على الخليفة الأول، بينما المتكلم يقصد: من ابنة الرسول في ابنة ذاك الصاحب، فهو يعني الإمام علي  ، فهو لم يكذب، ولكنه استخدم التورية.
، فهو لم يكذب، ولكنه استخدم التورية.
بعض الفقهاء يقولون: تجوز التورية مطلقًا، لكن بعض الفقهاء يقولون بأن التورية تؤدي إلى تضليل السامع وإيهامه، وهذا هو محذور الكذب، فلا فرق بينهما حتى يقال بأنه محرم بينما هي جائزة مطلقًا، فلا تجوز التورية إلا في حال الضرورة فقط، وهذا الخلاف ناشئ عن الاختلاف بين المدرسة الروحية والمدرسة التعبدية، فإن المدرسة الروحية - كما ذكرنا - تركز على المحذور المقتنص عقلاً من خلال بعض القرائن التي يراها.
رأي المدرسة التعبدية في هذا الوجه:
المدرسة التعبدية تقول: حتى لو فرضنا بأن المنطلق هو روح الحكم إلا أن المصالح تتزاحم، فكيف نوفق بين المصالح المتزاحمة؟! مثلا: من مصلحة الفرد العامل أن يحقق نتيجة عمله، أي أنه يكدح فحيصل على نتيجة كدحه وعمله، لكن هناك مصلحة أخرى يجب أن تراعى أيضًا، وهي مصلحة الطبقة الرأسمالية التي تملك رؤوس الأموال، فكيف نجمع بين المصلحتين؟ إذا ركزنا على مصلحة الطبقة العاملة فسنغلق جميع طرق التخلص من الربا بدعوى أن هذه الطرق تؤدي إلى ظلم الطبقة الكادحة، ولكن سنظلم الطبقة الثرية، وأما إذا أردنا أن جمع بين الملاكين فالمسألة مختلفة.
إذن المسألة مسألة تزاحم بين المصالح والملاكات، فكيف يمكن التوفيق والجمع بينها؟ إذا أردنا أن نجعل اقتصاد المجتمع اقتصادًا متحركًا حيويًا يشارك الجميع فيه فإن ذلك - أي: تحريك عجلة الاقتصاد - لا يتم إلا بترغيب أصحاب رؤوس الأموال، وذلك بوضع بعض المغريات والمرغّبات لجذبهم من أجل بذل أموالهم وتحريك السوق وتفعيل المشاريع والموارد الإنتاجية.
إذا أغلقنا باب الحيل وأغلقنا باب طرق التخلص من الربا وقلنا: أيها البنك، إما أن تقرض قربةً لله وإما ألا تقرض أبدًا! خصوصًا في مثل هذا الواقع الرأسمالي الذي فرض نفسه علينا، فحينئذٍ لا يمكننا تحريك العجلة الرأسمالية. الآن لسنا نحن الذين نفكر، بل يوجد من يفكر عنا في دول أخرى، وهناك من يعبد لنا الطريق ويفتح لنا الأبواب، ويعلمنا ماذا نعمل خطوة خطوة، فمع هيمنة الاقتصاد الرأسمالي على السوق على الأرض كلها وأمام هذا الواقع الذي لا يمكن تغيير في القريب العاجل، كيف يمكن التوفيق بين المصالح؟! كيف يمكن الجمع بين المصالح؟! كيف يمكن التوفيق بين مصلحة العامل الكادح وبين تحريك أصحاب رؤوس الأموال بذل أموالهم في تحريك عجلة السوق؟! لا يمكن التوفيق بين هذه المصالح إلا بفتح طرق التخلص من الربا.
الوجه الثالث: لم ترد روايات تدل على مشروعية الحيل.
لو كانت هذه الحيل التي تقولون بها جائزة لبينها أهل البيت، مع أننا لم نجد شيئًا من ذلك، فلماذا لم يسهّل الأئمة على الناس حياتهم؟! إذا كان بيع مئة ألف مع قلم بمئة وأربعة آلاف أمرًا جائزًا لتصدى الأئمة لبيانه، ولتصدى الأئمة لتبليغه، ولتصدى الأئمة لإيصاله إلى الناس؛ تسهيلاً عليهم ورفعًا للحرج عنهم، علمًا بأن الاقتصاد الرأسمالي ليس وليد يومنا هذا، بل منذ زمان هارون الرشيد كان النظام المسيطر على السوق هو الاقتصاد الرأسمالي، فإذا كان الأمر كذلك، لو كانت هذه الحيل أمرًا جائزًا ومباحًا، لتوصل إليها الأئمة قبل أن يتوصل إليها فقهاؤنا في هذا الزمان، ولأباحوها ولتحدثوا عنها، فلماذا لم يرد عنهم مثل هذه الحيل التي اخترعت وطُرِحَت في زماننا هذا؟!
الجواب عن هذا الوجه:
بعض الحيل لم ترد في النصوص، لكن بعض الحيل وردت في النصوص وبيّن أهل البيت جوازها، ومن هذه النصوص: معتبرة محمد بن إسحاق بن عمار: سألتُ أبا عبد الله  : يكون لي على الرجل دراهم، فيأتي إليَّ ويقول: أخّرني بها وأنا أرْبِحُك، فأبيعه جبّةً تسوى عليه بألف درهم بعشرين ألف درهم إلى أجل، قال
: يكون لي على الرجل دراهم، فيأتي إليَّ ويقول: أخّرني بها وأنا أرْبِحُك، فأبيعه جبّةً تسوى عليه بألف درهم بعشرين ألف درهم إلى أجل، قال  : لا بأس بذلك. هنا يقول الراوي بأنّ له دينًا عند رجل، وكان هذا المدين يطلب تأجيل وقت تسديد الدين ولكن مع فائدة، فلم يشترط هذا الراوي التأخير بفائدة حتى لا يقع في محذور الربا، بل باعه ثوبًا يستحق ثمنًا رخيصًا بثمن باهض مؤجل، فأجابه الإمام
: لا بأس بذلك. هنا يقول الراوي بأنّ له دينًا عند رجل، وكان هذا المدين يطلب تأجيل وقت تسديد الدين ولكن مع فائدة، فلم يشترط هذا الراوي التأخير بفائدة حتى لا يقع في محذور الربا، بل باعه ثوبًا يستحق ثمنًا رخيصًا بثمن باهض مؤجل، فأجابه الإمام  بجواز ذلك.
بجواز ذلك.
وورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: نبعث بالغلة فنأخذ ألفًا وخمسين منها بألف من الدمشقية، فقال الإمام الصادق  : لا خير في هذا، أفلا يجعلون لمكان زيادتها ذهبًا؟ فقلتُ: أفشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ لو جئتَ بدينار لم تُعْطَ ألف درهم، ولو جئتَ بألفي درهم لم تعطَ ألفي دينار! فقال: لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة - أي: فقهاء المالكية المعاصرين للإمام الباقر - مني، فكان يقول: لا بأس بذلك، وكانوا يعترضون عليه، ويقولون: هذا الفرار! لو جئتَ بدينار لم تُعْطَ ألف درهم، وكان يقول لهم: نعم الفرار من الحرام إلى الحلال!
: لا خير في هذا، أفلا يجعلون لمكان زيادتها ذهبًا؟ فقلتُ: أفشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ لو جئتَ بدينار لم تُعْطَ ألف درهم، ولو جئتَ بألفي درهم لم تعطَ ألفي دينار! فقال: لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة - أي: فقهاء المالكية المعاصرين للإمام الباقر - مني، فكان يقول: لا بأس بذلك، وكانوا يعترضون عليه، ويقولون: هذا الفرار! لو جئتَ بدينار لم تُعْطَ ألف درهم، وكان يقول لهم: نعم الفرار من الحرام إلى الحلال!
المقصود بالغلة الدراهم المغلولة، حيث كانت الدراهم في زمان الأئمة  على قسمين: قسم مغلول، وهو القسم المخلوط من فضة ونحاس مثلاً، وفي المقابل توجد دراهم خالصة - مصنوعة من فضة خالصة أو ذهب خالص - يعبّر عنها بالدراهم المصرية أو الدمشقية، وقد بيّن الإمام أن محذور الربا لا يمكن تجاوزه من خلال مقابلة الدراهم المغلولة بالدراهم الدمشية، ولكن يمكن تجاوزه من خلال مقابلة الدراهم الدمشية مع قطعة ذهب بالدراهم المغلولة.
على قسمين: قسم مغلول، وهو القسم المخلوط من فضة ونحاس مثلاً، وفي المقابل توجد دراهم خالصة - مصنوعة من فضة خالصة أو ذهب خالص - يعبّر عنها بالدراهم المصرية أو الدمشقية، وقد بيّن الإمام أن محذور الربا لا يمكن تجاوزه من خلال مقابلة الدراهم المغلولة بالدراهم الدمشية، ولكن يمكن تجاوزه من خلال مقابلة الدراهم الدمشية مع قطعة ذهب بالدراهم المغلولة.
وقد استشكل الراوي - وهو فقيه عالم - على الإمام  باعتبار أن الدينار لا يمكن مقابلته بالدراهم، فتحدث الإمام - كعادته - عن أبيه الباقر «عليهما السلام»، وكان كثير الاستناد إليه باعتبار أنه كان أكثر وقعًا عند علماء السنة من الإمام الصادق، أي أنهم كانوا يحترمون كلامه أكثر من الإمام الصادق
باعتبار أن الدينار لا يمكن مقابلته بالدراهم، فتحدث الإمام - كعادته - عن أبيه الباقر «عليهما السلام»، وكان كثير الاستناد إليه باعتبار أنه كان أكثر وقعًا عند علماء السنة من الإمام الصادق، أي أنهم كانوا يحترمون كلامه أكثر من الإمام الصادق  ، وإن كان أهل البيت
، وإن كان أهل البيت  كلهم علم ونور واحد. والخلاصة: أن هناك رواياتٍ تحدثت عن أن أهل البيت طرحوا حيلاً للتخلص من الربا.
كلهم علم ونور واحد. والخلاصة: أن هناك رواياتٍ تحدثت عن أن أهل البيت طرحوا حيلاً للتخلص من الربا.
وعلى كل حال، على الإنسان أن يسير حسب فتاوى مرجعه، وإنما أردتُ أن يفهم الشاب المثقف كيف يختلف الفقهاء في الأنظار وفي التوجهات وفي اقتناص الأحكام الشرعية؛ حتى يطلع على كيفية تفكيرهم ونظرهم للأمور.