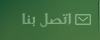الدرس 19 | وقفة مع المذهب التجريبي
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
بعد اتضاح المذهب العقلي لنا وقفة مع المذهب التجريبي وذلك من خلال ثلاثة محاور:
المحور الأول: في تعريف المذهب التجريبي وذكر برهانه وعرض نتائجه.
تعريف المذهب التجريبي:
قد تعرض لذلك مفصلاً السيد الشهيد قدس سره في كتابه فلسفتنا[1] إلى أن المذهب التجريبي هو المذهب القائل بأن التجربة هي المصدر الأول لجميع المعارف البشرية، ولا يوجد مصدر أسبق من التجربة وهي المصدر والمنبع لجميع المعارف البشرية.
البرهان على المذهب التجريبي:
وبرهانه على ذلك أن الإنسان يولد خالياً من كل معرفة بشهادة الوجدان، ويبدأ باستقبال المعارف عن طريق الحياة العملية والتي هي عبارة عن مخزون من التجارب والمشاهدات والأحاسيس، وكلما اتسعت تجاربه ومشاهداته أصبحت معارفه أضخم وأكثر، مما يعني ارتباط المعارف ارتباطاً جوهرياً بالتجربة فلا مصدر إلا التجربة.
نتائج المذهب التجريبي:
النتيجة الأولى: أن التجريبيين لا يعترفون بمعارف ضرورية، ولا يوجد لديهم ما يسمى بالمعارف البديهية أو الضرورية لأن كل معرفة لا بُد أن تُعرض على التجربة والمشاهدة؛ لأن التجربة هي المقياس في تصحيح كل معرفة من المعارف، وحتى الأحكام التي ادعى العقليون أنها أحكام بديهية ضرورية مثل «لكل معلول علة»، «كل شيء هو هو وليس غيره»، «الضدان لا يجتمعان»، كلها معارف ولولا التجربة لما ثبتت صحتها.
النتيجة الثانية: تحديد طاقة الفكر البشري بحدود الميدان التجريبي، فأي معارف خارج التجربة هي لهو وعبث، وكل بحث ميتافيزيقي أو دراسة لمسائل وراء الطبيعة كلها عملٌ أجوفٌ وعبث لا ثمرة فيه؛ لأن المعرفة الحقيقة هي المعرفة التجريبية.
المحور الثاني: في ركائز المذهب التجريبي وموقفه من المذهب العقلي.
الأمر الأول: ركائز المذهب التجريبي [2] وهي ركيزتان أساسيتان.
الركيزة الأولى: لا توجد قضايا بديهية أولية.
سبق أن عرفنا أن القضية البديهية هي التي يكفي تصور الموضوع وتصور المحمول في الحكم بها، لأن الحكم بها لا يحتاج إلى واسطة لا عقلية ولا تجريبية، فعندما نقول مثلاً «الكل أكبر من الجزء» لا نحتاج إلا أن نتصور الكل ونتصور الجزء ومن ثم نحكم بالنتيجة، وعندما نقول «العدم لا شيء» لا نحتاج أيضاً إلى تصور الموضوع فقط والمحمول ونحكم بهما، القضية البديهية ما يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول ولا يحتاج الحكم فيها إلى واسطة، وهذا ما ينكره المذهب التجريبي ويقول لا يوجد لدينا قضايا يكفي في الحكم بها تصور الموضوع والمحمول، وكل قضية لابد في الحكم بها من إقامة البرهان وهو التجربة.
الركيزة الثانية: أن الفكر البشري متقوم بالنمو والتصاعد من الجزئي إلى الكلي، وينتقل من الخاص إلى العام ومن العام إلى الأعم، بمعنى أن طريقة الفكر البشري مجبولة على الاتساع والنمو، وهكذا ولد الفكر البشري وهذه هي طريقته في التفكير فهو دائما يسير في أحكامه وتصديقاته من الأحكام الجزئية إلى الأحكام الكلية، ومن الأحكام العامة إلى الأحكام الأعم تماماً بعكس المذهب العقلي الذي يقول أن الفكر البشري طريقة تفكيره الانتقال من العام إلى الخاص ومن الكلي إلى الجزئي، لكن في المذهب البديهي ولد الفكر البشري أصلاً وهو يعيش فكرة التصاعد والنمو والاتساع لا فكرة الانتقال من العام إلى الخاص، ولذلك جميع الأحكام الكلية الموجودة في الذهن البشري اليوم والتي نسميها أحكام بديهية أولية مثل «التناقض مستحيل» و«لكل معلول علة»، فهذه كلها جاءت من التجربة، فإن الذهن في البداية قد أصدر أحكاماً بصورة جزئية ثم أصبحت بعد ذلك كلية، لأن الإنسان منذ بدء حياته قد تعلمها من مختبر الحياة الكبير نتيجة الاستقراء وتكرار التجربة.. إلخ.
إذن الاستقراء والتجربة قادا إلى هذه الأحكام التي نسميها الآن بديهية أولية.
الأمر الثاني: موقف الناقد على المذهب العقلي.
يتلخص موقفه الناقد في أن الاستدلال العقلي عن طريق القياس استدلال عقيم، والاستناد إلى المنطق الصوري المسمى بالمنطق الأرسطي واستخدامه في مقام الاستدلال هو استنادٌ عبثٌ وعقيم؛ لأن القياس الذي طرحه أرسطو إما تكرار أو مصادرة على المطلوب.
وإذا رجعنا إلى كتاب علم المنطق نتحدث عن المنطق الأرسطي الذي يعتمده المذهب العقلي في باب صناعة الاستدلال والبرهان ذكر في هذا الباب أن الدليل الموصل للنتيجة هو القياس، والقياس مكون من صغرى وكبرى وحد أوسط مكرر في الصغرى والكبرى ليوصل إلى النتيجة، ومثال على ذلك عندما نقول: «الإنسان مادة وكل مادة تتحول إلى طاقة، إذن الإنسان يتحول إلى طاقة» وهذا هو القياس، وقد ذكر في باب القياس أن له أشكالاً أربعة، والأشكال الأربعة كلها ترجع إلى الشكل الأول، والشكل الأول هو ما ذكرناه من أن «الإنسان» مادة صغرى وكل مادة تُكرر الحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، وكل مادة تتحول إلى طاقة، فبالنتيجة أن الإنسان يتحول إلى طاقة، يقول التجريبيون عندما تشكلون هذا القياس وتقولون أن «الإنسان مادة وكل مادة تتحول إلى طاقة، فالإنسان يتحول إلى طاقة»، فإننا قبل أن نذهب إلى النتيجة نأتي إلى الكبرى التي هي عمدة في الاستدلال «كل مادة تتحول إلى طاقة» فإن كلمة «وكل» هل لاحظنا فيها مادة الانسان؟ وهل استقرأت كل المواد ورأيت أن كل مادة تتحول إلى طاقة؟
الشق الأول: إذا لاحظت وقلت لا يصح مني أن أطلق حكماً كلياً قبل استقراء جميع مصاديقه وأفراده، ولأني قمت بالاستقراء ووجدت أن الإنسان المادي ماديته تتحول إلى طاقة أيضاً فقلت «وكل مادة تتحول إلى طاقة» إذن المعلومة موجودة ضمن قولك، فكلمة «الإنسان يتحول» يصبح فيها تكرار لأنك من الأول وقبل أن تصل إلى النتيجة هي معلومة موجودةٌ في كلمة «وكل» ولولا أن هذه المعلومة موجودة في كلمة «وكل» لما صح منك إطلاق الحكم الكلي، فأصبح تكراراً للمعلول.
الشق الثاني: عندما قلت «وكل» لم ألاحظ مادة الإنسان، يعني استقرأت كل المواد إلا مادة الإنسان لم ألاحظها ولم أدخلها في القضية الكلية، فإذا كنت لم تلاحظ كل المواد فإذن قولك كل مادة تتحول إلى طاقة مصادرة على المطلوب.
فإما أن تختار أن هذه الكلية جاءت عن استقراء تام وشملت الإنسان فالنتيجة تكرار، أو أنها لم تنشأ عن استقراء تام فإطلاق الكلية مصادرة على المطلوب، إذن الشكل الأول غير منتج، وسقط المذهب العقلي، لأن برهان المذهب العقلي يعتمد على المنطق الأرسطي، والمنطق الأرسطي يعتمد على باب القياس، وباب القياس يعتمد على الشكل الأول والشكل الأول عقيم.
المحور الثالث: ملاحظات نقدية على المذهب التجريبي
نأتي إلى كتاب أصول الفلسفة[3] ، لنرى ما هي هذه الملاحظات وهي ملاحظات مشتركة بين كتاب «فلسفتنا» وكتاب «أصول الفلسفة» وكأنهما كتاب واحد:
الملاحظة الأولى: جُعل المعيار في صحة القضايا هو التجربة، وهذا المعيار مبتلى بأربعة محاذير إما انهيار المذهب التجريبي أو التصديق بالمذهب العقلي أو عقم الإنتاج أو لزوم التسلسل أو السفسطة، وقد قال التجريبيون هذه المقالة الكبيرة «كل ما يأتي عن طريق التجربة فهو صحيح وكل ما لا يأتي عن طريق التجربة فهو باطل» وهذا هو أساس المذهب التجريبي وبعبارة أخرى التجربة أساس المعرفة، وكل ما يأتي عن التجربة صحيح وكل ما لا يأتي عن التجربة فهو غير صحيح، فنلخص القضيتين في قولنا أن التجربة أساس المعرفة.
هذه المقالة «التجربة أساس المعرفة» هل هي صحيحة أم خاطئة؟
- إذا قلتم أنها خاطئة إذن انهار المذهب التجريبي لأن عمدته هي هذه المقالة، فإذا كانت هذه المقالة خاطئة سقط المذهب، وسقوط المذهب محذور يستوجب القول عنها أنها صحيحة حتى لا يسقط.
- ولو قلنا أن هذه المقالة صحيحة التجربة أساس الصحة فهل هذه المقالة نشأت من التجربة أم لم تنشأ منها؟ فإذا قلتم لم تأتي من التجربة فصحة هذه المقالة جاءت من العقل وحده وهو الذي حكم بأن التجربة هي معيار الصحة، إذن أنتم صدقتم المذهب العقلي من حيث لا تشعرون وصدقتم أن هناك قضية لا يحتاج في إثبات صحتها إلى التجربة بل هي صحيحة بحكم العقل، وهذا ما يدعيه المذهب العقلي بأن عندنا قضايا صحيحة مسلّم بها بلا حاجة لاستخدام التجربة، وأما إذا قلتم أن «التجربة معيار الصحة» هي بنفسها خضعت للتجربة وهي بنفسها استقت الصحة من التجربة لا من حكم العقل، إذن قبل تجربتها استندنا على ماذا؟ إذا كانت استندت إلى التجربة فنحن نعود معكم إلى أول تجربة، وإذا رجعنا إلى أول تجربة فبأي معيار نثبت صحتها وضمان إنتاجها إذا لم يكن لدينا مبدأ عقلياً مسلمٌ بصحته قبل الدخول في التجربة، فأول تجربة من أين اكتسبت صحتها؟ فإن أثبتنا صحة التجربة بالتجربة قبل أن نبدأ التجربة فهذا أمر غير معقول لأن الشيء لا يُثبت صحة نفسه وهذا هو معنى عقم الإنتاج.
أو أن تقولوا أن التجربة أثبتت صحتها بالتجربة والتجربة أثبتت صحتها بالتجربة والنتيجة هي لزوم التسلسل إلى ما لا نهاية ولن نقف عند حال، فيلزم التسلسل أو السفسطة لأن التجربة الأولى لا نستطيع أن نثبت صحتها فنبقى في شك وكل ما يبنى على ما هو مشكوك فهو مشكوك الصحة والنتيجة هي السفسطة وعدم التصديق بأي قضية.
فيتلخص من ذلك أن الملاحظة النقدية الأولى على المذهب التجريبي أن جَعْلَ معيار الصحة هو التجربة مبتلى إما بانهيار المذهب أو التصديق بالمذهب العقلي أو عقم الإنتاج أو لزوم التسلسل أو السفسطة.
الملاحظة الثانية: تعرض لها السيد الصدر قدس سره في كتابه[4] ، وملخص هذه الملاحظة أنه لا يمكننا أن نكتشف جهة الوجود، فنحن لدينا وجود ولدينا جهة الوجود، فوجود الإنسان له جهة وهو أنه ممكن، ووجود المعلول عند وجود العلة فله جهة وهو «وجوب» أي لابد أن يوجد، وجود النقيضين له جهة وهو «الامتناع» وكل وجود له جهة معينة، فإذا وجدت العلة كالنار وجب وجود المعلول وهو الحرارة «فوجود المعلول واجب»، وإذا وجد الإنسان هل يلزم أن يوجد معه وجود آخر؟ ممكن ولكن غير واجب، هل يمكن أن يوجد النقيضان؟ لا غير ممكن بل ممتنع، إذن كل وجود له جهة إما «الإمكان» أو «الوجوب» أو «الامتناع»، ولا يمكن اكتشاف جهة الوجود التي لا ينفك عنها وجود وهي إما الإمكان أو الوجوب أو الاستحالة عن طريق التجربة، فبالتجربة لا يمكن أن نثبت أن هذا ممكن أو واجب أو مستحيل، مع أننا نذعن بهذه الأحكام ونذعن بأن الإنسان ممكن وبأن الحرارة واجبة عند وجود النار، ونذعن بأن النقيضين يمتنع وجودهما، ومع إذعاننا بوجود أحكامٍ وهي أحكام جهة الوجود ولكن هذه الأحكام لا يمكن اكتشافها عن طريق التجربة.
عبارة السيد الشهيد «قدس سره» [5] أن الفكر لو كان محبوساً في حدود التجربة فقط ولم يكن يملك معارف مستقلة لما أتيح له أن يحكم باستحالة شيء، لأن الاستحالة ليست مما يدخل في نطاق التجربة ولا يمكن للتجربة أن تكشف عنه لأن قصارى ما تتيحه التجربة هو عدم الوجود، أما إثبات عدم الوجود لأنه مستحيل فهذا أمر لا تثبته التجربة، ثم يقول: ”فكم يبدو الفرق جلياً بين اصطدام القمر بالأرض أو وجود بشر في المريخ أو وجود إنسان يتمكن من الطيران، وبين وجود مثلث له أربعة أضلاع، ووجود جزء أكبر من الكل ووجود القمر حال انعدامه“، من ناحية أخرى فإن هذه القضايا جميعاً لم تتحقق ببركة التجربة لكن لو كانت التجربة هي المصدر الرئيسي للمعارف لما استطعنا أن نفرق بين فئتين من القضايا ونقول أن الفئة الأولى ممكنة والفئة الثانية مستحيلة، لأن التجربة لا تستطيع سوى إثبات التحقق أم لا، ولا تقول أكثر من ذلك مع أننا نرى بالوجدان أن هناك فرقاً جوهرياً بين هاتين الفئتين من القضايا. فالمثلث لا يكون له أربعة أضلاع واصطدام القمر بالأرض فهو وإن لم يحصل لكنه أمر ممكن وهذا الحكم بالاستحالة لا يمكن تفسيره إلا على ضوء المذهب العقلي، وبأن يكون من المعارف المستقلة عن التجربة، وعلى هذا الضوء فإن التجريبين بين سبيلين لا ثالث لهما إما أن يعترفوا بالاستحالة كالأشياء التي عرضناها من الفئة الثانية أو ينكروا الاستحالة، فإن اعترفوا بالاستحالة كان هذا اعترافاً بالمذهب العقلي لأن الاستحالة لا يقررها إلا العقل وحده وإن أنكروها ولم يقروا بها فلا يبقى على أساس هذا الإنكار فرق بين فئتين من القضايا، مع أننا بالوجدان نرى أن هناك فرقاً بينهما.
الملاحظة الثالثة[6] : أن التجربة محدودةٌ بزمنٍ ومكانٍ وعدد، فنحن الآن نريد أن نثبت أن كل ماء بلغت درجة حرارته مئة فإنه يغلي، ولكي تنتج التجربة قضيةً كليةً نحتاج إلى ثلاث صفات: الكلية والدوام والضرورة، فكيف تنتج قاعدة وهي ليست كلية، الدوام تعني أنه دائماً إذا بلغت درجة حرارة الماء فإنه يغلي، والضرورة تعني فيه ملازمة بين الغليان وبين درجة الحرارة مئة، فالقاعدة تحتاج إلى ثلاثة عناصر ألا وهي الكلية، الدوام، والضرورة، فكيف يمكن لتجربة خضعت لزمن ومكان وعدد أن تنتج قاعدة تتمتع بكلية ودوام وضرورة؟ لكي تصل التجربة إلى القاعدة نحتاج إلى أصول عقلية، وما لم تكن هناك هذه الأصول العقلية فلا يمكن للتجربة أن تتحول إلى قاعدة تمتلك هذه العناصر الثلاثة، وأول أصل هو امتناع التناقض.
يدّعي أصحاب المذهب العقلي أن التناقض قضية ضرورية وأنها سابقة على التجربة بمعارف لولاها لما أنتجت التجربة، بعكس المذهب التجريبي الذي يقول أنها جاءت من التجربة وأن كل المعارف عرفت بعد التجربة، وأول أصل قبلي سابق على التجربة هو امتناع التناقض، فما معنى أن التناقض ضرورة عقلية؟
الأمر الأول: يشرح السيد الصدر في فلسفتنا هذا المعنى[7] ويقول أن العقليين حينما يقولون إن هذه المبادئ ضرورية ومنها امتناع التناقض فهم يعنون أن الذهن إذا تصور المعاني التي تربط بينها استنبط المبدأ الأول من دون حاجة لسبب خارجي وهذا معنى الضرورة، وليس مثل قول المدرسة العقلية التي سبق بحثها في قسم التصورات قالوا بأنها وُلدت مع الإنسان مما يعني أن الإنسان ولد وهو يؤمن باستحالة التناقض، ولا نقصد بالضرورة هذا المعنى بل نقصد بالضرورة بأنه لا يحتاج إلى تجربة فقط، وهذا المبدأ الذي يعني التصديق بأن «وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان» ليس موجوداً عند الإنسان في لحظة وجوده الأولى بل يتوقف على تصور الوجود أولاً وتصور العدم، وتصور اجتماع الوجود والعدم، وبدون تصور هذه الأمور لا يمكن له أن يصدق أن الوجود والعدم لا يجتمعان، لأن تصديق الإنسان بشيء فرعُ تصوره، وقد عرفنا عند تعليل التصورات أنها ترجع جميعاً إلى الحس، مما يعني أنهم يوافقون المدرسة الحسية بأن التصورات تأتي من الحس، فتصور الوجود جاء من الحس وتصور العدم جاء من الحس وكل هذه التصورات استرفدناها من الحس، وبعد أن وردت هذه التصورات عن طريق الحس قَارَنَ الذهنُ بين الوجود والعدم من حيث الاجتماع وعدم الاجتماع فأذعن بأن الوجود والعدم لا يجتمعان ولكن هذا الإذعان لا يحتاج فيه إلى إقامة تجربة، فمعنى أنه ضروري أي عدم الحاجة فيه إلى إقامة تجربة وليس معنى أنه ضروري أنه ولد به الإنسان، فافهم واغتنم.
الأمر الثاني: [8] هناك قضية يكررها أهل الحكمة وهي أن امتناع التناقض أولى الأوائل، مما يعني أن أول قضية يؤمن بها الإنسان هي امتناع التناقض، فلذلك ربما هنا يُطرح سؤال يقول أنتم أيها العقليون تقولون بأن لديكم عدة قضايا بديهية، لديكم «أن لكل معلول علة» قضية بديهية ومبدأ الهوية «كل شيء هوهو وليس غيره» قضية بديهية، «تقدم الشيء على نفسه محال» قضية بديهية ولم تحصروا البديهي في التناقض فقط، فهل هذه القضايا البديهية هي في عرض امتناع التناقض أم هي في طوله؟ فإذا قلتم أن القضايا البديهية الأخرى في عرض امتناع التناقض فهذا يعني أن الذهن لا يحتاج في الإيمان بها إلى الإيمان بامتناع التناقض، وكما أن الذهن يؤمن بامتناع التناقض فهو يؤمن بأن «لكل معلول علة» في عرض واحد، فإذا كان هكذا إذن لم يحصل امتناع التناقض أولى الأوائل، صار هو وغيره من القضايا البديهية في عرض واحد.
أما لو قلتم بأنه لا يمكن للذهن بأن يحكم ب «أن لكل معلول علة» وب «أن الدور محال» إلا إذا حكم أولاً بامتناع التناقص إذن أصبحت هذه القضايا قضايا نظرية وليست بديهية، فكيف تسمى بديهية وهي يحتاج الحكم بها إلى الحكم أولا بامتناع التناقض!
هذا السؤال أجاب عنه الشيخ المطهري تبعاً للعلامة الطباطبائي رحمهما الله بأنه قال: فرق بين احتياج البديهيات لامتناع التناقض وبين احتياج النظريات للبديهيات، فالقضايا النظرية تحتاج إلى القضايا البديهية ولذلك تسمى قضايا نظرية «كل ماء تبلغ درجة حرارته مئة فإنه يغلي» هي قضية نظرية وإنما سميناها قضية نظرية لأنها تحتاج إلى مجموعة من القضايا البديهية، لكن قضية «إنما لكل معلول علة» هي قضية بديهية وإن احتاجت إلى قضية امتناع التناقض، ففرق بين الاحتياجين بين احتياج القضايا النظرية للبديهية وبين احتياج القضايا البديهية إلى قضية أولى الأوائل وهي امتناع التناقض.
يقول في أصول الفلسفة[9] احتياج النظريات إلى البديهيات هو أن النظريات بتمام وجودها مدينة للبديهيات، فكل ولادتها من البديهيات، والقضايا النظرية سميت بالنظرية لأنها تولد بتمام شؤونها من القضايا البديهية.
والحمد لله رب العالمين