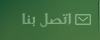الدرس 44 | كيف نثق بإحكام العقل مع كثرة الأخطاء فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
هذا السؤال والذي يُعد من المفاتيح الأساسية لنظرية المعرفة، حيث إنه يطرح من قبل عدةٍ من الباحثين - سواء في الغرب أو في الشرق - وهي أنه بعد أن اكتشفنا كثيراً من الأخطاء في الاستدلالات العقلية، سواء في استدلالات الفلاسفة أو استدلالات غيرهم، فمثلاً في موارد الاختلاف قطعاً أحدُ المختلفين خطأ والآخر صحيح، وما أكثر موارد الاختلاف سواء الاختلاف الديني أو الاختلاف الفلسفي أو الاختلاف في أي علم من العلوم، فالاختلافات تَكْشِفُ عن أن هناك نسبة من الأخطاء في الأحكام العقلية، وأن هناك نسبة من الأخطاء في الاستدلالات العقلية إذْ لا يُمكن أن يكون جميع المختلفين على صحة في آرائهم، فاذا استكشفنا أن كثيراً من الأخطاء في الأحكام العقلية والاستنتاجات والاستدلالات فلا يُمكن حصول الوثوق - فضلاً عن اليقين - بأي حكم عقلي، فمتى ما طُرح علينا استدلال عقلي لا يمكن أن يحصل لنا الوثوق فضلاً عن اليقين بصحة هذا الحكم العقلي بعد اكتشافنا لكثيرٍ من الأخطاء في الأحكام والاستدلالات العقلية، فما هو الجواب المحوري عن هذا السؤال؟
هناك اجابتان تعرض لهما السيد الشهيد - قدس سره - في بحثه الاصولي، وناقشهما وارتضى أجوبة أخرى:
الإجابة الأولى: وهي تبتني على مقدمتين:
المقدمة الأولى: أن اليقين الذي نَبحث عنه هو اليقين المنطقي - حيث أن السؤال كان عن اليقين كيف يحصل لكم اليقين بأي حكم عقلي مع اكتشافكم كثرة الأخطاء في الاحكام العقلية - فاليقين نوعان، وبيانهما:
النوع الأول: اليقين الأصولي.
هناك بحثٌ في علم الاصول يُعبّر عنه بحجية القطع «هل القطع حجة أو ليس بحجة؟»، فإذا جَزم الإنسان بتكليف من التكاليف كما إذا جزم بوجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة أو جزم بوجوب الحج حتى مع وجود الوباء وغيرها من الأمور، فهل جَزْمُه وقطعه حجةٌ عليه أم لا؟ وهذا بحث أصولي يُعبّر عنه ببحث حجيّة القطع، وهذا لا علاقة له الآن ببحثنا في نظرية المعرفة لأن البحث عن حجية القطع بحثٌ عن فراغ عهدَةِ المكلف بالعمل بالقطع، أي يعني لو أنني قطعت - مثلا - بإباحة حلق اللحية، وعملت بقطعي، فهل العمل بالقطع مفرغ للعهدة ومبرئ للذمة؟ وهذا ما يبحثه الأصوليون، فمعنى حجية القطع العمل بالقطع في الأحكام الشرعية هل هو مُعذّرٌ أمام الله أم لا؟ هل هو مُنَجِّزٌ لحكم واقعي أم لا؟ وهناك رأيان معروفان في علم الأصول حول حجية القطع، وبيانهما:
الرأي الأول: حُجية القطع حجةً عقلية.
وهذا الرأي المشهور - كما عليه السيد الخوئي - قدس سره - وأغلب تلامذته الحجية العقلية للطريقية الذاتية، فالسيد الخوئي والمشهور أيضا من علماء الأصوليين يقولون نعم القطع حجة عقلية ولا مجال للتشكيك فيه، فيُمكن التشكيك في حجية الظن وفي حجية الاحتمال أما حجية القطع فهي حجيّة عقلية يحكم بها العقل؛ لأن للقطع طَرِيقيّةً ذاتية، وهذا سبق أن ذكرناه عندما عرفنا العلم وقلنا أن الكاشفية من مقومات العلم، فالقطع من خصائصه الذاتية أنه كاشف، ولذلك اشتهر عند الأصوليين هذه العبارة «القاطعُ لا يرى إلا الواقع»؛ لأن القطع نفسُه فيه خاصية الكشف والإراءة، فكل من قطعَ بشيء يرى أَنَّهُ أَدْرَكَ الواقع، فلو قلت له أنت لم تُدرك الواقع، يقول أنا قاطع فكيف أكون لم أدرك الواقع؟! فالقاطع لا يحتمل أنه أخطأ الواقع، فللقطع طريقية ذاتية في الكشف عن الواقع لكن في الكشف عن الواقع بنظر القاطع، فقد أكون أنا الآخر اعتبره جاهلاً مركباً، فمثلا شخص يقول بأن الأرض مسطحة أنا أرى بأنه جاهل مركب، لكن هو لأنه قاطع بما يرى هو لا يرى إلا الواقع، فللقطع كاشفية ذاتية، أي من ذاتيات القطع أنه كاشف عن الواقع، فبما أن القطع له طريقية ذاتية وكاشفية ذاتية إذن حجيته حجية عقلية، فمن قطع بحكم إلزامي تنجّز عليه الحكم ولزمه العمل بما قطع به، ومن قطع بحكم ترخيصي فالعمل بقطعه معذّر له أمام الله، وهذا الرأي المشهور لدى الأصوليين.
الرأي الثاني: حجية القطع العقلائي وليس أي قطع.
وهو رأي السيد السيستاني - دام ظله - أن القطع المعذر هو القطع العقلائي وليس أي قطع، فلا بُد أن ينحدر عن مناشئ عقلائية، فلا يمكن أن يكون مطلق القطع معذراً ومنجّزاً، صحيح أن القاطع لا يرى بنظره إلا الواقع والقاطع يرى أنه وصل إلى الحكم، أما إذا كانت المناشِئ التي استند إليها في الوصول إلى قَطْعِه مناشئ عقلائية - أي لو عَرَضْتَ على المجتمع العقلائي لرآها مناشئ مصيبة ومقبولة - حينئذ يكون قطعه معذِّراً له ومنجِّزاً له، وأما إذا كانت المناشئ التي يستند إليها مناشئ لا توجب القطع، فهذه التي اسْتَندَ إليها وعلى أساسها قَطَع لا تُوجب القطعَ ولا توصل إلى اليقين فلا يكون حينئذ قَطعه معذراً له حتى لو كان قاطعاً ولا يحتمل الخلاف، فلا يكون قطعه معذراً ولا منجّزاً، لذلك فرق بين اليقين الذاتي واليقين العقلائي، فاليقين الذاتي هو مطلق القطع، واليقين العقلائي هو اليقين الناشئ عن مناشئ وقرائن عقلائية.
هذا هو البحث الأصولي، وهذا لا علاقة له بالبحث الفلسفي، فالبحث الفلسفي يبحث عن اليقين بالنوع الثاني وهو اليقين المنطقي.
النوع الثاني: اليقين المنطقي.
اليقين المنطقي هو المضمون الحقانية، فعلماء المنطق غير علماء الأصول، فعلماء الأصول يركزّون على اليقين من حيث أنه يُبْرِئ الذمة أم لا، فليس عَمَلُهُم أن هذا اليقين طابق الواقع أم لم يُطابِق الواقع، بينما علماء المنطق يُرَكزونَ على اليقين المطابق للواقع وهو ما يُعبّر عنه باليقين المضمون الحقانية، أي مضمون مطابقته للواقع، وهذا هو البحث، وهو ما يرتبط بالبحث الفلسفي في نظرية المعرفة.
المقدمة الثانية:
وهو ما طرحه جملة من الباحثين حيث قالوا: إذا اكتشفتم خطأً في مجموعة من الأحكام العقلية يزول اليقين بالأحكام الأخرى، فلنفترض عندنا مجموعتين «أ» و«ب»، فالمجموعة «أ» اكتشفنا خطأها فزال اليقين بالمجموعة «ب» مع أننا لم نكتشف خطأها، ولكن العلم بالمجموعة «أ» وهي مجموعة أحكام عقلية أزالت اليقين بالمجموعة «ب»، وهذا كان الاستدلال.
السيد الشهيد - قدس سره - في هذا الجواب يقول أنكم تبنون على تلازمٍ بحيث إذا أخطأت الأولى أخطأت الثانية، فهنا تُعبّرون عن تلازم وترابط بحيث إذا أخطأتْ الأحكام الأولى أخطأت الأحكام الثانية، فهل هذا الترابط صحيح؟ فإذا حصل للإنسان يقينٌ بخطأ مجموعة «أ» زال اليقين بصحة مجموعة «ب» فهل هذا الترابط في اليقين بين المجموعتين لا بُد له من سبب، فالترابط بين المجموعتين لا بُد له من سبب ومنشأ، وهذا ينشأ عن أحد عوامل ثلاثة:
العامل الأول: التلازم الموضوعي بين القضيتين.
القضيتان متلازمتان بحيث تصح الأولى تصح الثانية، تخطئ الأولى تخطئ الثانية، ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[1] فقضيتان متلازمتان، وكما يقولون في القياس الاستثنائي في المنطق «ملزوم ولازم» فإذا ثبت بُطلانُ اللازم اكتشف بطلان الملزوم، فلو كان هناكَ تَعددٌ في الآلهة لكان هناك فَسادٌ في الكون وخَللٌ، وحيث إنه لا خلل في الكون إذن لا تعدد في الآلهة، فإذا ثبت بطلانُ اللازم وهو الخللُ في الكون ثبت بطلان الملزوم وهو أن لا تعددَ في الآلهةِ، فالتلازم الموضوعي بين القضيتين نحو الملازمة بين تعدد الآلهة وفساد الكون، فهنا نُسلّم أنه إذا كان بين المجموعتين تلازمٌ موضوعي بأن تكون إحدى المجموعتين علة للأخرى فإذا بطلت إحداهما بطلت الأخرى فهنا نقر معكم بأن الترابط هنا صحيح.
العامل الثاني: وقوع قضية في مقدمات الاستدلال على صحّة قضية أخرى.
وهنا نأتي بمثالين:
المثال الأول: العقول العشرة. [2]
وهو المثال الفلسفي المعروف بالعقول العشرة، فما هو الدليل على وجود العقول العشرة [3] ؟ قالوا أن الدليل أن عندنا سبعة أفلاك، فإذا كان عندنا سبعة أفلاك و«الواحد لا يصدر إلا من واحد»، إذن لكل فلك عِلّة، فنحن عندنا سبعة أفلاك مستقلة وبما أن هناك سبعة أفلاك مستقلة وهناك قاعدة عقلية مسلمة وهي «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» إذن لا يمكن لعلة واحدة أن تُصدر عدّة أفلاك، فلكل فلك علّة، ونحن تحصّلْنا على سبعة علل، فهذه سبعة عِلل لسبعة أفلاك، وهذه أسميناها عقول سبعة، ثم جئنا بعلة للعرش وعلة للكرسي وعلة، فصارت العقول عشرة، فتوصلوا لنظرية العقول العشرة اعتماداً على مقدمتين، مقدمة عقلية لا مشكلة فيها «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد»، ولكن مقدمة ثانية فلكية ليست صحيحة وهي أن عدد الأفلاك سبعة، فإذن وقعتْ قضيةٌ مُقدّمة للاستدلال على قضية أخرى وهي «أن الأفلاك سبعة» فهذه قضية، وهذه القضية وقعت مقدمة للاستدلال على قضية أخرى وهي وجود العقول العشرة، فإذا اكتشفنا خطأ المقدمة اكتشفنا خطأ النتيجة، فلا يُمكن لنا اليقين بالنتيجة إذا كانت إحدى المقدمات خاطئة، وهنا نُسلم أنه متى ما اكتُشِفَ خطأ مقدمةٍ من مقدمات الاستدلال فاليقين بالنتيجة يزول، فالكلام يكون هنا صحيح.
المثال الثاني: مسألة تحريف القرآن الكريم.
قيل بأن «الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم» وذلك لوجود روايات في الكتب المعتمدة في لدى الشيعة تدل على نقص القرآن عن القرآن الموجود بين المسلمين، فما دام توجد روايات تدل على نقص القرآن الكريم عن القرآن الموجود بين المسلمين، إذن الشيعة يقولون بتحريف القرآن وهو التحريف بنحو النقص. هنا نقول ارجع إلى المقدمة التي استندت إليها، فهذه الروايات غير صحيحة السند، ثانياً وجود روايات شيء ووجود اعتقادٍ شيء آخر، فهذه الكتب ضمّت روايات مقبولة وروايات غير مقبولة، فمجرد وجود روايات تدل على نقص القرآن لا يعني أن علماء الشيعة قائلون بتماميّة مضمون هذه الروايات حتى يُعتمد عليها في نسبة التحريف للقرآن الكريم.
إذن إذا بطلت إحدى مقدمات الاستدلال زال اليقين بالنتيجة.
العامل الثالث: النسبة الرياضية بين المقدار الخاطئ ومجموع القضايا العلمية.
إذا كانت النسبة نسبة معتداً بها منعت اليقين الرياضي، وهنا نضرب أمثلة:
مثال:
نأتي إلى من أصيب بالكورونا إصابة حرجة - بغض النظر عن الوفيات - وقارنا بين من تناول اللقاح وبين من لم يتناول فنقول: نسبة المصابين بالكورونا إصابة حرجة في من لم يتناول جرعات اللقاح نسبةٌ معتدٌ بها، فلنفترض أنها نسبة «10%» بينما نسبة المصابين ممن تناول جرعات اللقاح نسبة «1%» وفرق بين النسبتين من حيث دليل حساب الاحتمالات، فإذا كانت النسبة هي نسبة «1%» أو نسبة «0%» أو أي نسبة فإنها لا تمنع من اليقين - حسب دليل حساب الاحتمالات - الرياضي، فأنا على يقين من أن تناول جرعات اللقاح يقي من الخطر، قد تقول أن هناك أناساً أصيبوا، أقول نعم إلا أن هذه النسبة ليست نسبة معتداً بها، فهي لا تمنع من حصول اليقين الرياضي وهي أن تناول جرعات اللقاح يقي من الخطر، بينما في المقابل نسبة من أصيب بالخطر ممن لم يتناول جرعات اللقاح نسبة معتدٌ بها فيزول عندي اليقين، فمن لم يتناول اللقاح ليس عندي يقين بعدم إصابته لأن نسبة من أصيب هي نسبة معتدٌ بها.
مثال آخر:
قبل 50 سنة في القطيف قالوا أن فلاناً ضربه الجن وكل شيء ليس له تفسير جعلوه في الجن، فتُفسر كثير من القضايا بالجن، فعندما تُقارن النسبة، أي نسبة الأخبار الواردة عن تصرف الجن في الإنسان لمجموع الأخبار الواردة عن الجن تجدُ أن نسبة الأخبار التي ذُكرت عن تصرف الجن في الإنسان نسبة كذبها نسبة كبيرة، فهي تمنع من حصول اليقين بأن للجن تصرفاً في الإنسان.
إذن هذا عامل رياضي مسلم يمنع من حصول اليقين.
السيد الصدر - قدس سره - يقول أن أمامك عوامل ثلاثة، فأيها المدعون أنه إذا زال اليقين بمجموعة من الأحكام العقلية فلا يحصل يقين أبداً بحكم عقلي، فإنه إما أن تستندوا للتلازم الموضوعي وهذا ليس موجوداً في كل القضايا، أو تستندوا إلى وقوع قضية مُقدِّمَة للاستدلال على قضية أخرى وهذا مقدار بسيط في الأحكام العقيلة، أو تستندوا إلى أن نسبة الأخطاء في الأحكام العقلية لمجموع الأحكام العقلية نسبةً معتدٌ بها وهذا مما لا صحة له لأن الأحكام العقلية التي ثبت خطؤها منذ نبي الله نوح -  - إلى يومنا هذا مقارنة بالنسبة للأحكام العقلية الصحيحة التي يتعامل بها الإنسان في كل شؤون حياته يجد أن نسبة الأحكام العقلية التي اكتشف خطؤها من مجموع الأحكام العقلية هي نسبة غير معتد بها فلا تمنع من حصول اليقين بالأحكام العقلية، ولذلك السيد الصدر يقول: ”ولذلك قلنا وجميع ما سوى ذلك فهو تلجلج عقلي أو مرض ذاتي“، فلو أحد يقول أننا اكتشفنا أخطاء فإنه ليس عندنا يقين بأي حكم، فهذا عنده مشكلة، فإما عنده تلجلج عقلي فدائماً لما يأتيه شيء عنده حالة من الشك، أو عنده مرض - كالوسواس مثلا - ”وجميع هذه المناشئ مما لا تنطبق على القضايا العقلية الاستدلالية فلا تصلح للمنع من حصول اليقين المنطقي“.
- إلى يومنا هذا مقارنة بالنسبة للأحكام العقلية الصحيحة التي يتعامل بها الإنسان في كل شؤون حياته يجد أن نسبة الأحكام العقلية التي اكتشف خطؤها من مجموع الأحكام العقلية هي نسبة غير معتد بها فلا تمنع من حصول اليقين بالأحكام العقلية، ولذلك السيد الصدر يقول: ”ولذلك قلنا وجميع ما سوى ذلك فهو تلجلج عقلي أو مرض ذاتي“، فلو أحد يقول أننا اكتشفنا أخطاء فإنه ليس عندنا يقين بأي حكم، فهذا عنده مشكلة، فإما عنده تلجلج عقلي فدائماً لما يأتيه شيء عنده حالة من الشك، أو عنده مرض - كالوسواس مثلا - ”وجميع هذه المناشئ مما لا تنطبق على القضايا العقلية الاستدلالية فلا تصلح للمنع من حصول اليقين المنطقي“.
الإجابة الثانية: إن الخطأ في الاستدلال عبر القياس العقلي - أي عبر الاستدلال العقلي - إما في المادة أو الصورة. [4]
أنت تقول أنك اكتشفت أن هناك أخطاءً في الأحكام العقلية فإننا نسأل هذه الأخطاء التي اكتشفتها هي أخطاء في المادة أو الصورة؟ فإما أن يكون مدّعاك أن اكتشفت أخطاء في المادة - أي في المضمون - أو تدعي أنك اكتشفت أخطاءً في الصورة - أي هيئة الاستدلال -، فإن ادعي الأول - أي الأخطاء في المادة والمضمون - فهو ممنوع؛ لأن المادة المستخدمة في الاستدلال إما من القضايا الأولية - استحالة اجتماع النقيضين، استحالة الدور، لكل معلول علّة - وهي يقينية ولا يُتصور اكتشاف خطئها، أو من القضايا الثانوية وما دامت ثانوية إذن هي مستنتجة من قضايا أولية، فكل قضية ثانوية مستنتجة من قضايا أولية، وهنا رجعنا للقياس مرة أخرى لأن الاستنتاج لا يتم إلا عبر القياس والاستدلال، فهنا نرجع للسؤال مرة أخرى: «الخطأ أين؟» فإذا كان في المادة نرجع نسأل ذات الأسئلة، وإن ادعي الثاني - أي الخطأ في الصورة - فإن علم المنطق عاصم، فأنت لمّا تذهب لكتاب علم المنطق للشيخ المظفر يقول: «علم المنطق هو قواعد تعصم مراعاتها الخطأ في الذهن»، فالذهن لا يخطئ في الاستدلال إذا راعى قواعد علم المنطق، ومعنى هذا أن علم المنطق يعصم من الخطأ في الصورة ولا تخطئ في هيئة الاستدلال ما دمت تسير على ضوء قواعد علم المنطق.
إذن أي الخطأ؟ فالخطأ الذي اكتشف في المادة ممنوع وفي الصورة علم المنطق يعصم منه، إذن اكتشافك خطأً في قضية عقلية لا يستلزم زوال اليقين بالقضايا العقلية الأخرى لأن القضايا العقلية الأخرى إما أن يستند الخطأ فيها إلى المادة وهي مادة أولية، أو يستند الخطأ إليها للهيئة وعلم المنطق يعصم من الخطأ في الهيئة، فلا خطأ في القضايا الثانية.
السيد الشهيد - قدس سره - سجل على هذا ملاحظة أساسية.
السيد الصدر أراد أن يقفز بعلم المنطق إلى مستوى أعلى، ولذلك يرجع إلى المنطق الصوري - فهو صوري لأنه يركز على صورة الاستدلال وهيئته - فيقول: يا علماء المنطق الذين قلتم بأن علم المنطق هو عبارة عن قواعدَ تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، نسأل كيف تكون عاصمة؟ هل قواعد علم المنطق ضرورية كبرىً وتطبيقاً؟ أو ضرورية تطبيقاً لا كبرىً؟ أو ضرورية كبرىً لا تطبيقاً؟ فمنذ أيام أرسطو إلى الآن وهذه الأخطاء التي تحصل عند البشر وأنتم لا زُلتم تقولون أن علم المنطق هو علم تعصم مراعاته الخطأ في الفكر، فهل تدّعون أن قواعد علم المنطق بديهية كبرى وتطبيقاً؟ أي هي القواعد بديهية وتطبيقها بديهية، القواعد يقينية وتطبيقها على الصغريات والموارد أيضاً يقيني، فهل تدعون ذلك؟ فإذا كان هكذا يكون لا خطأ في البشرية أبداً، بينما نرى الكثير الذي يمشي على قواعد علم المنطق ويدقق فيها تتبين أخطاؤه، فلو كانت قواعد علم المنطق ضرورية - أي من اليقينيات والبديهيات - كبرى وتطبيقاً لما حصل خطأ والحال أن الأخطاء حاصلة، إذن هذه الدعوى غير صحيحة.
”فإما ضرورية كبرى وتطبيقاً، ولازمه عدم وقوع خطأ أصلاً، وهو منافي للوجدان“، أو تعدون أنها خطأ كبرىً، أي أن نفس قواعد علم المنطق فيها أخطاء، إذن أي يكون علم المنطق عاصماً إذا كانت نفس قواعدهِ معرضاً للخطأ، فإذا بعض قواعد علم المنطق - أي بعض كبرياته - معرض للخطأ، إذن كيف يكون علم المنطق مراعاته تعصم الذهن إذا كان الخطأ في الكبرى؟! أو تقولوا أن القواعد نفسها ضرورية بديهية إنما الكلام في التطبيق، فليس كل أحد يتقن التطبيق، فالخطأ يقع في التطبيقات لا نفس القواعد، فالقواعد مثل قواعد علم النحو الآن، فكثير يدرس النحو وقد يكون مدرس نحو إلا أنه يخطئ، فإذا قلتم أن الخطأ في التطبيق فإن هذا أكثر الناس واقعون فيه، فالقواعد واضحة إلا أن التطبيق على مواردها خطأ.
”وإذا قلتم أن التطبيق في التطبيق الذي مرجعه للخطأ في المادة - أي المادة تطبيق هذه الكبرى على هذه المادة خطأ وبالنتيجة صار خطأ في المادة - وإذا كان خطأ في المادة حينئذ احتجنا إلى عاصم في مجال التطبيق“، فلا يكفي عاصم في القواعد، فأنت وضعت قواعد إلا أنك تعلم أن القواعد ليست هي المشكلة وإنما المشكلة في تطبيقها، لذا أنت بحاجة إلى عاصم في مجال التطبيق، فلا يكفي وجود قواعد، فحتى يُضمن قلة الخطأ - تنزلاً عن القول بعدم الخطأ - نحتاج إلى عاصمين، عاصم في القواعد وعاصم في التطبيق.
وهنا نذكر مثالاً يذكره الفلاسفة ويستدلون به:
عندنا قاعدة عامة «العلّة والمعلول متعاصران زمننا متفاوتان رتبةً»، وهنا نمثل بحركة اليد وحركة المفتاح، فهنا حركت يدي فتحرك المفتاح، فحركة اليد علة وحركة المفاتح معلول، فهما متعاصران زمناً، فلا يُعقل أن تحصل حركة يد دون حركة مفتاح، ولا يعقل أن تحصل حركة يد، فالعلة والمعلول متعاصران زمناً متفاوتان رتبةً لأن العلّة مفيض والمعلول مُفاض. كذلك النار والحرارة، فلا يُمكن أن تكون نار بدون حرارة، فالنارة علّة للحرارة، فهما متعاصران زمناً ومتفاوتان رتبةً، فالنار مفيض والحرارة مفاض.
هنا أيضا جاؤوا وطبقوا هذه القاعدة على الله - سبحانه وتعالى - فقالوا، ألستم تقولون أن العلة والمعلول متعاصران زمناً، أليس الله علة للوجود؟! إذن الوجود معاصر لله، فيكون الوجود أزلي، ولهذا من ذهب لقدم العالم - كما ذهب بعض الفلاسفة - فيقولون أنه ما سبق العالم عدم زماني، وإنما سبقه عدم رتبي، أي أن هذا العالم لم يكن ثم كان بل هو كائن منذ الأزل، أما لأن الله مفيض وهو مفاض فالله متقدم على العالم رتبة لا زمناً، إذن هذا العالم سبقه عدم رتبي، أي لم يكن في رتبة العلة وإنما هو في رتبة المعلول، لكنه لم يسبقه عدم زماني، ولما تقول له أن القرآن الكريم يقول أن العالم حادث فتجد فيه ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾[5] فيقول أن هذه الآيات مؤولة، وبالنتيجة أين الخطأ؟ الخطأ ليس في القاعدة وإنما الخطأ في التطبيق، فهذا اعتقد أن نسبة الله للوجود هي نسبة العلّة المُوجَبَةِ فطبق القاعدة، والحال أن نسبة الله للوجود هي نسبة العلّة المُوجِبةِ لا العلةُ المُوجَبَة، أي العلة التي ليس لها اختيار، فلا بُد أن توجد المعلول، فهذه العلة التي ليس لها اختيار هي التي يُقال عنها العلة والمعلول متعاصران زمناً متفاوتان رتبةً، لا أن العلّة الموجِبة، فالعلة المُوجِبة هي التي أعطت معلولها الوجوب ولولاها لم يكن لمعلولها وجوب، فالعلة الموجِبَة هي العلةُ المختارة، فإذا فرضتها مختارة فكيف تقول «العلة والمعلول متعاصران زمناً»؟! بل هو باختياره، ولذلك مثل السيد الخوئي يقول: ”ليست نسبة الله للوجود نسبة العلة للمعلول بل نسبة الفاعل المختار لفعله الاختياري“، كيف أن الإنسان فاعل للقيام وقيامه ليس معاصراً لي زمناً فأقدمه وأخره، فنسبة الله للوجود هي نسبة الفاعل المختار لفعله لا نسبة العلة لمعلولها أو قل نسبة العلة المُوجِبة وليس نسبة العلة المُوجَبة.
إذن بالنتيجة الخطأ ليس في القواعد وإنما الخطأ في التطبيقات، ولذلك احتجنا إلى منهج يعصمنا في مجال التطبيق، وهنا قال السيد الصدر - قدس سره - أن هذا المنهج نحن قمنا بفتحه، فقمنا بفتح في هذا المجال ولم نُسبق به، وهو توفير منهج يعصم في مجال التطبيق في العقليات والحسيات أيضا، فنحن في المحاضرات السابقة كانت عن الخطأ في الحس ووصلنا إلى الخطأ في العقل، وهذا العاصم الذي نحن بحاجة إليه والضامن عن الوقوع في الخطأ الحسي والعقلي، وهذا المنهج هو دليل حساب الاحتمالات بالكيفية التي هو وضعها - قدس سره -.
والحمد لله رب العالمين