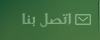بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾
صدق الله العلي العظيم
الآية المباركة تتحدث عن فكرة العبثية، وهي فكرةٌ شائعةٌ ومنتشرةٌ في كثير من المجتمعات والأذهان، وهي عبارة عن السؤال الحائر الذي يطرحه كثير من الناس، حيث يقولون بأن هذا الوجود وهذا الكون ليس له هدف محدّد، فهذا القانون لم يبتن على قانون الهدفية، وإنما هو مبني على العبثية. ويمكن تلخيص فكرة العبثية في أربعة أسئلة:
السؤال الأول: لماذا خلقنا؟
الكثير من الناس يقول: نحن خلقنا وابتلينا بمشاكل الدنيا وهمومها وغمومها، وبما أننا قد خلقنا وتعرضنا لمصائب الحياة ومتاعبها وآفاتها، فإن عدم خلقنا أفضل من خلقنا؛ لأننا خلقنا وأصبحنا تحت أعاصير المشاكل والهموم وتحت وطأة الظروف القاسية، فلماذا خلقنا إذن؟! لأجل هذه الظروف القاسية؟! لأجل هذه المشاكل والغموم والهموم؟! لو لم نخلق لكان ذلك أفضل من خلقنا.
هذا هو السؤال الأول، ولا بد من الإجابة عليه، فنقول: الفلاسفة يقولون: «الفاعل على قسمين: فاعل ناقص يستكمل بهدفه، وفاعل كامل هدفه ذاته»، وحتى تتضح هذه القاعدة الفلسفية نضرب مثالاً لهذين القسمين.
المثال الأول: عندما أراك في العمل أو في السوق، فأقدّم لك خدمة معينة، فما هو هدفي من تقديم هذه الخدمة؟ إنما أقدّم لك خدمة من أجل أن أحصل على صداقة معك، أو من أجل أن أصل إلى مودتك ومحبتك، أو من أجل أن أكتسب سمعة حسنة بين الناس، بحيث يقال بأنني شخصٌ يقدّم الخدماتِ ويقضي حوائج الآخرين، فأنا في هذا الحال فاعل ناقص، أي أنني لا أقوم بالعمل إلا بهدف تغطية حاجة من حاجتي، ولو لم أكن فاعلاً ناقصًا لما قمتُ بهذه الخدمة، فأنا إنما قمت بهذه الخدمة من أجل تكميل ذاتي، حيث شعرتُ بأنني ناقصٌ، ولذلك أردتُ أن أكمل ذاتي بحسن السمعة وبحصول صداقة ومودة بيني وبين الآخرين.
المثال الآخر: لو خرجتُ من أبي ظبي إلى دبي مثلاً، ووجدتُ إنسانًا في وسط الشارع، لا مال عنده، ولا وسيلة توصله إلى بلده، فنزلت وساعدت ذلك الإنسان، وقدّمت له مالاً، وأوصلته بسيارتي إلى بلده، فهنا لا أعتبر فاعلاً ناقصًا، بل أعتبر فاعلاً كاملاً؛ لأنني لم أقدّم هذه الخدمة لأجل حاجة من الحاجات، فإنني لم أطلب صداقته ولا مودته، فإنه إنسان غريب لا أعرف، كما لم أطلب سمعة حسنة؛ لأنني قمت بهذا العمل وحدي من غير أن يراني أحد، فأنا لم أقم بهذه الخدمة لأجل حاجة من الحاجات، ولم أطلب من هذا الشخص أن يقدّم لي خدمةً في المقابل، وإنما قمتُ بهذا العمل بدافع الإنسانية فقط وفقط، حيث فرضت عليَّ إنسانيتي أن أساعد هذا الإنسان الغريب الضائع، فأعتبر في هذه الحالة فاعلاً كاملاً؛ لأن هدفي من هذا الفعل ليس تكميل نفسي، وإنما هدفي من هذا الفعل نشر إنسانيتي ونشر صفاتي الحسنة.
بعد أن اتضحت هذه القاعدة الفلسفية، نطبقها على محل بحثنا، فنقول: الله «تبارك وتعالى» ليس فاعلاً ناقصًا، بل هو فاعل كامل، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾، فالله غني في ذاته، وكامل في ذاته، بل هو محض الكمال وهو عين الكمال، فلا يحتاج لأي غرض ولا لأي حاجة من الحاجات، فإذا كان الله كاملاً فلماذا خلقنا؟ هل لحاجة يرتجيها منا؟! هل لغرض يستكمل به؟!
لا، بما أنه «تبارك وتعالى» فاعلٌ كاملٌ لا يحتاج لشيء فإنما خلقنا لأجل ذاته، أي: لأجل أن يوصلنا إلى الكمال، وبعبارة أخرى: بما أنه كامل فهدفه دائمًا هو الكمال، أي أن هدفه هو نشر كماله وفيضه وجوده وفضله، وهذا من قبيل الكريم والبخيل، فلو كنتُ شخصًا بخيلاً مثلاً، وأحببتُ أن أصبح شخصًا كريمًا، فقمتُ بإكرام الناس؛ لأجل أن أعوّد نفسي على الكرم، فحينئذٍ يعبّر عني بأني فاعل ناقص؛ لأنني أشعر بأنني بخيل، والبخيل يحتاج إلى صفة الكرم، ولذلك أقوم بإكرام الناس كي أتحلى بصفة الكرم وأتعوّد عليها، وأما الإنسان الذي خلقه الله كريمًا فإنه لا يكرم الناس لأجل غرض؛ لأنه كريمٌ بطبعه، وإنما كرمه فرض عليه الكرم، وكرمه هو الذي اقتضى أن يُكْرِمَ الناسَ، فالفاعل الكريم يكرم الناس لا لأجل أن يسد النقص، بل إنه يكرمهم لأجل نشر كرمه وجوده.
من هنا نقول: الله «تبارك وتعالى» بهذه المثابة؛ فإنه كامل غني، وإنما خلقنا لنشر الكمال، أي: لكي نصل إلى الكمال، ولكي نبلغ الكمال، فإذا وصلنا إلى الكمال فقد وصلنا إليه «تبارك وتعالى»، ومن وصل إلى الكمال فقد وصل إلى الله «تبارك وتعالى»، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾.
قد يقول قائل: القرآن يقول بأننا خلقنا للعبادة، حيث قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، فكيف يصح أن يقال بأننا خلقنا للكمال؟!
والجواب عن ذلك: أن الكمال على قسمين: كمال مادي وكمال روحي، ومن مظاهر الكمال المادي: الصحة والأموال والأولاد والنعيم والأمان، فالإنسان الذي ينعم بالصحة والثروة والأولاد عنده كمال مادي، ولكن هذا الكمال المادي كمال زائف، وليس كمالاً حقيقيًا؛ لأن هذا الكمال في معرض الزوال والتبخر، فالصحة تزول، والثروة يفارقها الإنسان إذا انتقل إلى ربه، وهكذا بقية مظاهر الكمال المادي، فإنها كلها كمال مؤقت زائف؛ لأنه كمال يتبخر وينتهي وينمحي، فالكمال الحقيقي ليس هو إلا كمال النفس الذي يتمثل في طهارة الروح، وصفاء الباطن، وكمال الأخلاق، وكمال القرب من الله، وكمال الإنسانية، وكمال التعلق بالله.
هذا هو الكمال الحقيقي؛ لأنه كمال يبقى ويستمر، فهو لا يعيش مع الإنسان خمسين سنة كالأموال، بل إن كمال الروح يعيش مع الإنسان مليارات السنين، فعندما يمر بالدنيا يكون الكمال الروحي معه، وعندما ينطلق إلى عالم القبر يكون الكمال الروحي عنده، وعندما يبعث يوم القيامة يكون معه الكمال الروحي، فالكمال الروحي لا يفارق الإنسان أبدًا، فهو الكمال الحقيقي. وبما أن العبادة هي الطريق إلى الكمال الروحي، لذلك قالت الآية القرآنية: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، أي: إلا للكمال، والعبادة هي درب الكمال وطريقه.
إذن الإنسان لم يُخْلَق للظروف القاسية التي يعيشها، ولا للمشاكل التي يبتلى بها، ولا للهموم التي تخيّم عليه، بل هذه كلها إنما تؤثر على الكمال المادي، وأما الكمال الروحي فلا تؤثر عليه هذه الأمور شيئًا، والإنسان لم يُخْلَق للكمال المادي كي يعترض على الله بقوله: لماذا خلقتني وابتليتني يا رب بظروف قاسية وبمشاكل وهموم؟! الظروف القاسية تعوق الكمال المادي، وليست عائقًا أمام الكمال الروحي، بل بالعكس، فإن الظروف القاسية قد تساعد الإنسان على الكمال الروحي، وقد تساعده على صفاء الروح وطهارته.
ولذلك القرآن الكريم يمدح أولئك الكاملين فيقول: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، أي أن أولياء الله لا يحزنون أبدًا لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن الإنسان الذي يفكّر في الكمال المادي فقط هو الذي يحزن إذا أصابه مرض أو بلاء أو ظروف قاسية، وذلك لأنه يخاف أن يذهب الكمال المادي من يديه، وأما الإنسان الذي لا يعيش إلا الكمال الروحي فلا يهمه ما يحصل في هذه الدنيا، كما قال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.
إذن أنت - أيها الإنسان - لم تُخْلَق للمشاكل ولا للكمال المادي، وإنما خُلِقْتَ للكمال الروحي، فتحرّك نحو هدفك الذي خُلِقْتَ من أجله، واغتنم الفرصة في سبيل الوصول إلى هدفك.
السؤال الثاني: إذا كان الله قد خلقنا للكمال، فلماذا خلق لنا الشرور، كالحشرات الضارة، والأمراض، والزلازل والبراكين، وإبليس والشياطين؟! أليست الشروط عائقًا يعرقلنا دون الوصول إلى كمالنا الروحي؟! لماذا خلق الله لنا الشرور؟!
الجواب عن هذا السؤال: هناك أيضًا قاعدة فلسفية لا بدَّ من فهمها، حيث يقول الفلاسفة: الوجود كله خير وليس فيه شر، وإنما الشر أمر نسبي عدمي وليس شيئًا حقيقيًا، وحتى تتضح هذه القاعدة نضرب بعض الأمثلة.
المثال الأول: قد يعتبر الإنسان الذبابةَ شرًا؛ لأنها مصدر خطر وضرر للإنسان، والحال أن الذبابة في حد ذاتها طاقة من طاقات الوجود، إذ أن جميع ما في هذا الكون طاقة، أي أن كل موجود يحمل ويختزن طاقة تتحرك في هذا الكون، فالذبابة - وهي مخلوق صغير - طاقة من طاقات هذا الوجود، فإن الذبابة تساعد بعض النباتات على التلقيح، وهذه الذبابة نفسها - والتي يعتبرها الإنسان شرًا - تقتل كثيرًا من الحشرات الضارة، فهذه الذبابة في حد نفسها خير؛ لأنها طاقةٌ من طاقات الوجود.
وإنما يحصل الشر من عدم الملاءمة بين الذبابة وبين أنسجة البدن في بعض الظروف لبعض الأسباب، ففي بعض الظروف يقع - لبعض الملابسات - عدم ملاءمة بين الذبابة وبين أنسجة البدن، فإذا حصل ذلك فحينئذٍ يحدث ما نسمّيه شرًا أو مرضًا، والحال أن الذبابة خير، وجسم الإنسان أيضًا خير، ولكن هذين الخيرين قد لا يتلاءمان في بعض الظروف والأسباب، ونتيجة عدم الملاءمة نعبّر عنها بالشر أو بالمرض.
المثال الثاني: عصير البرتقال شهي لذيذ يحبه الإنسان ويستمتع بشربه، فهو خيرٌ، ولكن هذا العصير لا يلائم كل أحد، فهو في حد ذاته خير، لكنه بالنسبة إلى بعض الناس يعدّ شرًا، والمقصود من كونه شرًا أنه لا يتلاءم مع بعض الأبدان ولا يتلاءم مع بعض الأنسجة في بعض الظروف، ونتيجة عدم الملاءمة نعبّر عنها بالشر، وإلا فإن عصير البرتقال خير، والجسم الإنسان أيضًا خير، ولكن عصير البرتقال بالنسبة لبعض الأبدان نعبّر عنه بالشر، فالشر أمر نسبي عدمي؛ لأنه عبارة عن عدم الملاءمة بين هذا الخير وذاك الخير.
وكذلك حال الذبابة، فإنها في حد ذاتها خير، ولكن بالنسبة لبعض أفراد الإنسان في بعض الظروف وبسبب عدم الملاءمة بينها وبين بعض الأجسام يحصل ما نسمّيه بالشر والمرض، فالشر أمر عدمي نسبي، وليس أمرًا حقيقيًا.
المثال الثالث: الصديق هو أثمن ما عند الإنسان، كما يقول الشاعر:
| يعرّفك الإخوانُ كلٌ بنفسه | وخير أخ من عرّفتك الشدائدُ |
فالصديق هو الذي يقف معك في الشدائد، ويخدمك في مصاعب الحياة، ويحفظ أسرارك، ويصونك وينصحك ويساعدك، ولكن هل كثرة الأصداق خير؟ الشاعر يقول:
| عدوك من صديقك مستفادٌ فإن الداء أكثر ما تراه |
فلا تستكثرن من الصحابِ يكون من الطعام أو الشرابِ |
الطعام إذا كثر صار ضررًا عليك، والصديق إذا كثر صار ضررًا عليك أيضًا، فليس في الوجود إلا الخير، وإنما الشر هو أمر نسبي عدمي، وحتى يتضح المطلب أكثر نذكر قصةً قصيرةً، وهي أن المنصور العباسي كان جالسًا مع الإمام الصادق  ، فمرت الذبابة على أنف المنصور، فأبعدها، ثم جاءت مرة ثانية فأبعدها، ثم جاءت مرة ثالثة فأبعدها، ثم قال: يا جعفر، لماذا خلق الله الذبابة؟! قال: ”خلقها الله ليذل بها أنوفَ الجبابرة“، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾.
، فمرت الذبابة على أنف المنصور، فأبعدها، ثم جاءت مرة ثانية فأبعدها، ثم جاءت مرة ثالثة فأبعدها، ثم قال: يا جعفر، لماذا خلق الله الذبابة؟! قال: ”خلقها الله ليذل بها أنوفَ الجبابرة“، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾.
أي أن هذه الذبابة قدّمت خدمةً، حيث بيّنت لهذا الإنسان الذي يعيش كبرياء وغطرسةً أنه لا يستطيع أن يقاوم هذا المخلوق الضعيف، فإن هذه الذبابة إذا سلبت الإنسانَ الراحةَ والصحةَ فإنه لا يستطيع أن يُرْجِع الراحة والصحة، فالذبابة تقهره وتغلبه وتسلبه الراحة والصحة، ولذلك قال الإمام بأن هذا المخلوق الضعيف خُلِقَ ليذل الله به أنوفَ الجبابرة، وهذا ما ورد عن الإمام علي  : ”ما لابن آدم والفخر؟! وإنما أوله نطفةٌ قذرةٌ، وآخره جيفةٌ نذرةٌ، وما بينهما يحمل العذرة“، أي أن الإنسان بين تلك النطفة القذرة وتلك الجيفة المتعفنة جسمٌ يحمل في طياته الأوساخ والقذارات التي تخرج منه يوميًا، فالإمام يركّز على إذابة الغطرسة والكبرياء التي قد يصاب بها الإنسان إذا رأى أنه يمتلك أموالاً وثرواتٍ. ولذلك يقول في رواية أخرى: ”تنتنه العرقةُ، وتقتله الشرقةُ، وتؤلمه البقةُ“، إذا كانت هذه البقة تؤلم الإنسان فما أضعفه وما أحقره!
: ”ما لابن آدم والفخر؟! وإنما أوله نطفةٌ قذرةٌ، وآخره جيفةٌ نذرةٌ، وما بينهما يحمل العذرة“، أي أن الإنسان بين تلك النطفة القذرة وتلك الجيفة المتعفنة جسمٌ يحمل في طياته الأوساخ والقذارات التي تخرج منه يوميًا، فالإمام يركّز على إذابة الغطرسة والكبرياء التي قد يصاب بها الإنسان إذا رأى أنه يمتلك أموالاً وثرواتٍ. ولذلك يقول في رواية أخرى: ”تنتنه العرقةُ، وتقتله الشرقةُ، وتؤلمه البقةُ“، إذا كانت هذه البقة تؤلم الإنسان فما أضعفه وما أحقره!
إذن فالشر أمرٌ عدميٌ نسبيٌ، ولذلك لا يصح أن نتعرض فنقول: لماذا خلق الله الشرور؟! فإن الله لم يخلق إلا الخير، وإنما الشر أمرٌ نسبيٌ عدميٌ.
السؤال الثالث: إذا كان الله قد خلقنا كي نصل إلى الكمال، فلماذا خلق لنا شهوة مستعرة تغلي تعيقنا عن أن نصل إلى الكمال الروحي؟ كيف نصل إلى صفاء النفس وطهارتها ونحن نعيش في داخلنا شهوة وغريزة مستعرة تدفعنا نحو الرذيلة ونحو الانهيار في هاوية الذنب والمعصية؟! القرآن الكريم يؤكد على قوة هذه الشهوة التي تؤثر على الإنسان في الانحراف حيث يقول: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾، فلماذا خلق الله لنا شهوة؟!
الجواب عن ذلك يتضح من خلال شرح قاعدة فلسفية ببعض الأمثلة أيضًا، فإن الفلاسفة يقولون: «الكمال فرع الحركة، والحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل بدفع العوائق والموانع».
المثال الأول: عندما نضع بذرة التفاح في التربة فإن هذه البذرة الصغيرة تحمل في داخلها شجرة مثمرة معطاء قد تثمر مليون تفاحة، ولكن كيف تصل هذه البذرة إلى الكمال؟ كيف تخرج هذا المخزون الموجود فيها وتصل فعلاً إلى كمالها وهدفها، وهو أن تصبح شجرة مثمرة؟ لا تصل إلى ذلك إلا بالحركة، إذ أن كل شيء في هذا الكون يتحرك، كما قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾.
البذرة إذا وجدت الغذاء ووجدت الهواء ووجدت الماء فإنها تبدأ بالتحرك، حيث تمتد منها الجذور إلى عمق الأرض، وتتفرع منها السيقان إلى خارج الأرض، وتبدأ هذه البذرة عملية صراع، حيث تصارع الطبيعة، وتصارع الأعاصير، وتصارع الحشرات الضارة، وتبقى في صراع إلى أن تصل إلى الكمال، حيث تصبح شجرةً مثمرةً، مما يعني أن وصول البذرة إلى كمالها - أي: إلى شجرة مثمرة - يتوقف على الحركة، والحركة هي الخروج من المخزون إلى الفعلية والثمرة، ولا يتم ذلك إلا بصراع العوائق والموانع.
وهكذا هو حال الإنسان، فإنه لا يستطيع أن يصل إلى الكمال إلا عبر الحركة، ولذلك ورد في الشعر المنسوب إلى الإمام علي  :
:
| أتحسب أنك جرمٌ صغير | وفيك انطوى العالم الأكبرُ |
قد يتصور الإنسان أنه شيء عادي، والحال أنه عالمٌ كاملٌ، فإن جسم الإنسان يحمل عشرات الأجهزة والأنظمة الدقيقة، حيث يحمل عقلاً ونفسًا وقوى وإرادةً ومشاعرَ وعواطفَ. هذه النطفة التي يقذفها الإنسان في باطن الرحم قد يتصور البعض أنها شيء صغير، والحال أنها تحمل في طياتها طاقاتٍ من الخير وطاقاتٍ من الفضائل والقيم والمُثُل، وإنما تخرج هذه النطفة هذا المخزون وتصبح إنسانًا فاضلاً قيّمًا يملك طاقاتٍ جبارةً هائلةً بالحركة، ولذلك تمر النطفة بمراحل عديدة: نطفة، علقة، مضغة، عظام، جسم، روح متكاملة، طفولة، شباب، شيخوخة... فالحركة هي خروج المخزون إلى عالم الفعلية، وهذه الحركة تتوقف على الصراع. ومن هنا نفهم فلسفة وجود الشهوة، إذ لولا الصراع الذي يعيشه الإنسان مع نفسه وشهوته وغرائزه لما حصلت حركة، ولولا الحركة ما وصل الإنسان إلى الكمال.
قد يقول قائلٌ: لماذا لم يجعلنا الله منذ أول يوم كاملين؟! لماذا نصارع النفس والشهوات؟! لماذا لا نكون منذ أول يوم أناسًا كاملين بلا حاجة للصراع مع الشهوات والغرائز؟!
والجواب: أن ذلك غير ممكن؛ لأن الإنسان خُلِق للكمال الروحي، ومعنى الكمال الروحي الشعور بلذة الطهارة وبلذة الصفاء النفسي، فالإنسان الذي لا يشعر بلذة الطهارة ولا بلذة صفاء النفس لم يصل إلى الكمال الروحي، فكيف يشعر الإنسان باللذة إذا لم يمر بمرحلة الصراع؟! من لم يمر بمرحلة الصراع لم يشعر بلذة الطهارة والصفاء، ولذلك لو أتينا بطفل يدرس في المرحلة الابتدائية وأعطيناه شهادة دكتوراه من غير أن يكمل دراسته لما وصل ذلك الطفل إلى الكمال العلمي؛ فإن الكمال العلمي هو أن يشعر الإنسان بلذة العلم والمعرفة، ولا يشعر الإنسان بذلك حتى يتحرّك، ولا يتحرّك حتى يصارع ما حوله، ولذلك لا يمكن الإنسان أن يصل إلى الكمال الروحي إلا إذا صارع الشهوة والغريزة وسحقها وتغلب عليها.
ومن هنا ورد عن أمير المؤمنين  أنه قال: ”إن الله خلق الملائكة عقلاً بلا شهوة، وخلق الحيوانات شهوةً بلا عقل، وركّب في الإنسان عقلاً وشهوةً، فمن غلب عقلُه شهوتَه فهو خيرٌ من الملائكة، ومن غلبت شهوتُه عقلَه فهو أدنى من البهائم“.
أنه قال: ”إن الله خلق الملائكة عقلاً بلا شهوة، وخلق الحيوانات شهوةً بلا عقل، وركّب في الإنسان عقلاً وشهوةً، فمن غلب عقلُه شهوتَه فهو خيرٌ من الملائكة، ومن غلبت شهوتُه عقلَه فهو أدنى من البهائم“.
السؤال الرابع: الله خلقنا وقال لنا في كتابه: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، وقال لنا: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، لماذا نحن ندعو فلا يستجاب لنا؟! نتوسل ونتضرع ونبكي وندعو ليلاً ونهارًا ولكن لا يستجاب لنا دعاؤنا؟! إذن أين هي الهدفية وأين هو الكمال إذا كان الله لا يستجيب لنا دعواتِنا؟! أين الهدفية في هذا الكون إذا لم تكن هناك إجابةٌ للدعاء؟!
الجواب: الله أمرنا بدعائه؛ فإن الحبيب يحب أن يناجيه محبوبه، والله يحبنا، والحبيب يحب أن يسمع صوت محبوبه، وأن يرى شخص محبوبه، وأن يتناجى ويتناغى مع محبوبه، فلأن الله يحبنا لذلك يحب أن يسمع صوتنا وتضرعنا ويحب أن يرانا ماثلين بين يديه نتضرع ونتوسل إليه، لكن هناك موانع متعددة تمنع من استجابة الدعاء، ومن هذه الموانع:
المانع الأول: الإصرار على المعصية.
أنا مصر على عقوق الوالدين ومع ذلك أدعو ربي! مصر على غيبة المؤمنين ومع ذلك أدعو ربي! مصر على علاقة غير مشروعة ومع ذلك أدعو ربي! مصر على استماع الأغاني ومع ذلك أدعو ربي! مع أن عليًا  يقول في دعاء كميل: ”اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء“، فهناك ذنوب تحبس الدعاء، وهناك ذنوب تجعل الأبواب موصدة، وهناك ذنوب تقف حواجب شديدة بين الدعوة وبين الإجابة، وأنّى للإنسان أن يصر على استجابة الدعاء وهو مصر على مزاولة الذنوب؟!
يقول في دعاء كميل: ”اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء“، فهناك ذنوب تحبس الدعاء، وهناك ذنوب تجعل الأبواب موصدة، وهناك ذنوب تقف حواجب شديدة بين الدعوة وبين الإجابة، وأنّى للإنسان أن يصر على استجابة الدعاء وهو مصر على مزاولة الذنوب؟!
ولذلك ورد عن الإمام الصادق  : ”إذا أردتَ أن تجاب دعوتك فقف بين يدي الله واعترف بجميع ذنوبك كلها، وأقر لله بها، واستغفر الله منها، وتب إليه، وتندم وتحسّر وتأسّف، ثم ادعُ ربك بالحاجة التي تريد قضاءها، فإن الله يقضي حاجتك“.
: ”إذا أردتَ أن تجاب دعوتك فقف بين يدي الله واعترف بجميع ذنوبك كلها، وأقر لله بها، واستغفر الله منها، وتب إليه، وتندم وتحسّر وتأسّف، ثم ادعُ ربك بالحاجة التي تريد قضاءها، فإن الله يقضي حاجتك“.
المانع الثاني: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أنا أرى زوجتي لا تتحجب حجابًا إسلاميًا، ولكنني لا أقول لها شيئًا؛ لأنني أخاف أن تزعل مني! وأرى من صديقي بعض الأعمال والمعاصي، إلا أنني أخشى من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لئلا تتأثر صداقتنا! أرى إخواني يرتكبون بعض القبائح فأستحي أن أقول لهم شيئًا! وهكذا أترك مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياءً وخوفًا وخشيةً، والقرآن ينادينا: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، وعن الرسول الأعظم  : ”لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو يسلطن عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم“.
: ”لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو يسلطن عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم“.
إذا ترك المجتمع مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سُلِّط عليه الأشرار، ودعاء الأخيار حينئذ لا أثر له، فهي عقوبة جماعية، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾، فترك الأمر بالمعروف يجر إلى عدم استجابة الدعاء.
المانع الثالث: الكفران بالنعم.
نحن - بحمد الله - شعوب تملك ثراء وأموالاً وبحبوبةً من العيش، حيث ننام على الوسادة الناعمة، ونفترش وسائل الراحة، ونرغد في هناء من العيش، فإذا طلع النهار علينا فكرنا في كيفية إشباع بطوننا وملء جيوبنا وكيفية التمتع باللذائذ وإشباع الشهوات، فكل واحد منا بمجرد أن يجلس نهارًا فإن أول ما يخطر على ذهنه: ما هو الغذاء اللذيذ الذي سآكله اليوم؟ وما هي المتعة التي سأتمتع بها هذا اليوم؟ وما هو الراتب الذي سأحصل عليه هذا اليوم؟ وغير ذلك من مظاهر تفكيرنا الشهوي المادي الترفي، فنحن نعيش في هالةٍ من الترف لا حد ولا أمد لها. القرآن الكريم يحذّرنا من هذا الترف ومن هذا الإغراق في استعمال النعم من دون رعاية ولا حدود، حيث يقول: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾، وهذه سنة كونية يحذّرنا منها القرآن الكريم.
عاصم بن زياد - وهو أحد أصحاب الإمام علي  - بنى له بيتًا في زماننا، فدعا الإمام عليًا إلى زيارة بيته، فلما أتى الإمام علي رأى بيتًا وعالمًا من الزخارف، وعلي بعيد عن كل هذا العالم بالكلية، فقال له: يا عاصم، ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ فاعتذر بعذر، ثم قال الإمام: يا عاصم، إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، فقال: كيف يا سيدي؟ قال: ”تقري الضيف، وتصل الرحم، وتخرج الحقوقَ من مخارجها، فإذا أنت فعلتَ ذلك فقد وصلت بها الآخرة“.
- بنى له بيتًا في زماننا، فدعا الإمام عليًا إلى زيارة بيته، فلما أتى الإمام علي رأى بيتًا وعالمًا من الزخارف، وعلي بعيد عن كل هذا العالم بالكلية، فقال له: يا عاصم، ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ فاعتذر بعذر، ثم قال الإمام: يا عاصم، إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، فقال: كيف يا سيدي؟ قال: ”تقري الضيف، وتصل الرحم، وتخرج الحقوقَ من مخارجها، فإذا أنت فعلتَ ذلك فقد وصلت بها الآخرة“.
لنسأل أنفسنا: هل نحن نخرج الحقوق أم أننا نجمع الثروات ونكدّسها من دون إخراج للحقوق الشرعية؟! الإمام الباقر يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النارَ؟ قال: سيدي، لا أدري، قال: من أكل من مال اليتيم درهمًا، قال: من هو اليتيم سيدي؟ قال: نحن اليتيم يا أبا بصير. وورد في رواية أخرى: ”من أكل شيئًا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا“. من لا يخرج الخمس ولا يخرج الحقوق الشرعية فإن الإمام يعبّر عنه بهذا التعبير.
إذن عندما يقول شخص: لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟! نقول: أنى يستجاب ونحن مصرون على الذنوب والمعاصي، ومتخلون عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتلاعبون بالنعم والثروات؟! نعم، قد يدعو الإنسان ولكن الله يؤخر إجابة الدعاء لمصلحة الإنسان؛ لأنه لو استجاب دعاءه في نفس الوقت لكان ذلك ضررًا ومفسدةً له، ولذلك يؤخر الله إجابة الدعاء إلى الظرف الصالح للإنسان.
ولذلك الحسين  دعا يوم عاشوراء 61 هـ ، فقال: ”اللهم احبس عنهم قطر السماء، واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسًا مصبّرةً؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا“، ولم يستجب دعاء الحسين إلا سنة 65 هـ عندما قام المختار بن عبيد الله الثقفي وقتل قتلة الحسين وسقاهم كأسًا مصبرةً، فمع أن الحسين إمام معصوم، إلا أن الله لم يستجب دعاءه إلا في الوقت والظرف المناسب، مما يعني أن إجابة الدعاء قد تؤخر إلى ظرفها المناسب.
دعا يوم عاشوراء 61 هـ ، فقال: ”اللهم احبس عنهم قطر السماء، واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسًا مصبّرةً؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا“، ولم يستجب دعاء الحسين إلا سنة 65 هـ عندما قام المختار بن عبيد الله الثقفي وقتل قتلة الحسين وسقاهم كأسًا مصبرةً، فمع أن الحسين إمام معصوم، إلا أن الله لم يستجب دعاءه إلا في الوقت والظرف المناسب، مما يعني أن إجابة الدعاء قد تؤخر إلى ظرفها المناسب.