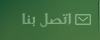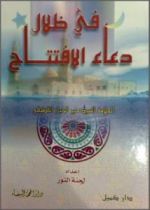بسم الله الرحمن الرحيم
﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
انطلاقًا من الآية المباركة نتحدث حول الحرية الفكرية في الإسلام، وذلك في محاور ثلاثة:
المحور الأول: الفرق بين حرية الفكر وحرية الاعتقاد.
في هذا المحور نطرح سؤالين ونجيب عنهما:
لو قال لنا إنسان: أنا لا أعتنق دينًا ولا أريد أن أبحث في الديانات، بل أريد أن أبقى حرًا من دون أن أعتنق دينًا أو أن أبحث عن الدين، فهل هذا الإنسان بنظر العقل حر؟ هل العقل البشري يرى الإنسان حرًا في أن يبحث عن دين أو لا يبحث؟
ربما يتصور الإنسان أن العقل يقول: الإنسان حر في ذلك، سواء بحث أو لم يبحث، وسواء اعتقد أو لم يعتقد، لكن هذا ليس صحيحًا، إذ أن العقل يفرض على الإنسان أن يبحث عن الدين، حيث توجد قاعدة عقلية تقول: يجب على الإنسان أن يدفع الخطر المحتمل، فلو أن إنسانًا جاء إلى الطبيب، ففحصه الطبيب وقال له: إن المؤشرات تشير إلى احتمال وجود مرض خطير في جسمك، فهنا بمجرد أن يقول له الطبيب ذلك يلزمه العقل بالفحص، ولا يوجد مجال للحرية حتى يقول: هذا جسمي وأنا حر في أن أفحص أم لا! إذ أن العقل يقول له: بما أن احتمال الخطر احتمال عقلائي - لأنه صدر عن طبيب حاذق - يجب عليك عقلاً أن تفحص عن جسمك لتدفع الخطر المحتمل.
نفس الكلام بالنسبة إلى الدين، فإن الإنسان إذا رأى أن الملايين من البشر من يوم آدم إلى الآن - بما فيهم من أنبياء وأئمة ومصلحين - يقولون بأن هناك دينًا، فهذا يعني أن هناك خطرًا؛ لأن معنى الدين أن هناك مرحلتين: مرحلة تسمى الدنيا، ومرحلة تسمى الآخرة، وأن هناك نظامًا من طبقه في المرحلة الأولى نجا من الخطر، ومن لم يطبقه في المرحلة الأولى عرّض نفسه للخطر في المرحلة الثانية، فالدين يعني الخطر، وكما أن الطبيب إذا قال باحتمال وجود مرض خطير في الجسم فإن العقل يفرض الفحص والبحث عن المرض، كذلك إذا قال الملايين من البشر أن هناك مرحلتين - دنيا وآخرة - وأن هناك نظامًا من لم يطبقه في الدنيا تعرض للخطر في الآخرة، أصبح احتمال الخطر احتمالاً عقلائيًا، فيفرض العقل على الإنسان أن يبحث عن الدين لكي يخلص نفسه من هذا الخطر المحتمل.
قد يقال: إن ظاهر الآيات القرآنية أن الناس أحرار في الدين، فإن أرادوا الاعتقاد بالدين فلهم ذلك وإن لم يريدوا فلهم ذلك أيضًا، كقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾، وقوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، وقوله: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ﴾، وقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾، فهذه الآيات كلها ترشد إلى أن الإنسان حر في اختيار الدين وعدم اختياره، فلماذا نقول بأن العقل يلزم الإنسان بالبحث عن الدين دفعًا للخطر المحتمل، والحال أن هذه الآيات تؤكد الحرية؟
الجواب: الحرية على أقسام ثلاثة، فهنالك حرية تكوينية، وهنالك حرية قانونية، وهنالك حرية سلطوية، فأي نوع من الحرية دلت عليه الآيات الشريفة؟
1/ الحرية التكوينية: هذه الحرية الكل يؤمن بها، إذ أن لكل إنسان إرادة، وهذا هو معنى الحرية التكوينية، فالإنسان حر في أداء الصلاة وعدمها، أي أنه صاحب الإرادة، فقد يريد الصلاة وقد لا يريدها، وهذه الحرية التكوينية لا يشك فيها أحد.
2/ الحرية القانونية: الإنسان حر تكوينًا في أن يشرب الخمر أو لا يشرب، لكنه ليس معذورًا أمام الله في شربه، فليست عنده حرية قانونية، وهذا يعني أن الحرية التكوينية شيء والحرية القانونية شيء آخر، والإنسان وإن كان حرًا تكوينًا إلا أنه ليس حرًا قانونًا.
3/ الحرية السلطوية: لا يجب على الدولة أن تفرض الدين بالقوة، وهذا يعني أن الإنسان حر من ناحية السلطة.
إذا جئنا للدين نجد أن الإنسان حر فيه حرية تكوينية، فيستطيع الأخذ به ويستطيع تركه، وهو حر سلطويًا أيضًا من ناحية الدين، إذ ليس لأي سلطة أن تفرض على الإنسان الدين بالقوة، لكن الإنسان ليس حرًا قانونًا، وهذا يعني أن الإنسان وإن كان حرًا تكوينًا في أن يؤمن بالدين، وليس للسلطة أن تفرض عليه الدين، لكنه ليس حرًا بالحرية القانونية، أي أنه ليس معذورًا أمام الله في ترك الإيمان بالدين، وإلا لكان تشريع الدين لغوًا لا وجه له.
من هنا نقول: لا توجد آية في القرآن تدل على الحرية القانونية، فنحن لا نتكلم عن الحرية التكوينية ولا عن الحرية السلطوية، إذ أن كلاهما مسلَّم، وأما الحرية القانونية فلا توجد آية في القرآن تقول بأن الإنسان معذور أمام الله سواء آمن أو لم يؤمن، وبيان ذلك:
الآية الأولى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾.
هذه الآية لا تعني الحرية، بل إنها تعني البراءة، أي أنني برئتُ من دينكم كما برأتُ من ديني، ولذلك عندما نقرأ سورة الكافرون نجد سياقها سياق البراءة، حيث يقول تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ «1» لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ «2» وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ «3» وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ «4» وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ «5» لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾.
الآية الثانية والثالثة: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ﴾ ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾.
هاتان الآيتان معناهما الحرية السلطوية، أي أنك يا رسول صاحب سلطة، لكن لا تفرض الدين بالسلطة والقوة، إذ ليس للسلطة أن تفرض الدين بالقوة والقهر، فهذه الآيات تشير إلى الحرية السلطوية.
الآية الرابعة: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.
أي أن وظيفتك تبليغ الحق، لكن ليس من وظيفتك أن تفرض عليهم الدين، بل دعهم يدخلون الدين عن قناعة واختيار، فمعنى الآية إثبات الحرية السلطوية لا الحرية القانونية.
الآية الخامسة: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾.
معنى هذه الآية أننا لا نحتاج إلى فرض الدين على الإنسان؛ لأن الدين واضح، وبعبارة أرخى: بعد أن تبين الرشد من الغي واتضحت الأدلة والبراهين والمعالم لا نحتاج إلى فرض الدين؛ لأن الفكر الغامض هو الذي يفرض، وأما الفكر الواضح فلا يحتاج إلى فرض، فالآية تريد أن تقول: الدين ومعالمه وأدلته واضحة، فلا نحتاج إلى فرضه على الناس، وهذا نظير قوله عز وجل: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾.
إذن جميع الآيات لا تدل على الحرية القانونية، وإنما تدل إما على الحرية التكوينية، أو على الحرية السلطوية، أو على أنه لا حاجة إلى فرض الدين بعد وضوحه.
نحن نسمع في القوانين الوضعية بالحرية الفكرية، فالقانون الغربي مثلاً يقول: الإنسان حر في تفكيره، ومقتضى حريته في تفكيره أن يكون حرًا في معتقده، فلماذا يفرض الإسلام على الإنسان أن يعتقد بدين الإسلام، فيقول: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؟ القوانين الغربية أقرب إلى الإنسانية من الإسلام؛ لأن القانون الغربي يقول بأن الإنسان حر في تفكيره ومعتقده.
الجواب: الحرية لها ثلاثة أنواع: حرية التفكير، وحرية الاستدلال، وحرية الاعتقاد، وكل حرية لها حد معين.
1/ حرية التفكير: الإنسان حر في تفكيره، بمعنى أن منهج التفكير باختيار الإنسان، إذ أن عقل الإنسان صندوق عنده وهو حر فيه، فلا أحد يقول لآخر: فكّر بالطريقة الكذائية ولا تفكر بالطريقة الفلانية.
مثلاً: قد يفكر الإنسان في شخصية الإمام علي بطريقة فلسفية، وآخر قد يفكر في شخصيته بطريقة اجتماعية، وثالث قد يفكر في شخصيته بطريقة روحية، فهذا اختلاف في مناهج التفكير، وهذه الحرية الفكرية - بمعنى الحرية في منهج التفكير - تقرها جميع الأديان والملل، ولا كلام لنا فيها.
2/ الحرية في الاستدلال: لو أتى شخص واستدل على قاعدة في علم الطب مثلاً بآية من القرآن لقيل له: هذا لا يصح؛ إذ الصحيح الاستدلال بالطب على قواعده، ولو أتى شخص واستدل على قاعدة في علم النفس بقاعدة في علم الطب، لقيل له بأن هذا خطأ، ولو قال: أنا حرٌ في الاستدلال، فيصح لي أن أثبّت علم النفس بعلم الطب، وأثبّت علم الطب بعلم الفلسفة، وأثبّت علم الفلسفة بعلم الهندسة... إلخ.
لقيل له: هذا ليس مجالاً للحرية، إذ لا معنى للحرية في الاستدلال، ولو كان هناك حرية في الاستدلال لما ثبت علم من العلوم، لأن أي إنسان يستطيع بإمكانه أن يقول: أنا لا أؤمن بعلم الطب لأنني حر! وعلم الفلسفة لا أؤمن به أيضًا لأنني حر!
هذا ليس مجالاً للحرية عند جميع الأمم؛ لأن للاستدلال طرقًا يجب سلوكها، فليس للإنسان أن يستدل بأي دليل، وليس للإنسان أن يخلط بين العلوم، وليس له أن ينكر العلوم بحجة الحرية، فالاستدلال لا حرية فيه، ولا معنى لها فيه، بل يجب الاستدلال بالطرق الصحيحة، وهذه الطرق على نحوين: إما المنطق الأرسطي، وإما الدليل الرياضي.
أي فكرة من الأفكار لا يصح تثبيتها بالفوضى والخلط بين المعلومات، بل لا بد من استخدام أحد هذين الطريقين: إما المنطق الأرسطي، فمنذ زمان أرسطو - الفيلسوف اليوناني - قبل الميلاد إلى زماننا توجد طرق صحيحة للاستدلال، وكتاب المنطق للشيخ محمد رضا المظفر يشرح المنطق الأرسطي في مجال الاستدلال، كالقياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، فلا يصح للإنسان أن يقول: أنا أريد أن أستدل بالكيفية التي أراها! بل هناك طرق وضعها علماء المنطق للاستدلال لا بد من سلوكها، وإلا تصبح النتيجة خاطئة.
وفي المقابل يوجد الدليل الرياضي المسمى بدليل حساب الاحتمالات، فإن هذا الدليل الموجود في علم الرياضيات طريق صحيح للاستدلال، والشهيد السيد محمد باقر الصدر «قدس سره» كتب كتابه العظيم الذي يعد إنجازًا في زمانه: الأسس المنطقية للاستقراء، حيث ركّز على دليل حساب الاحتمالات، وساهم في وضع اللبنات لهذا الدليل.
3/ الحرية في الاعتقاد: لو قيل للإنسان مثلاً: عليك أن تعتقد برجعة الأئمة إلى الدنيا، فإنه سيقول: ليس عندي دليل فكيف أعتقد بذلك؟! قبل أن يقوم دليل فهو حر، لكن بعد أن يقوم دليل قطعي لا يصح له أن يقول بأنه حر، وإذا قام عند الإنسان دليل واضح على وجود الله مثلاً لا يصح له أن يقول: حتى لو كان هناك دليل أنا حر!
مثال آخر: لو أتى شخص إلى المختبر، وبعد بعض التحليلات اكتشف الأطباء وجود مرض معين، وقالوا له: هذا التحليل دليل أوجب لنا اليقين بأن لديك مرضًا معينًا، فهل يصح له أن يقول: أنا حر في أن أعتقد بوجود المرض فيَّ أم لا؟! لا يصح ذلك؛ إذ بعد وجود الدليل اليقيني لا معنى للحرية، فإن اليقين بالدليل يساوي الدليل بالنتيجة، ولا يمكن التفكيك بينهما بدعوى الحرية.
ولهذا الإمام علي  عندما يتحدث عن المتقين يقول: ”هجم بهم العلم عن حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون“، فالعلم يهجم، بمعنى أنه يفرض على الإنسان النتيجة، فإذا علم الإنسان بالدليل فإن العلم بالدليل يفرض عليه الإيمان بالنتيجة، وهذا معنى ”هجم بهم العلم“، حيث قامت عليهم أدلة واضحة على وجود الله، فلا يستطيعون بعد ذلك إنكار وجوده.
عندما يتحدث عن المتقين يقول: ”هجم بهم العلم عن حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون“، فالعلم يهجم، بمعنى أنه يفرض على الإنسان النتيجة، فإذا علم الإنسان بالدليل فإن العلم بالدليل يفرض عليه الإيمان بالنتيجة، وهذا معنى ”هجم بهم العلم“، حيث قامت عليهم أدلة واضحة على وجود الله، فلا يستطيعون بعد ذلك إنكار وجوده.
إذن هناك خلط بين المصطلحات، فالحرية في منهج التفكير صحيحة، وكل القوانين تقرها، بينما الحرية في الاستدلال خاطئة، إذ لا بد من الاستدلال بطريق صحيح، والحرية في الاعتقاد خاطئة أيضًا؛ لأن اليقين بالنتيجة بعد قيام الدليل اليقيني أمر تلقائي، وليس باختيار الإنسان أن يفكك بين اليقين بالدليل واليقين بالنتيجة.
المحور الثاني: كيف نجمع بين دعوة القرآن إلى التفكير وبين الحكم بالارتداد؟
قد يقال: هناك تناف بين دعوة القرآن إلى التعقل وبين الحكم بالارتداد، فإننا عندما نرجع إلى آيات القرآن نجدها تأمر بالتعقل، من قبيل قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾، وقوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾، فلو فكّر الإنسان ووصل إلى نتيجة أن الله ليس موجودًا، فبعد أن أمره القرآن بالتفكير والتعقل، وسلك الإنسان طريق التفكير والتعقل، فهل يقبل القرآن منا ذلك، أم يقال بأن هذا شخص مرتد؟!
نقول: نعم، صحيح أن القرآن يدعو إلى التفكير والتعقل، ويقول للإنسان: لا تعتقد بعقيدة إلا عن دليل؛ ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾، ولكن هذا الإنسان الذي دخل عالم التعقل والتفكير لا بد أن تكون نتيجته إحدى حالات ثلاث:
الحالة الأولى: أن يصل - نتيجة التفكير - إلى وجود الله عز وجل ونبوة النبي  ، وهذه الحالة ممتازة ولا مشكلة فيها، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.
، وهذه الحالة ممتازة ولا مشكلة فيها، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.
الحالة الثانية: ألا يصل إلى الله، لكن لوجود مانع، وهذا المانع إما نفسي، كالإنسان المصاب بالوسواس، بحيث لا يستقر، ويكون دائمًا في حالة شك وتردد، وإما مانع عقلي، كمن تكون عنده شبهة مستعصية على ذهنه، فكلما أراد أن يفك العقدة عن ذهنه لا يستطيع أن يستوعب، وإما أن يكون مانعًا اجتماعيًا، كمن يعيش في دولة ظالمة مثلاً بحيث حُجِب عنه الحق ولم يمتلك وسائل يستطيع من خلالها الوصول إلى الحق، وهذا الإنسان الذي فكّر ولم يصل إلى الحق لمانع - إما نفسي أو عقلي أو اجتماعي - وهذا المانع مقبول منه فهو إنسان معذور أمام الله تعالى، ولا مشكلة عندنا معه.
القرآن يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾، والمستضعف هو من منعه الظالم عن الوصول إلى الحق، كمن ليست عنده كتب وبحوث توصله إلى الحق، لأنه يعيش في بيئة ليست فيها وسائل الوصول إلى الحق، فهذا الإنسان معذور، وكذلك من عنده مرض نفسي أو مشكلة عقلية، إذ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ و﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فعدم الوصول إلى الحق لعجز معذرٌ أمام الله.
الحالة الثالثة: أن يقوم لدى الإنسان الدليل على الحق لكنه يعرض عنه مكابرة وعنادًا، وهذا من نحكم عليه بالارتداد، فلا منافاة أبدًا بين دعوة القرآن إلى التعقل وبين الحكم بالارتداد؛ لأن الحكم بالارتداد في حالة واحدة فقط، وهي حالة الإعراض عن الحق مع قيام الدليل عليه، ومع قدرة الوصول إليه.
المحور الثالث: حدود الارتداد بحسب المنظور الفقهي.
من المعروف فقهيًا لدى الإمامية حد الارتداد، فمن أنكر الله أو نبوة النبي بعد أن كان مسلمًا يحكم عليه بأنه مرتد، فما هي حدود الارتداد بحسب المنظور الفقهي؟
لا بد من الوقوف عند هذه النقطة حتى نعرف كيف أن الحكم بالارتداد لا يتنافى مع الحرية الفكرية، وهنا نطرح عدة أسئلة:
الحكم القانوني هو - كما ذكرنا في ليال سابقة - حكم شرعي يشمل كل المجتمعات وجميع الأزمنة، كاشتراط الصلاة بالطهارة، بمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فهذا حكم قانوني لا يتختلف، ولا يصح لشخص أن يأتي في المستقبل ويقول: الصلاة تصح بلا طهارة.
وهناك حكم تدبيري، وهو الحكم الذي يصدر من ولي الأمر - وهو الفقيه الجامع للشرائط - إذا اقتضته المصلحة، فمثلاً: يقول الفقيه: يحرم شراء البضائع الإسرائيلية، ويجب خروج الشعب للانتخابات، ويجب أن يتسلح الشعب للدفاع عن نفسه، فهذه أحكام تدبيرية ولايتية، تصدر من الفقيه الجامع للشرائط إذا اقتضت المصلحة، وهذا الحكم التدبيري يتغير بتغير الظروف؛ لأنه حكم يصدر في ظرف معين لاقتضاء المصلحة له، وليس حكمًا ثابتًا، فهل الحكم بحد الارتداد - وهو القتل - حكم قانوني لا يتغير ولا يختلف أم أنه حكم تدبيري بيد ولي الأمر الفقيه الجامع للشرائط؟
المعروف بين فقهائنا أنه حكم قانوني لا يتغير، لكن بعض فقهائنا ذهبوا إلى أن حد الارتداد حكم تدبيري يتغير بتغير الظروف؛ فإننا إذا لاحظنا الروايات نجد فيها قرائن على أن الحكم تدبيري وليس حكمًا قانونيًا، ولا يخفى أن حد الارتداد لم يرد في القرآن، لكنه ورد عن الأئمة المعصومين «صلوات الله عليهم أجمعين» فيما لا يقل عن أربعين رواية في الكافي والفقيه والتهذيب، ومن هذه الروايات:
1/ موثقة عمار الساباطي، ح3، باب1 من أبواب حد المرتد، في كتاب وسائل الشيعة، ج28، عن أبي عبد الله الصادق  : ”كل مسلم بين مسلمين - أي أن أبويه مسلمان - ارتد عن الإسلام وجحد محمدًا
: ”كل مسلم بين مسلمين - أي أن أبويه مسلمان - ارتد عن الإسلام وجحد محمدًا  نبوته وكذّبه فإن دمه مباحٌ لمن سمع منه ذلك“.
نبوته وكذّبه فإن دمه مباحٌ لمن سمع منه ذلك“.
بعض الفقهاء يقولون: هذه الرواية تقول بأن من سمع منه جاز له قتله مباشرة، ولذلك بعض فقهائنا يقولون: لا يمكن أن يكون هذا الحكم قانونيًا، لأنه لو كان حكمًا قانونًا لا يتخلف ولا يختلف للزم الهرج والمرج واستباحة الدماء وقتل الناس وإهدار الحقوق، فهذه قرينة على أن هذا الحكم صدر عن الصادق  بما هو ولي الأمر وبما هو حاكم شرعي، أي أنه صدر في ظرف لأن المصلحة تقتضي صدوره لا أنه حكم قانوني لا يتغير.
بما هو ولي الأمر وبما هو حاكم شرعي، أي أنه صدر في ظرف لأن المصلحة تقتضي صدوره لا أنه حكم قانوني لا يتغير.
2/ رواية جابر، ح4، باب 3 من نفس هذا الكتاب، عن أبي عبد الله  : ”أُتِيَ أمير المؤمنين
: ”أُتِيَ أمير المؤمنين  برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه، فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين
برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه، فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين  : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقالوا: صدقوا، وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال
: ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقالوا: صدقوا، وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال  : أما إنك لو كذّبت الشهودَ لضربتُ عنقك، وقد قبلتُ منك فلا تعد، فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعًا بعده“، أي أن القرار - كما يقول بعض الفقهاء - بيد الإمام، فهو من يقبل أو لا يقبل، وهو من يقيم الحد أو لا يقيمه.
: أما إنك لو كذّبت الشهودَ لضربتُ عنقك، وقد قبلتُ منك فلا تعد، فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعًا بعده“، أي أن القرار - كما يقول بعض الفقهاء - بيد الإمام، فهو من يقبل أو لا يقبل، وهو من يقيم الحد أو لا يقيمه.
3/ حديث 3، باب 5، صحيحة زرارة عن أحدهما - الباقر أو الصادق - قال: قال رسول الله  : ”لولا أني أكره أن يقال: إن محمدًا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربتُ أعناق قوم كثير“، أي أن الكثير من أصحابي مرتدون، لكنني لم أضرب أعناقهم لأنني لو فعلتُ ذلك لقيل بأن محمدًا بعد أن صفّى أعداءه صار يصفّي أصحابه.
: ”لولا أني أكره أن يقال: إن محمدًا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربتُ أعناق قوم كثير“، أي أن الكثير من أصحابي مرتدون، لكنني لم أضرب أعناقهم لأنني لو فعلتُ ذلك لقيل بأن محمدًا بعد أن صفّى أعداءه صار يصفّي أصحابه.
إذن بعض الفقهاء يستفيد من هذه الروايات أن الحكم بحد المرتد هو حكم تدبيري للحاكم الشرعي قراره، وليس حكمًا ثابتًا، فلا يتنافى مع مبدأ الحرية الفكرية، وهذه القرائن محل نقاش في الفقه، وإنما ذكرناها لأجل استعلام حدود موضوع حد الارتداد.
لا شك في أن توبته عند الله مقبولة، ولكن الكلام في أن توبته هل تقبل عند الحاكم أم لا؟
المعروف بين علمائنا أن توبة المرتد لا تقبل أمام الحاكم، وهنا لا بد من الالتفات إلى الفرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي، إذ أن المرتد الفطري - وهو الذي يكون مسلمًا في الأصل ثم يرتد - يُقْتَل ولا يُسْتتاب، وأما المرتد الفطري - وهو من كان مسيحيًا أو يهوديًا ثم أسلم ثم ارتد - فإنه يستتاب ثلاث مرات، فإذا رجع بعد المرة الثالثة يُقْتَل، فلماذا هذا الفرق بينهما؟
بعض فقهائنا يقولون بأن هناك روايات مطلقة تفيد بأن المرتد - سواء كان فطريًا أو مليًا - يستتاب، ولا يقتل مباشرة، وإنما يقتل بعد التوبة الرابعة، وذلك لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم، ح1 من نفس الباب، قال: ”من جحد نبيًا نبوته وكذّبه فدمه مباح... إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال“، فيقال: هذه الرواية مطلقة، ولكن أغلب العلماء يقولون بأن عندنا روايات فصّلت بين المرتد الفطري والمرتد الملي، كموثقة عمار، حيث جاء فيها: ”كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام.... فإن دمه مباح، وعلى الإمام أن يقتله، ولا يستتيبه“.
هناك شروط موثقة مغلظة، لا أن حد الارتداد يقام مطلقًا، وهذه الشروط هي:
الشرط الأول: ما اشترطه بعض العلماء.
حيث قالوا: يشترط تكذيب النبي، فمجرد إنكار شيء لا يدل على ارتداده ما لم ينسب النبي إلى الكذب، وذلك لأن الروايات قالت: ”من جحد نبيًا وكذبه“ أو ”من جحد محمدًا وكذبه“، وأما من قال مثلاً بأنه لا يؤمن بنجاسة الدم، ولكنه لا يكذّب النبي، بل يعتقد بأن النبي لم يقل ذلك، فإن هذا الشخص وإن أنكر أمرًا ضروريًا من الضروريات لا يحكم عليه - ما لم يكذب النبي - بحد الارتداد.
الشرط الثاني: ألا تكون لديه شبهة.
فلو كانت لدى شخص شبهة مستعصية، وكلما أقيمت له الأدلة لم يستوعب، كمن توجد في عقله شبهة تمنعه عن الإيمان بنبوة النبي أو عن الإيمان بوجوب الصلاة مثلاً، حينئذ لا يقام عليه حد الارتداد، وقد بحث السيد السبزواري «رحمه الله» في كتابه «مهذب الأحكام، ج27، ص28» في هذه النقطة، وهذا الشرط اتفاقي لدى العلماء، ولذلك لما ورد عن النبي  : ”ادرؤوا الحدود بالشبهات“، وعن الإمام الصادق
: ”ادرؤوا الحدود بالشبهات“، وعن الإمام الصادق  : ”إذا أتى العبد كبيرة كان خارجًا عن الإيمان وثابتًا على الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد للإيمان، ولم يخرجه للكفر إلا الجحود“، والجحود هو إبراز الإنكار، فإذا أبرز الإنكار مع قيام دليل أمامه فإنه جاحد ويقام عليه الحد.
: ”إذا أتى العبد كبيرة كان خارجًا عن الإيمان وثابتًا على الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد للإيمان، ولم يخرجه للكفر إلا الجحود“، والجحود هو إبراز الإنكار، فإذا أبرز الإنكار مع قيام دليل أمامه فإنه جاحد ويقام عليه الحد.
الشرط الثالث: أن يكون ارتداده موجبًا للفتنة.
هذا الشرط محل خلاف، فقد يرتد شخص في مجتمع غربي، وهذا الارتداد لا يحدث فتنة، وأما إذا كان شخص في صلب المجتمع الإسلامي مؤمنًا معروفًا، وإذا به يجهر بالارتداد، فينكر وجود الله، أو ينكر نبوة النبي، فحينئذ بما أنه أعلن ارتداده في وسط المجتمع الإسلامي فإن إعلان الارتداد يوجب فتنة فكرية اجتماعية، ولأن إعلان ارتداده يوجب فتنة يستحق إقامة الحد، فالحد إنما يقام على من كان ارتداده موجبًا لحدوث فتنة.
وهذا الشرط الذي يراه بعض العلماء يستظهر بالرجوع للآيات الشريفة، كقوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وقوله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.
هذه الآيات نستفيد منها أن الهدف هو منع الفتنة، فإذا كان الارتداد طريقًا إلى إثارة الفتنة كان موجبًا لإقامة الحد، وإلا فلا، وقد يقال بأن الآيات تتحدث عن القتال لا عن قتل المرتد، والجواب عن ذلك - كما يقول من يرى هذا الشرط - أن المرتكز العرفي لا يفرق بين البابين، فإن المرتكز العرفي إذا قرأ هذه الآيات يفهم منها أن إراقة دم أي إنسان لأجل كفره أو لأجل إنكاره إنما هو لأجل منع الفتنة وليس مطلقًا، ولأجل ذلك مقتضى عرض الروايات على الكتاب - إذ أن هناك مسلكًا عند بعض علمائنا يقول بأن من شروط حجية الرواية موافقة الكتاب موافقة روحية - فإن هذه الروايات لا تبقى على إطلاقها، لأنها إنما توافق الكتاب موافقة روحية إذا اشترطنا هذا الشرط فيها، فنقول بأن المرتد إنما يقتل إذا كان ارتداده سببًا لإثارة الفتنة.
والقرآن يهتم بموضوع الفتنة، فنراه يقول مثلاً: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾، فالفتنة الفكرية الموجبة للفتنة الاجتماعية سبب يقتضي القتل، لا أن مجرد الارتداد هو الذي يقتضي القتل.
ومن خلال بيان تفاصيل الموضوع التي ذكرناها نعرف أن الحرية الفكرية لا تتنافى مع قول العلماء بحد الارتداد؛ إما لأن حد الارتداد حكم تدبيري وليس حكمًا ثابتًا، أو لأن حكم الارتداد وإن كان ثابتًا إلا أنه مشروط بشروط وليس مطلقًا حتى يتنافى مع فتح باب الحرية الفكرية.