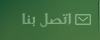بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إنَّ محور البحث هنا هو في أن العقل العملي هل له صلاحية إصدار حكم مولوي في حق الله تبارك وتعالى، فيقرر مثلًا أن خلق الله للخير حسن وخلقه للشر قبيح، وأن إدخال النبي المصطفى  إلى النار قبيح وإدخال إبليس إلى الجنة قبيح، أم ليست للعقل صلاحية في إصدار مثل هذه الأحكام تجاه الله تبارك وتعالى؟
إلى النار قبيح وإدخال إبليس إلى الجنة قبيح، أم ليست للعقل صلاحية في إصدار مثل هذه الأحكام تجاه الله تبارك وتعالى؟
وهنا قد يقال: إنه لا يعقل أن يصدر من العقل حكم في حق الله.
والوجه في ذلك: أن العقل يدرك أن المولوية الاستقلالية المطلقة هي لله تعالى؛ لأن المناط في المولوية هو المنعمية، فمن كان مصدراً للمنعمية المجانية بلا مقابل كانت له صلاحية المولوية، وبما أن المنعمية المطلقة الاستقلالية لله تبارك وتعالى - فلا توجد نعمة إلا وتعود إليه ولا منعم إلا ويرجع إليه - فله إذاً المولوية المطلقة الاستقلالية، بمعنى صلاحية الحكم والأمر والنهي، ويتفرع على ثبوت المولوية له ثبوت حق الطاعة له على عبده بحكم العقل.
وما دام العقل يدرك أن من له المولوية المطلقة هو الباري تعالى، إذاً لا يتأتى من العقل أن يصدر حكماً مولوياً تجاه من هو مولى له، بل هذان الأمران لا يجتمعان، إذ متى ما التفت العقل إلى أن لله تبارك وتعالى موقع المنعمية المطلقة أدرك أن له منصب المولوية المطلقة، وإذا أدرك العقل أن له تبارك وتعالى منصب المولوية المطلقة لم يعقل أن يصدر منه حكم مولوي تجاه الله تبارك وتعالى، إذ هذا خلف إدراكه أنه عبد ومولى عليه وليس ولياً.
وعلى ذلك، فما هي حقيقة حكم العقل بأن فعل الله للخير عدل حسن وفعل الله للشر ظلم قبيح؟ وكيف يصدر العقل هذه الأحكام تجاه الباري تبارك وتعالى مع أنه يدرك أنه ليس له شأن أن يصدر حكماً مولوياً تجاه الله ما دام عبداً له؟
والجواب عن هذا السؤال يرتكز على تحليل القبح والحسن العقليين اللذين يصدران مما يسمى بالعقل العملي، فلأجل ذلك نذكر هنا مقدمتين:
المقدمة الأولى: تحليل المدارس والاتجاهات في الحسن والقبح العقليين، وأهمها أربعة:
الاتجاه الأول:
إن الحسن والقبح قضايا مرتسمة في الواقع، ولا دور للعقل تجاهها إلا الإدراك المحض، وليس شيئاً آخر.
وبيان ذلك: إن العقل ليس من شأنه الحكم، بل إنه مجرد مدرك لما في صفحة الواقع، فليس شأنه أن يصدر حكماً تجاه الله ولا تجاه أي شيء آخر، وليس من شأنه أي باعثية أو زاجرية أو محركية، وإنما شأنه هو الإدراك المحض لما هو الواقع.
ولأجل ذلك، يذكر علماء الأصول أن المحركية دائما فطرية، بمعنى أن الطبيعة البشرية الفطرية هي التي يصدر منها البعث والزجر والمحركية، وإلا فالعقل دوره مجرد الإدراك.
فمثلاً: في مسألة دفع الضرر المحتمل، يقول علماء الأصول: إن العقل يدرك احتمال الضرر لكنه لا يحرك نحوه ولا يزجر عنه، وإنما الزاجرية للطبيعة الفطرية التي لدى الإنسان، فإذا أدرك العقل أن في الطريق الكذائي ضرراً مقطوعاً أو مظنوناً، ففي طول إدراك العقل تأتي القوة الفطرية الطبيعية لدى الإنسان وتزجره عن سلوك هذا الطريق، وهذا يعني أن المحركية والزاجرية تعود للقوة الطبيعية الفطرية في الإنسان وليست من شأن العقل.
فليس شأن العقل إلا الإدراك لما في صفحة الواقع، غاية ما في الباب أن ما يدركه العقل تارة يكون من الأمور العملية، كحسن العدل وقبح الظلم، وأخرى يكون من الأمور النظرية، من قبيل: الواحد نصف الاثنين، والأربعة زوج، فالاختلاف في المدرَك وإلا فالإدراك واحد.
فعندما يقول العقل: «العدل حسن والظلم قبيح»، فهذا ليس حكماً مولويا يصدر من العقل كي يقال: ليس للعقل صلاحية إصدار حكم مولوي تجاه الله تبارك وتعالى أو تجاه أي شيء آخر، وإنما «العدل حسن» و«الظلم قبيح» قضيتان مرتسمتان في الواقع؛ لأن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، فالعقل يدرك مثلاً أن اجتماع النقيضين مستحيل، مع أن اجتماع النقيضين ليس له وجود في الخارج، لكن هذه القضية «اجتماع النقيضين مستحيل» قضية مرتسمة في صفحة الواقع، وكذلك عندما يدرك العقل أن شريك الباري ممتنع، فإن هذه القضية لا وجود لها خارجاً، لكنها قضية مرتسمة في صفحة الواقع.
إذاً لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، فلذلك هناك قضايا مرتسمة في لوح الواقع ليس دور العقل تجاهها إلا دور الإدراك، فكما أن «اجتماع النقيضين محال» قضية مرتسمة في الواقع يدركها العقل، كذلك قولنا: «العدل حسن» و«الظلم قبيح» قضيتان مرتسمتان في صفحة الواقع، والعقل مجرد مدرك لهما لا أكثر من ذلك، وبالتالي فعندما يقرر العقل أن الظلم لا ينبغي صدوره والعدل ينبغي صدوره، فهذا ليس حكماً مولوياً صادراً من العقل، بل هذه قضية مرتسمة في صفحة الواقع شأن العقل تجاهها أن يدركها ليس إلا.
الاتجاه الثاني:
إن الحسن والقبح مرجعهما إلى ميول نفسية كامنة في نفس الإنسان، فمعنى أن العدل حسن هو أن النفس تنجذب للعدل وتلتذ به، ومعنى أن الظلم قبيح هو أن النفس تنفر من الظلم وتشمئز منه، وبناء على هذا الاتجاه أيضا فإن حكم العقل بالحسن والقبح ليس حكماً مولوياً، وإنما هو مجرد ميول منطبعة كامنة في وجدان الإنسان.
الاتجاه الثالث:
إن الحسن والقبح العقليين مرجعهما إلى قضايا فطرية جُبل عليها الإنسان، بمعنى أن «العدل ينبغي صدوره» و«الظلم لا ينبغي صدوره» قضيتان إنشائيتان، لكن هاتين القضيتين الإنشائيتين جبل عليهما الإنسان بفطرته، فكما جُبِل على حب أبويه، وعلى شكر المنعم، وعلى دفع الضرر المحتمل، جُبِل أيضًا بفطرته على هذه القضايا التي نسميها حسن العدل وقبح الظلم، فهي وإن كانت قضايا إنشائية، لكن ليس العقل يقوم بإصدار حكم مولوي تجاه من يفعل هذه القضايا، وإنما هاتان قضيتان إنشائيتان جبل عليهما الإنسان وأودعتا في صميم فطرته، ولعل هذا ما تشير إليه الآية المباركة: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾.
الاتجاه الرابع:
إن مرجع حسن العدل وقبح الظلم إلى قوانين عقلائية، وهذا مسلك كثير من الحكماء وتبعهم المحقق الإصفهاني قدس سره، فذهب هؤلاء إلى أن المجتمع العقلائي قد تبانى على هذه القوانين، فاتفق على أن الصدق ينبغي صدوره والكذب لا ينبغي صدوره، وإنما تبانى المجتمع العقلائي على هذه القضايا لأجل إحراز المصالح ودفع المفاسد، حيث أدرك أن في الظلم مفسدة لزومية فاتفق بينه وبين أفراده على أن الظلم قبيح لا ينبغي صدوره، وأدرك أن في العدل مصلحة لازمة ضرورية فتبانى بينه وبين أفراده على أن العدل حسن ينبغي صدوره.
وهنا يأتي السؤال: هل قانون حسن العدل وقبح الظلم من سنخ الأحكام المولوية كي يقال: كيف يصدر من العقلاء بما هم عقلاء أحكام مولوية تجاه الخالق تبارك وتعالى، مع إدراكهم أن المولوية الحقيقية للخالق وليست لهم؟
فهذه المسألة إنما تأتي بناء على الاتجاه الرابع، وإلا فعلى ضوء الاتجاهات الثلاثة الأخرى لا توجد مولوية تصدر من العقل تجاه الله تبارك وتعالى حتى تكون مورداً للبحث والسؤال.
المقدمة الثانية:
هل ما يصدر من العقلاء في قولهم: «العدل حسن والظلم قبيح» - بمعنى أن العدل ينبغي صدوره والظلم لا ينبغي صدوره - هي فعلاً أحكام مولوية تصدر من العقلاء بما هم موالي كي يقال: لا ينبغي توجيه هذه الأحكام إلى الباري تبارك وتعالى؟
والجواب عن ذلك: هناك ثلاثة أمور لا بد من توضيحها حتى يتبيّن أنه ليس هناك أحكام مولوية تصدر من العقلاء في مسألة الحسن والقبح العقليين.
الأمر الأول:
ما هو الفرق بين القضية الأولية التي يدركها الذهن إدراكاً أولياً وغيرها من القضايا؟
إن القضية الأولية هي ما ترجع إلى ضرورة المدرَك أو ضرورة الإدراك، فمثلاً: «الأربعة زوج» قضية أولية؛ لأن المدرك ضروري، بمعنى أنه متى ما تصور الذهن الموضوع أدرك أن المحمول مستبطن في الموضوع لا ينفك عنه، فلا يعقل أن تكون أربعة ولا تكون زوجاً، بل ثبوت المحمول للموضوع ثبوت ضروري، ولذلك هذه القضية أولية.
وقد ترجع القضية الأولية إلى ضرورة الإدراك لا المدرَك، بمعنى أن هذه القضية تصدر من حاق العقل لا من مصدر آخر، فهي لا تصدر من تلقين العاطفة، ولا من تزيين النفس، ولا من تلقين البيئة التي يعيش فيها الإنسان، بل هي قضية تصدر من لبّ العقل وحاقّه، فهي ضرورية الإدراك، وتدخل ضمن القضايا الأولية، فالعقل بما هو عقل يدرك مثلًا «أنا موجود، أنا لي عاطفة، أنا لي نفس، أنا لي مشاعر، أنا لي أفكار»، فهذه القضايا يدركها نفس العقل، لا أنها نشأت من تلقين نفس الإنسان أو من تلقين البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان، فهي قضايا أولية لأنها ضرورية الإدراك، بمعنى أنها نابعة من حاق القوة العاقلة لا من مصدر آخر.
ومن هنا نأتي لنطبّق، فنقول: هل «العدل حسن والظلم قبيح» من القضايا الضرورية، أم لا؟
والجواب عن ذلك: إننا نرى بوجداننا أن الذهن متى ما أدرك العدل أدرك أنه حسن، أي أن الذهن لا يتصور انفكاك العدل عن الحسن، فهي ضرورية المدرَك، وإن لم تكن ضرورية المدرك فهي ضرورية الإدراك، إذ هي ليست من تلقين من النفس ولا من تلقين من البيئة والمحيط، بل من حاق القوة العاقلة، فعندما يجرد الإنسان نفسه من تمام الدوافع والرواسب يدرك أن العدل حسن والظلم قبيح.
الأمر الثاني:
هناك فرق بين موقف العقل من العدل والظلم وموقف العقلاء من العادل والظالم، إذ هما أمران طوليان لا ينبغي الخلط بينهما، فالعقل يدرك أولاً أن العدل حسن ينبغي صدوره والظلم قبيح لا ينبغي صدوره، سواء كان هناك مجتمع عقلائي أم لم يكن، وفي طول هذه القضية ومتفرعاً عليها يقول المجتمع العقلائي تجاه الظالم: هذا الذي فعل الظلم - مع إدراكه أن الظلم قبيح - مستحق للذم، وذاك الذي فعل العدل - مع إدراكه أن العدل حسن - مستحق للمدح.
فنحن نسلّم بأن عند العقلاء بناء واتفاقاً، لكن هذا البناء والاتفاق على القضية الثانية، وأما القضية الأولى فهي من مدركات العقل لا من بناء العقلاء واتفاقهم، فالعقلاء تبانوا على مدح العادل بمعنى استحقاقه للمثوبة، وتبانوا على ذم الظالم بمعنى استحقاقه للعقوبة، وهذا موقف عقلائي مولوي، إلا أن هذا الموقف العقلائي متفرع على الموقف الأول، وهو موقف العقل تجاه العدل والظلم، فمتى ما تصور العقل العدل حكم بحسنه، ومتى ما تصور الظلم حكم بقبحه، وفي طول ذلك يكون للعقلاء موقف مدح أو ذم.
وبعبارة أوضح: القضية الأولى هي: ماذا ينبغي من العقل تجاه العدل والظلم؟ والقضية الثانية هي: ماذا ينبغي من العقلاء تجاه الظالم والعادل؟ فكلتا القضيتين تطبيقان لعنوان ما ينبغي وما لا ينبغي، لكن التطبيق الأول سابق على التطبيق الثاني، إذ التطبيق الأول قضية خبرية مرتسمة في نفس الأمر والواقع، والقضية الثانية هي قضية إنشائية صادرة من العقلاء تجاه الظالم والعادل.
الأمر الثالث:
لو سلّمنا بأنّ لدى العقلاء موقفا مفاده أن العدل ينبغي صدوره وأن الظلم لا ينبغي صدوره، فتصوير موقف العقلاء بأنه قضية إنشائية مولوية - بمعنى أن العقلاء يصدرون حكما مولويا مفاده أن العدل ينبغي صدوره والظلم لا ينبغي صدوره - غير صحيح ولا يتطابق مع كلمات أهل الحكمة الذين هم أصاحب هذا الاتجاه، فإن كلماتهم وكذلك كلمات المحقق الاصفهاني ترشد إلى أنهم يقولون: إن قضايا الحسن والقبح من التصديقات الجازمة، غاية ما في الفرق بينها وبين القضايا الأولية: أن القضايا الأولوية - كما يقولون - مضمونة الحقانية، بينما هذه القضايا ليست مضمونة الحقانية، بمعنى أن العقل عندما يدرك القضية الأولية لا يحتاج إلى برهان عليها، فهي مضمونة الحقانية، بينما هذه القضايا «العدل حسن والظلم قبيح» وإن كانت تصديقات جازمة - بمعنى أن العقلاء يصدقون بها تصديقاً جازماً لا شك عندهم فيه ولا تردد - لكنها ليست مضمونة الحقانية، بل تحتاج إلى دليل وبرهان ومستمسك.
فأهل الحكمة يعبرون عن هذه القضايا - وهي حسن العدل وقبح الظلم - بأنها قضايا تصديقية جازمة، وهذا معنى أنهم يرونها قضايا خبرية وليست إنشائية؛ لأن القضايا الإنشائية ليست من التصديقات الجازمة، فتعبيرهم عن حسن العدل وقبح الظلم بأنها من التصديقات الجازمة يرشد إلى أنها من القضايا الخبرية وليس الإنشائية.
فتلخص من ذلك: أنه لا يوجد لدى العقل حكم مولوي تجاه الباري تبارك وتعالى كي يقال: كيف يصدر من العقل حكم مولوي وهو ملتفت إلى أن المولوية لله تبارك وتعالى؟ بل مسألة الحسن والقبح ترجع إما إلى قضايا واقعية، وإما إلى ميول نفسية، وإما إلى قوانين فطرية، وإما إلى قضايا عقلائية بنحو القضية الخبرية لا بنحو القضية الإنشائية.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.