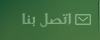سيدنا المنيّر، لدي عدة تساؤلات نرجو من جنابكم إفادتنا من بركات فيوضكم.
السؤال الأول: ما المقصود بخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام المُشار إليه في الآية: {الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}؟
السؤال الثاني: عندما نقوم بالمقارنة بين قوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}، وبين قوله تعالى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ «9» وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ «10» ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ «11» فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا}، نرى أن خلق الأرض وإحياءها استغرق ستة أيام، ولا يُتصور أن تكون مدة خلق الأرض وإحيائها مساوية لمدة خلق السماوات والأرض، مع أن نسبة الأرض للكون لا تساوي ذرة لمساحة الأرض كلها، وهذا قد يكشف عن أن القرآن صياغة بشرية لا إلهية.
السؤال الثالث: ما المقصود باليوم في آية {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}؟ وإذا كان المقصود شيئًا غير كلمة اليوم التي نعرفها، فلماذا استخدم هذا التعبير مع العلم بأنه يوجد في الإنجيل مثل هذا التعبير؟
السؤال الرابع: لماذا بعض آيات القرآن ليست دقيقة، فيُفتح بذلك المجال لأي أحد بأن يشرحها على ما يراه صحيحًا؟
أثابكم الله

بسم الله الرحمن الرحيم
النقطة الأولى: أن هناك فرقًا بين عنوان البارئ وعنوان الخالق، فالبرء هو عبارة عن إعداد المادة، والخلق هو إيجاد تفاصيل الصورة، فمثلًا: من يريد أن يصنع كرسيًا، فيقوم بإعداد المادة الخشبية، فإنه حينئذ قد قام بعملية البرء، والخلق هو إيجاد الصورة بتفاصيلها وخصائصها، فإذا صنع الكرسي وتشكلت هيئته، فقد خلق الكرسي. وبذلك نفهم أن إيجاد الله تعالى للكون بمعنى إعداده لمادة الكون قبل صنع المجرات والكواكب هو البرء، وقد كان لحظيًا خارجًا عن إطار الزمن، ولكن إيجاده تعالى لتفاصيل السماوات والأرض هو الخلق، وقد استغرق ستة أيام.
النقطة الثانية: الزمن هو بعد رابع للكتلة، فلا وجود له قبل وجودها، لذلك تمت عملية البرء من دون زمن، إذ لم يكن هناك كتلة، ولكن عملية الخلق لأنها تتعلق بتفاصيل السماء والأرض، كانت بعد إيجاد الطاقة المتحولة إلى كتلة، فكانت هذه العملية عبر إطار زمني معين عبر عنه القرآن الكريم بستة أيام.
النقطة الثالثة: أن الله تعالى قادر على أن يوجد الكون في لحظة، ولكن لأن عالم المادة متقوم بالتغير، إذ لو كان ثابتًا وليس متغيرًا لم يكن ماديًا، والتغير يقتضي الحركة من مرحلة لأخرى، ومن صورة لأخرى، فلذلك كان لا بد من زمن تتم فيه عملية التغير، إذ لا يمكن تحقق الحركة بلا زمن، ومن هنا كان اكتمال الجنين يقتضي حركة الحيوان المنوي، وكانت الحركة مفتقرة إلى الزمن، وهو ستة أشهر مثلًا، فكذلك وجود السماوات والأرض وجود مادي متغير، ولذا فهو مؤطر بالزمن.
الوجه الأول: أن المراد بخلق السماوات والأرض هو تحقيق التفاصيل، بقرينة قوله: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، ومن التفاصيل: ولادة الحياة في الكون، والتي منها نشوء الحياة على الأرض، وذلك يعني أن مفاد الآية الثانية شرح لمفاد الآية الأولى، فإن الآية الأولى تعرضت للحديث عن هذا الأمر بالإجمال، بينما الآية الثانية تضمنت تفصيل هذه الخلقة، وأنها مرت بمراحل، منها: الخلق، وجعل الرواسي، وتقدير الأقوات، وحشد الطاقات والمعادن، فإذا كان مفاد الآية الثانية بمثابة الشرح للآية الأولى فلا بُعْد في اتحاد المعنيين.
الوجه الثاني: أن المقصود بخلق الأرض ونشوء الحياة فيها ليس مقصورًا على ولادة الحياة على الأرض بالفعل، وإنما المنظور فيها هو المراحل التمهيدية لولادة الحياة، والتي تشمل مسيرة الوجود منذ تكوّن المجرات، إلى حين تكوّن الحياة بالفعل على الأرض، فإن كل هذه المراحل هي مبادئ تمهيدية لنشوء الحياة على الأرض، وإنما جعلنا المبدأ هو زمن تكوّن المجرات - الذي نشأ عن مرور الانفجار بالتكثف والتبرّد - لأمرين:
الأمر الأول: أن تحديد المعنى المقصود من أي آية منوط بالخصائص اللفظية والسياقية للآية، وحيث أن الآية أشارت للجهات كما في كلمة ﴿فَوْقِهَا﴾ وكلمة ﴿فِيهَا﴾، والجهات إنما تتصور مع وجود المادة التي بلحاظ كتلتها تتحقق هذه الأبعاد والزوايا، كالفوق والتحت، والقبل والبعد، فلا امتداد فيها لما قبل تكوّن المجرات.
الأمر الثاني: إن ولادة الحياة تحتاج إلى مادة تنبعث فيها الحياة، وهذا يعني أن مبادئ الحياة المكونة لها بدأت شرارتها وانعقدت جذورها منذ تكوّن المجرات.
المعنى الأول: النهار، كما في قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾.
المعنى الثاني: مجموع الليل والنهار، كما في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾.
المعنى الثالث: ما يقارب ألف سنة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾.
المعنى الرابع: خمسون ألف سنة، كما في قوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾.
المعنى الخامس: الحالة، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾، أي حال ظعنكم، وحال إقامتكم.
المعنى السادس: مطلق الفترة الزمنية، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾، أي في هذه الفترة، أو قوله جل وعلا: «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ»، أي تلك الأزمنة نداولها بين الناس.
وبعد استعراض هذه المعاني، نقول: إن المحتمل في آية: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ معانٍ ثلاثة:
المعنى الأول: الترميز للحاجة للزمن في حركة المادة، وليس التعبير عن مقدار محدد، وأسلوب الترميز استعمله القرآن الكريم في مواضع أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، فإن العدد هنا لا يعبر عن حد معين، وإنما هو رمز للكثرة فقط.
المعنى الثاني: أن المقصود من الأيام هو المراحل، أي أن هنالك مرحلة للإيجاد، ومرحلة للخلق، وهنالك مرحلة لمبادئ الحياة، باعتبار أن اليوم استعمل في القرآن الكريم بمعنى الحالة، فلعل المقصود بالأيام هنا الحالات والمراحل.
المعنى الثالث: أن المراد به فترة زمنية، وتقدير هذه الفترة الزمنية يختلف باختلاف موقع التقدير، فمن يقوم بتقدير الزمن وهو ضمن مجموعتنا الشمسية، سوف يختلف تحديده عمن يقوم بتحديده وهو خارج هذه المجموعة، فبنتيجة اختلاف التحديد الزمني، نرى الاختلاف في تقدير اليوم في القرآن الكريم بين عدة معانٍ، ومن ذلك نستكشف أن المراد بالزمن في هذه الآية المباركة ليس المعنى المتبادر لأذهاننا من اليوم الأرضي، بل ما يعادل مجموعة من السنين الضوئية التي تقارب مليارات السنين.
ويمكن تقريب ذلك بأن نقول: بما أن عمر الكون 13.7 مليار سنة، وعمر الحياة 4 مليار سنة، فمن المحتمل أن يكون مقدار الستة أيام التي أشار لها القرآن الكريم هو الزمن منذ تكوّن المجرات إلى بداية الحياة على الأرض، والذي قد يصل إلى ستة مليار سنة.
وإنّ وجود هذا التحديد في الإنجيل يدلّ على أن مصدر الإنجيل والقرآن واحد، وهو الخالق البارئ تعالى، وهناك مصطلحات مشتركة بين جميع الكتب السماوية، كمصطلح الملكوت، ومصطلح الوحي، والخلافة، وإن اختلفت الألفاظ.
العامل الأول: أن اللغة كائن اجتماعي متحوّل، ولذلك قد تتغيّر معاني كثير من الكلمات بمرور الزمن، وبسبب التراكم الثقافي، وقد تتغير طريقة النطق للكلمات أيضًا نتيجة لتداخل اللغات، ولهذا كثير من العرب في العصر الحاضر لا يفهم بعض شعر امرِئ القيس، وشعر المتنبي، لغموض المعاني بمرور الزمن، ومن هذا القبيل في القرآن الكريم كثير من الآيات، نحو: ﴿وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾، ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾، ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴾.
العامل الثاني: ضعف المستوى الثقافي حين نزول القرآن، والمقصود بذلك أن القرآن الكريم قد أشار لعدة حقائق علمية من أجل إثارة عنصر التأمل والتفكير لدى الإنسان في عالم الوجود، وأن يتحول ذلك إلى سبب من أسباب التدبر في القرآن، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، ولكن لأن الذهنية البشرية في تلك الحقبة لم تكن تستطيع استيعاب الحقيقة العلمية مثل حركة الأرض والمجموعة الشمسية، وظاهرة الإزاحة الحمراء، فلم يعبر القرآن عنها تعبيرًا صريحًا لعدم تقبل الذهن البشري آنذاك لها، وإنما استخدم لغة الكناية والإشارة، فقال مثلًا: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ وقال: ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾، مما أوجب اختلاف تحليل المفسرين القدامى لها وتحليل المفسرين المعاصرين.
العامل الثالث: قصور الذهن البشري عن التصور، فمثلًا: عندما يتحدث القرآن عن المفاهيم المجردة من المادة، كالعلم الإلهي، أو حقيقة علاقة الله بالإنسان، فإن القرآن في هذا الفرض يستخدم تعبيرات حسية من أجل تقريب المعنى فقط، لا من أجل شرحه، فيقول مثلا: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، ويقول: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ «22» إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، فإن هذه الألفاظ لا تعكس المفهوم الذي يُراد الحديث عنه، لأن الذهن البشري قاصر عن الإحاطة به واستيعابه، لعدم كون المفهوم ماديًا، وإنما يأتي بالألفاظ ذات المعاني الحسية لتقريب الفكرة.
العمل الرابع: أن الله جعل في القرآن قسمًا من الآيات عبّر عنه بالمتشابه، أي الغامض والمجمل في حدود معناه، وذلك من أجل أن يحتاج المسلم للرجوع إلى النبي  وأهل بيته
وأهل بيته  العارفين بدقائق القرآن وبواطنه وأسراره، دعمًا لموقعية القيادة الفكرية لهم، وربطًا للأمة بالمصدر الأمين المضمون، إذ لو كان القرآن كله واضحًا جدًا لكانت النتيجة استغناء الأمة عن الإمام، والقبول بأي قيادة ميدانية، ما دام لا يوجد دور فكري للإمام والقائد يحتاجه الناس، فمن أجل ضمان ارتباط المجتمع المسلم بالقيادة الأمينة المضمونة المخلصة، جعل الله قسمًا من الدستور - وهو القرآن - غامض المعاني، يُحتاج في تفسيره وتحليله للإمام بعد النبي
العارفين بدقائق القرآن وبواطنه وأسراره، دعمًا لموقعية القيادة الفكرية لهم، وربطًا للأمة بالمصدر الأمين المضمون، إذ لو كان القرآن كله واضحًا جدًا لكانت النتيجة استغناء الأمة عن الإمام، والقبول بأي قيادة ميدانية، ما دام لا يوجد دور فكري للإمام والقائد يحتاجه الناس، فمن أجل ضمان ارتباط المجتمع المسلم بالقيادة الأمينة المضمونة المخلصة، جعل الله قسمًا من الدستور - وهو القرآن - غامض المعاني، يُحتاج في تفسيره وتحليله للإمام بعد النبي  ، كما قال تعالى في حق النبي
، كما قال تعالى في حق النبي  : ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، وقال تعالى في حق النبي والإمام: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، وبذلك تمتاز القيادة الخبيرة من القيادة الفارغة.
: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، وقال تعالى في حق النبي والإمام: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، وبذلك تمتاز القيادة الخبيرة من القيادة الفارغة.