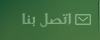بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
مازال الحديث حول حجية العقل في وصوله إلى الحكم الشرعي.
وقد ذكرنا فيما سبق أن بعض علماء الأصول أورد على بعض المحدثين القائلين بعدم حجية العقل ثلاث مناقشات ووصلنا إلى المناقشة الرابعة.
المناقشة الرابعة: أنه لو لم يكن العقل حجة في وصوله للحكم الشرعي لما أمكن أن نحكم بوجوب إطاعة المولى وبقبح معصيته؛ فإن الحاكم بوجوب إطاعة المولى وقبح معصيته هو العقل، فإذا سددنا هذا الباب وقلنا بعدم حجية العقل إذاً لا دليل على وجوب إطاعة المولى ولا دليل على قبح معصيته.
ويمكن تحليل هذا المطلب بأن يقال: هناك بحث كلامي في مصدر لزوم إطاعة المولى؛ حيث إن هناك عدة نظريات في تحليل مصدر لزوم إطاعة المولى:
1. هل أن مصدر لزوم إطاعة المولى هو حق الطاعة.
2. أم أن مصدر اللزوم شكر المنعم.
3. أم أن مصدر اللزوم حكم العقل بدفع الضرر المحتمل؟
النظرية الأولى: نظرية حق الطاعة.
وهي تختص بالمولى الحقيقي هو الله تبارك وتعالى؛ حيث تقرر هذه النظرية أن للمولى الحقيقي بلحاظ أن مولويته ذاتية وليست مكتسبة ولا اعتبارية، وإنما مولويته ناشئة من خالقيته ومالكيته، ومقتضى أنه خالق بالاستقلال ومالك بالاستقلال أن له حق الطاعة على مماليكه وعبيده، وحق الطاعة حكم يحكم به العقل بعد إدراكه المولوية الذاتية للمشرع وهو الله عز وجل.
الملاحظة على النظرية الأولى: لا ملازمة بين الخالقية وحق الطاعة، وكونه تبارك وتعالى خالقاً للعباد بالاستقلال أو مالكاً لما خلق لا ملازمة بين ذلك عقلاً وبين أن يكون له حق الطاعة على عبيده؛ إذ لا نرى وجهاً للملازمة بين الأمرين، أي بين مولويته الذاتية الناشئة عن خالقيته ومالكيته وبين أن يثبت له حق الطاعة على العباد؛ لأن الملازمة ترجع إلى علة مشتركة تقتضي الملازمة بين الأمرين، لا يمكن أن تحصل الملازمة بين أمرين ليس بينهما علة مشتركة بحيث تكون علة لألف وعلة لباء فيحصل بين ألف وباء ملازمة لأن بينهما علة مشتركة، وإذا لم يكن بين الطرفين علة مشتركة لا ملازمة بينهما عقلاً، فما هي العلة المشتركة بين المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى وبين حق الطاعة حتى نقول بالملازمة العقلية بينهما؟
النظرية الثانية: نظرية شكر المنعم.
هذه النظرية تقرر أن مصدر لزوم إطاعة المولى ليست هي المولوية الذاتية، وإنما مصدر لزوم إطاعة المولى هو مسألة شكر المنعم، أن العقل إذا أدرك أنه منعم أدرك أن مقتضى المقابلة مع المنعم هو شكره، شكره حسن والكفر بنعمته قبيح؛ من أجل ذلك قلنا بلزوم إطاعة المولى عز وجل، بلحاظ أنه منعم حقيقي.
الملاحظة على النظرية الثانية: هذه النظرية الثانية أيضاً نوقشت؛ باعتبار أن ما يحكم به العقل قبح الكفران بالنعمة لا وجوب شكر المنعم، شكر المنعم حسن لكنه ليس لازماً وواجباً، الكفران بنعمته قبيح، وهذا لا شك فيه، فإن العقل يحكم بقبح الكفران بنعم المنعم، ولكنه لا يحكم بوجوب شكر المنعم، وإن كان شكر المنعم أمراً حسناً وكمالاً ومستحباً، ولكنه ليس بلازم.
ولأجل ذلك ما ورد عن النبي  من أنه كان يربط الحزام على بطنه في شهر رمضان ليتفرغ للعبادة المستحبة، فيقال له أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً؟!
من أنه كان يربط الحزام على بطنه في شهر رمضان ليتفرغ للعبادة المستحبة، فيقال له أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً؟!
كأنما الشكر هو مرتبة كمالية، أن أكون في مقام الشكر لله هذا أمر كمالي أطلبه، لا أن شكر المنعم لازم عقلاً.
النظرية الثالثة: نظرية دفع الضرر المحتمل.
بما أن في مخالفة أحكامه - تبارك وتعالى - وفي عدم احترام قوانينه - تبارك وتعالى - احتمالاً للعقوبة، يحتمل العبد أنه إذا خالف قوانينه ولم يلتزم بأوامره ونواهيه أن وراء ذلك عقاباً، وبما أن العقوبة المحتملة عقوبة خطيرة؛ لأنها عقوبة أبدية شديدة مثلاً؛ لأجل ذلك يحكم العقل بلزوم إطاعة المولى، لا لأن له حق الطاعة ولا لأن شكر المنعم واجب، بل لأن في مخالفته ضرراً محتملاً، فمن باب دفع الضرر المحتمل يلزم إطاعته.
الملاحظة على النظرية الثالثة: دفع الضرر المحتمل هل هو حكم عقلي أو قضاء فطري وجداني؟
يوجد اتجاهان في ذلك:
الاتجاه الأول: يظهر من بعض كلمات سيدنا الخوئي قدس سره أنه حكم عقلي، العقل حاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل كما يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، ومقتضى حكم العقل هذا هو وجوب إطاعة المولى، حيث إن في مخالفته ضرراً محتملاً.
الاتجاه الثاني: وهو ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سره في كتابه «حقائق الأصول» من أن دفع الضرر المحتمل مجرد قضاء فطري وليس حكماً عقلياً.
والسر في ذلك: أن جميع أحكام العقل العملي لابد أن تدخل في الحسن والقبح، فعندما نقول بأن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل يعني أن العقل يقول دفع الضرر المحتمل حسن وعدم دفع الضرر المحتمل قبيح، فكل أحكام العقل تدخل ضمن دائرتي الحسن والقبح.
وبالتالي: هل فعلاً عدم دفع الضرر المحتمل قبيح أم لا؟ بمعنى أنه هل وراء الضرر المحتمل مفسدة أخرى نعبّر عنها بالقبح؟
فلنفترض إنساناً احتمل ضرراً، احتمل أنه إذا سلك هذا الطريق يتعرض إلى خطر كهربائي مثلا، ولكنه اقتحم الطريق ولم يبالِ بالضرر المحتمل:
فإن كان وقع في الضرر فعلاً، تبين وانكشف أن في الطريق ضرراً، فليس وراء وقوعه في الضرر شيء آخر وهو قبح الإقدام، هو وقع في الضرر ولا يتحمل أمرين: الضرر والقبح.
وإن لم يكن هناك ضرر فهل يعد عند العقلاء فعل قبيحاً؟ هو يقول لم يصبني شيء، دخلت الطريق وما أصابني شيء، فهل العقلاء يقولون نعم لم تتعرض لضرر ولكن إقدامك كان قبيحاً؟ كلا، بل يقولون إذا احتمل الإنسان خطراً في طريق فالفطرة تقضي بلزوم تجنبه؛ فإن من طبع الإنسان بمقتضى غريزته الحيوانية أن يدفع عن نفسه الضرر ويجلب لنفسه النفع.
إذاً: هذه غريزة فطرية في الإنسان وليست حكماً من أحكام العقل، فلو أن الإنسان اقتحم الطريق ولم يبالِ لم يكن اقتحامه قبيحاً.
والدليل على أن اقتحامه ليس قبيحاً عقلاً أنه لو انكشف ان الطريق لا خطر فيه فإن العقلاء يقولون الحمد لله لم يحدث شيئاً، لا أنهم يقولون لم يصبك ضرر ولكن ارتكبت قبيحاً لأنك أقدمت على الضرر المحتمل والإقدام على الضرر المحتمل قبيح.
ولو قلنا بمقالة السيد الحكيم من أن دفع الضرر المحتمل ليس واجباً عقلاً، وإنما هو قضاء فطري، وفنّدنا النظريتين الأوليين، يعني قلنا: ليس مصدر لزوم إطاعة الله هو حق الطاعة وليس هو شكر المنعم، وأما دفع الضرر المحتمل فليس حكما عقلياً وإنما هو قضاء فطري، فالنتيجة: لا يحكم العقل بوجوب إطاعة الله؛ لأن وجوب إطاعته عقلاً إما بالنظرية الأولى أو الثانية أو بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل، فإذا قلتم العقل لا يحكم بدفع الضرر المحتمل وإنما هو قضاء فطري غريزي، إذاً فنتيجة هذه النظريات ومناقشتها أن لا يوجد حكم للعقل بلزوم إطاعة المولى تبارك وتعالى، وإنما هو قضاء فطري لا أكثر من ذلك.
إذاً: من يلتزم بوجوب إطاعة المولى عقلاً، بحيث يكون ترك إطاعة المولى أمراً قبيحاً، لابد أن يرجعه إما إلى النظرية الأولى أو الثانية أو يقول بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل.
فتلخص من ذلك: أن النقضين اللذين نُقض بهما على من ينكر حجية العقل من المحدثين، وهما النقض بوجوب إطاعة المولى عقلاً والنقض بطريق إثبات النبوة بإظهار المعجز على يد مدعي النبوة، كلا النقضين تمت المناقشة فيهما في هذا الأسبوع والأسابيع الماضية.
قاعدة الملازمة
في هذا العنوان الجديد نبحث أنه إذا قلنا بأن العقل حجة في حكمه بالحسن والقبح فهل يمكن الانطلاق من نفس حكم العقل إلى حكم الشرع؟ أي أنه متى حكم العقل بقبح شيء مستقلاً اكتشفنا حكم الشرع بحرمته، ومتى حكم العقل بحسن شيء مستقلاً حكم الشرع بوجوبه، أي لا يمكن أن ننتقل من حكم العقل بشيء إلى حكم الشرع بذلك الشيء إلا إذا بنينا على قاعدة الملازمة، وهي أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، فهل أن قاعدة الملازمة ثابتة أم لا؟
لذلك لابد أن نبحث هنا في مقامين:
1. هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع؟
2. هل هناك ملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشرع؟
فنحن نبحث في مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري.
المقام الأول: الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع.
في هذا المقام نبحث عن الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع بالوجوب أو الحرمة، وقد ذكر علماؤنا في كتب الأصول أن البحث هنا يتفرع إلى جهتين:
1. هل يمكن أن يحكم الشرع على خلاف حكم العقل؟
2. هل يجب أن يحكم على وفاقه؟
فهنا جهتان: بعد أن حكم العقل مستقلاً بحسن أو بقبح هل يمكن أن يحكم الشرع على خلافه ويقول العقل مشتبه وأنا أحكم على خلافه؟ وإذا قلتم لا يمكن أن يحكم الشرع على خلاف العقل نأتي إلى الجهة الثانية وهي هل يجب أن يحكم على وفاقه؟
الجهة الأولى: هل يمكن أن يحكم الشرع على خلاف ما حكم به العقل وإن كان ما حكم به العقل حكماً عقلياً قطعياً مستقلاً ومع ذلك يحكم الشرع على خلافه ويقول العقل مشتبه؟
هنا تعرض المحقق الإصفهاني في كتابه نهاية الدراية في شرح الكفاية إلى هذا المطلب، وهو أنه هل أن الشرع يمكن أن يحكم بخلاف حكم العقل أم لا؟
قال: حكم العقل على نوعين:
1. تارة يحكم العقل على نحو العلية التامة.
2. وتارة يحكم العقل على نحو الاقتضاء لا العلية التامة.
أما النوع الأول: حكم العقل على نحو العلية التامة.
وهو مسألة حسن العدل وقبح الظلم، أي أن العقل يحكم بأن الظلم علة تامة للقبح، يعني لا يمكن ولا يعقل أن يوجد ظلم ليس قبيحاً، الظلم علة تامة للقبح، أي أنه متى ما تصور العقل ظلماً حكم بقبحه لا محالة.
وفي مثل هذا النوع لا يعقل أن يحكم الشرع على خلاف العقل؛ باعتبار أن الشرع سيد العقلاء، وأن الشرع لا يعقل أن يغفل عمّا يدركه العقلاء بما هم عقلاء، لا يمكن أن يحكم العقل حكماً قطعياً مستقلاً بقبح أو بحسن على نحو العلية التامة ومع ذلك يأتي الشرع ويحكم على الخلاف.
نعم في موارد التزاحم يمكن أن ينبه الشرعُ العقلَ على ملاك الأهم وهو ليس ملتفتاً له؛ كما لو دار الأمر بين ظلمين، إما أن تظلم هذا أو أن تظلم ذاك، هنا ليست المساحة مساحة العقل، أي الظلمين أكثر فساداً؟ أي اجتناب منهما أهم؟
لنفترض مثلاً لدينا امرأة في بطنها جنين مكتمل ذو روح، هي إنسان وهو إنسان، ودار الأمر بين موت المرأة وموت الجنين، يعني الطبي لابد أن يرتكب أحد الظلمين لا محالة، قتل المرأة ظلم وإزهاق لحق الحياة، وقتل الجنين ظلم وإزهاق لحق الحياة، هذا الطبيب لابد أن يقوم بعملية تنتج قتل أحدهما، لا يمكن إنقاذ أحدهما إلا بقتل الآخر.
العقل يقول كل منهما قبيح في نفسه، لكن أي الظلمين أكثر قبحاً بحيث يقدم العقل هذا على ذاك؟ هنا إذا لم ينكشف للعقل ما هو الأكثر فساداً والأشد قبحاً يمكن أن يتدخل الشرع ويقول قدّم الأم أو قدّم الجنين، أو ما أشبه ذلك.
إذاً: لا يمكن أن يحكم الشرع على خلاف حكم العقل، لكن يمكن أن يتدخل الشرع في موارد التزاحم لتحديد ما هو الأشد قبحاً وما هو الأكثر أهمية.
النوع الثاني: حكم العقل على نحو الاقتضاء.
في هذا النوع يكون حكم العقل بالحسن أو القبح على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية التامة، فإن العقل يقول ليس الكذب قبيحاً على نحو العلية التامة، وإنما فيه اقتضاء للقبح؛ بدليل أنه قد يتخلف في بعض الموارد، كما لو ترتب على الصدق ضرر على نفس محترمة، هنا لا يكون الكذب قبيحاً، إذا كان في الكذب صيانة لنفس محترمة عن ضرر معتد به لا يكون الكذب قبيحاً.
وفي هذا النوع يمكن أن يحكم الشرع على خلاف ما حكم به العقل؛ العقل يقول الكذب قبيح فيأتي الشرع ويقول: إلا في المورد الكذائي فإن الكذب ليس قبيحاً، هنا يمكن أن يحكم على خلاف ما حكم به العقل، باعتبار أن حكم العقل كان حكماً اقتضائياً ولم يكن على نحو العلية التامة التي لا تختلف ولا تتخلف.
إذاً: في الجهة الأولى، وهي عندما نبحث هل يمكن للشرع أن يحكم على خلاف حكم العقل؟ فصّلنا بين النوعين: ما كان على نحو العلية التامة وما كان على نحو الاقتضاء.
الجهة الثانية: إذا لم يمكن أن يحكم الشرع على خلاف حكم العقل - كما في النوع الأول - فهل يجب أن يحكم على وفاقه؟ وهذا ما يعبّر عنه بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
هنا بحث علماء الأصول: تارة نتكلم عن الملازمة الإثباتية وتارة نتكلم عن الملازمة الثبوتية، فما هو الفرق بينهما؟
الملازمة الإثباتية: في مقام الظاهر.
الملازمة الثبوتية: في مقام الواقع.
أولاً: الملازمة الإثباتية.
وهنا نعم يوجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؛ لأن الشرع لم يردع، ومادام لم يردع فهذا يعني أنه موافق لحكم العقل، لكن موافق لحكم العقل بما هو حكم عقل لا بما هو حكم شرع.
لو فرضنا مثلاً أن العقلاء بما هم عقلاء أطبقوا على قبح الغيبة، ونحن قلنا لا يمكن للشرع أن يحكم على خلافه، لم يحكم على خلافه، لكن هل يجب أن يحكم على وفاقه؟
يقولون: بما أن الشرع لم يردع فهو موافق.
هذه الموافقة تسمى ظاهرية، يعني سكوته لا يعني أكثر من أن ما حكم به العقلاء بما هم عقلاء صحيح، لا أنه حكم شرعي.
ثانياً: الملازمة الثبوتية.
نحن الآن نبحث عن الملازمة الثبوتية، بمعنى أن حكم العقلاء يستدعي حكماً من الشرع على وجوبه أو على حرمته.
مثلاً الآن في زماننا هذا يقال: يحكم العقلاء بما هم عقلاء بقبح تملك إنسان لإنسان، يعني الرق قبيح عند العقلاء، العقلاء يرون أن استرقاق إنسان لإنسان أمر قبيح.
لو فرضنا أن حكم العقلاء بقبح الاسترقاق على نحو العلية التامة، هل يجب أن يحكم الشرع على طبقه، بأن يقول يحرم الاسترقاق؟
ذكر هنا الشيخ المظفر في كتابه أصول المظفر أنه هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع على نحو الدلالة التضمنية، والمقصود أنه إذا حكم كل المجتمع العقلائي بما هم عقلاء لا بدوافع أخرى، لا بدوافع عاطفية، ولا بدوافع اجتماعية ولا بدوافع بيئية، العقلاء بما هم عقلاء، من دون أي مؤثرات خارجية، إذا حكم المجتمع العقلائي بأسره - بما هم عقلاء - على أن الاسترقاق قبيح، فالشرع حكم بحرمته.
لماذا؟
الدليل على ذلك: يقول الشيخ المظفر لأن الشارع سيد العقلاء؛ فلو تخلف عنهم لم يكن عاقلاً، وبما أنه سيد العقلاء فإذا حكم العقلاء بقبح شيء حكم هو بحرمته، وإذا حكم العقلاء بحسن شيء حكم هو بوجوبه.
هذا ما يسمى بالملازمة الثبوتية بين حكم العقل وحكم الشرع.
الملاحظة عليه: توجد هنا عدة مناقشات لهذه الملازمة، نذكر هذه الليلة إحدى المناقشات ونترك البقية إلى الأسبوع القادم.
المناقشة الأولى: ما ذكره السيد الصدر قدس سره في أصوله، من أن الحسن والقبح أمور واقعية، ليست أموراً إنشائية نحن ننشئها كما ننشئ الوجوب وننشئ الحرمة وكما أن الأب يُنشئ الأمر في حق ولده، وكما أن الدولة تُنشئ الإلزام في حق مواطنيها.
الوجوب والحرمة أمور إنشائية وأما الحسن والقبح فهي أمور نفس أمرية، يعني هي أمور مرتسمة في نفس الأمر والواقع، وليس دور العقل تجاهها إلا الإدراك، لا أن العقل يُنشئها ويصنعها، العقل يدركها، تماماً كالأمور النظرية، كما أن العقل يدرك استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين ليس شيئاً ينشئه العقل وإنما هو أمر واقعي يدركه العقل، كما أن العقل يدرك أن الإنسان ممكن وأن الله واجب الوجود العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب، حسن الأشياء ليس أمراً إنشائياً بل هو أمر واقعي.
فإذا كان الحسن والقبح أمرين واقعيين فالعقلاء أدركوا بما لديهم من عقل أن العدل حسن والظلم قبيح والاسترقاق قبيح وما أشبه ذلك، والشرع أدرك ما أدركوه؛ لأن المفروض أن الحسن والقبح أمران واقعيان، هناك ملازمة بين الإدراكين لا أن هناك ملازمة بين إدراك العقلاء للحسن والقبح وقول الشارع يجب أو يحرم؛ لأن هناك فرقاً بينهما، الحسن والقبح أمران واقعيان بينما الوجوب والحرمة أمران إنشائيان، ولا ملازمة بين الأمر الواقعي والأمر الإنشائي.
العقلاء بما هم عقلاء أدركوا حسن العدل وقبح الظلم، والشارع يدرك كما أدركوا، ولكن هذا لا يعني أن الشرع يُنشئ كما أدركوا فيُنشئ حرمة الظلم أو ينشئ حرمة الاسترقاق لأن العقلاء أدركوا قبحه، فلا ملازمة بين الأمرين؛ لأن الأمرين مختلفان سنخاً، هذا من الأمور الواقعية وهذا من الأمور الإنشائية ولا ملازمة بينهما.
يأتي الكلام في بقية المناقشات إن شاء الله في الأسبوع القادم.
والحمد لله رب العالمين.