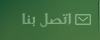بسم الله الرحمن الرحيم
﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
صدق الله العلي العظيم
حديثنا من خلال الآية المباركة في ثلاث نقاط:
- النقطة الأولى: في بيان معنى الفطرة.
- النقطة الثانية: في بيان معنى كون الدين أمرًا فطريًا منسجمًا مع فطرة الإنسان.
- النقطة الثالثة: في بيان تربية الدين للدوافع الفطرية عند الإنسان.
النقطة الأولى: ما هو معنى الفطرة؟
الفطرة هي إعداد المخلوق بأجهزة وطاقات تنسجم مع هدفه في الوجود، إذ أن لكل مخلوق هدفًا في هذا الوجود، فإذا أعد المخلوق بطاقات وأجهزة تنسجم مع هدفه، فهذا الإعداد يعبّر عنه بالفطرة. مثلاً: القرآن الكريم يتحدث عن الأرض فيقول: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾، وعندما نراجع النظريات العلمية نجدها تقول بأن الغلاف الجوي المحيط بالأرض تكوّن من المواد المشعة التي خلقها الله داخل الأرض، حيث تفاعلت هذه المواد، ونتيجة تفاعلها انبثقت الغازات الأولية، وترتبت هذه الغازات حسب كثافتها وثقلها، فصار الأكسجين والنيتروجين صار إلى الأسفل، بينما صعد الهيدروجين إلى الأعلى، وهكذا تكوّن غلافٌ جويٌ محيطٌ بالأرض من تمام جهاتها، ويتراوح هذا الغلاف تقريبًا ما بين مئة إلى مئتي ميل من ناحية مسافته.
هذا الغلاف الجوي الذي أحاط بالأرض له عدة فوائد: فهو من ناحية يمنع الأرض من خطر الشهب والنيازك، فإن هذه الشهب والنيازك إذا انفصلت عن الكواكب الأخرى فقد ترتطم بهذا الغلاف الجوي وتحترق، فلا تصل إلى الأرض، وهكذا يحمي هذا الغلاف الأرضَ من خطر النيازك. ومن ناحية أخرى: يحتوي هذا الغلاف على قوام تنفس الإنسان والحيوان، إذ أنه يحتوي على نسبة 21% من الأكسجين الذي يحتاج إليه الإنسان والحيوان في التنفس. والخلاصة: أن الأرض صارت فراشًا للإنسان، بحيث ينام فيها هادئًا مستقرًا، ببركة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، فإن هذا الغلاف ضمن للإنسان الهدوء والاستقرار، وهذه هي الفطرة. وبعبارة أخرى: الهدف من الأرض أن تكون فراشًا للإنسان، ولذلك أعد الله الأرض بأجهزة تتناسب بهذا الهدف، فأحاطها بالغلاف الجوي، وهذا إعدادٌ للأرض بجهاز ينسجم مع هدفها، وهكذا أصبحت الأرض ببركة الغلاف الجوي فراشًا ناعمًا مفيدًا للإنسان، وهذه هي الفطرة.
مثال آخر: عندما نضع بذرة شجرة التفاح في الأرض، فإن الهدف منها هو أن تصبح شجرة مثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وقد جهّز الله «تبارك وتعالى» بطاقات وخصائص حيوية وفيزيائية تستطيع من خلالها أن تتحرك وتصبح شجرة مثمرة، فهذه البذرة قد أعطيت الخصائص التي تنسجم مع هدفها في الوجود، وهذه هي الفطرة.
وكذلك هو حال الإنسان تمامًا، فكما أن الأرض والبذرة أعطيا ما ينسجم مع هدفهما، كذلك أعطي الإنسان ما ينسجم مع هدفه في الوجود، إذ أن الهدف من الإنسان هو الخلافة، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، فالإنسان هو خليفة الله في الأرض، ولذلك يقول القرآن الكريم: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ والأمانة هي خلافة الله في الأرض، والمقصود من خلافة الله في الأرض إقامة الحضارة الكونية، فإقامة الحضارة الكونية على هذه الأرض أمر مطلوب من الإنسان، وهذا هو أداء الأمانة والخلافة، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾، أي أنه جعل إعمار الأرض بيدكم، فالهدف من وجود الإنسان هو خلافة الله في الأرض، بمعنى إقامة الحضارة الكونية.
ولأن هذا هو الهدف، جُهِّز الإنسان بطاقات وبأجهزة تنسجم مع هذا الهدف، ولذلك يقول الفلاسفة: الإنسان أعطي عدة قوى: القوة العاقلة، والقوة المتخيلة، والقوة الواهمة، والقوة الأمّارة، والقوة الغضبية، والقوة اللوامة. والمقصود من القوة العاقلة: القوة المفكرة التي تستنتج الأشياء، أي أنها تنتقل من المعلومات إلى المجهولات، وهذه القوة هي التي تميز الإنسان عن سائر الحيوانات. والمقصود من القوة المتخيلة: القوة التي تركب الأشياء، كأن يتصور الإنسان مدينة أو أجهزة بتركيب شيء من شيء وتحليل شيء من شيء، فالقوة التي تركب الأشياء وتجزّئها تسمّى بالقوة المتخيلة. والمقصود من القوة الواهمة: القوة الشعورية، أي أنها القوة التي تدرك الحب والبغض والانبساط والانقباض، فيدرك من خلالها الإنسان أن فلانًا يحبه وفلانًا يبغضه، وأن أبويه يحبانه وأعداءه يبغضونه، فهي القوة التي تحمل المشاعر والعواطف والميول الإنسانية المشتركة بين الإنسان وغيره من أبناء المجتمع.
وأما القوة الأمارة فهي التي يعبّر عنها علماء العرفان بالقوة الشهوية، وهي عبارة عن مجموعة الغرائز الشهوية، كشهوة الجنس، وشهوة الطعام والشراب، وشهوة الراحة والاستقرار، وغيرها من الغرائز والشهوات، وهي التي عبّر عنها القرآن الكريم بقوله: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾. وأما القوة الغضبية فهي القوة التي تدفعه للانتقام والثأر إذا غضب. وأما القوة اللوامة فهي عبارة عن الضمير، وهو النداء الذي يؤنب الإنسان على الخطأ، ويوبخه على الرذيلة، ويعصف به إذا ارتكب الأخطاء، وهي التي عبّر عنها القرآن الكريم بقوله: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾، أي أن الإنسان إذا أذنب فإنه لا يخضع لمحكمة واحدة فقط، بل يخضع لمحكمتين: محكمة داخلية، وهي محكمة الضمير المعبّر عنها بالنفس اللوامة، وفي المقابل توجد محكمة خارجية، وهي محكمة يوم القيامة، وقد ذكر القرآن الكريم المحكمتين في عرض واحد.
والخلاصة: أن عند الإنسان عدة قوى، والغرض من هذه القوى كلها أن الهدف الذي خلق من أجله الإنسان يحتاج إلى هذه القوى، وهذا الهدف - كما ذكرنا - هو أداء الأمانة وإعمار الكون، وذلك باستخراج طاقات الكون وبركاته. إذن فالمقصود من الفطرة: إعداد الإنسان بقوى وطاقات تنسجم مع هدفه الكبير، وهو إقامة الحضارة على الأرض.
النقطة الثانية: ما معنى فطرية الدين؟
الآية المباركة تقول: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ﴾، أي أن الدين أمر فطري، والمقصود من فطرية الدين أن لكل جهاز نظامًا يناسبه، وحتى يتضح هذا المعنى نضرب بعض الأمثلة.
المثال الأول: الإنسان يملك داخله جهازًا هضميًا، والمناسب لهذا الجهاز الهضمي هو الغذاء النباتي؛ فإن الغذاء النباتي - كما يقول الأطباء - أكثر مناسبة للجهاز الهضمي عند الإنسان من الغذاء الحيواني، فهناك جهاز، وهناك نظام يتناسب مع هذا الجهاز. ولذلك نقرأ قول أمير المؤمنين  : ”لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات“، أي أن الجهاز الهضمي الموجود عند الإنسان يحتاج إلى الغذاء النباتي أكثر من ملاءمته للغذاء الحيواني، فالإمام علي لا يتكلم عن فراغ.
: ”لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات“، أي أن الجهاز الهضمي الموجود عند الإنسان يحتاج إلى الغذاء النباتي أكثر من ملاءمته للغذاء الحيواني، فالإمام علي لا يتكلم عن فراغ.
المثال الثاني: كما أن عند الإنسان جهازًا هضميًا، كذلك عنده مجموعة من المشاعر والعواطف، وكما يقول الفلاسفة: الإنسان مخلوقٌ إحساسيٌ، أي أنه يعيش كتلة من المشاعر والعواطف، ولذلك فإنه يحب ويكره ويميل وينقبض وينبسط وينفتح، فيعيش داخل هالة من المشاعر والعواطف، فهو مخلوق عاطفي شعوري إحساسي، وإذا كان الإنسان يملك طاقة من العواطف فإن النظام المناسب لهذه الطاقة من العواطف هو العلاقة الزوجية، فإن العلاقة الزوجية هي التي تغذي المشاعر والعواطف، ولذلك فإن القرآن الكريم يؤكد على العلاقة الزوجية، فيقول: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أي أنه خلق شيئًا يتناسب مع أنفسكم وينسجم مع طبيعة كيانكم ويتلاءم مع عواطفكم ومشاعركم.
وقد يتمادى البعض منا - مع الأسف - في العلاقات غير المشروعة، فيكون يومًا مع هذه الفتاة، وآخر مع تلك الفتاة، وثالثًا مع الفتاة الثالثة.. فما دامت الفتيات معروضة أمامه بأزيائها ومفاتنها وبهرجتها وإغرائها وإثارتها، فإنه يتنوع بحسب ما يشاء، ويختار ما يشاء، فيومًا مع هذه وآخر مع تلك! ما دامت الأجواء مملوءة بالإغراءات والإثارات والمحركات فإنه يتنوع ويتنقل بين الفتيات كما يشاء!
هذه العلاقة المتنوعة المتغيرة لا تغذي مشاعر الإنسان وعواطفه، بل تبقيه دائمًا في حالة توتر وقلق واضطراب وهيجان، فيبقى الإنسان يعيش مشاعر متوترة وعواطف مضطربة قلقة، فلا تهدأ عواطفه، ولا تستقر مشاعره، إلا مع العلاقة الزوجية، ولذلك يقول القرآن الكريم: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أي أن السكون والاستقرار في العواطف والمشاعر يتحقق بالعلاقة الزوجية، وعلى ذلك فالنظام الذي يناسب العواطف هو العلاقة الزوجية.
نأتي للإنسان: الإنسان مركب من عنصرين: عنصر المادة - وهو الجسم - وعنصر الروح، فما هو النظام المناسب للإنسان؟ النظام المناسب للجهاز الهضمي هو الغذاء النباتي كما ذكرنا، والنظام المناسب للعواطف والمشاعر هو العلاقة الزوجية، ولكن ما هو النظام المناسب للإنسان المكوّن من عنصرين: عنصر روح وعنصر مادة؟
الدين هو النظام المناسب لتركيبة الإنسان من روح وجسد، وهذا هو معنى كون الدين أمرًا فطريًا، فعندما نقول بأن الدين فطري فالمقصود من ذلك أن الدين منسجمٌ مع طبيعة الإنسان وتركيبه من العنصرين: الروح والمادة. مثلاً: لو كان عندي خمس مئة ألف درهم، وأردت أن أستثمر أموالي في السوق، وذلك من خلال إنشاء مصنع ينتج بعض الأجهزة الكهربائية التي يحتاج الناس إليها، فأنا عندما أفكر في مشروع تجاري استثماري فإنني أدرس المشروع أولاً، ودراسة المشروع تتحقق بدراسة الموازنة بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع، وفي عملية التوزيع أيضًا لا بد من دراسة الموازنة بين مستوى العرض ومستوى الطلب، فالموازنة بين الإنتاج والتوزيع من ناحية، والموازنة بين العرض والطلب من ناحية أخرى، فحينئذ يكون المشروع مشروعًا مثمرًا منتجًا.
ولكن هذا بوحده لا ينسجم مع نظام الإنسان الداخلي؛ إذ أن العلم يقول بأن الإنسان مركب من بدن وروح، فلا يكفي أن يدرس المشروع دراسة تجارية اقتصادية فقط، بل لا بد من دراسة المشروع من زاوية أخرى يعالج بها الروح، فلا بد من دراسة المشروع بنحو يحقق الموازنة بين الحركة السوقية والحركة الروحية الداخلية، وهذه الموازنة لا تتحقق من خلال النظام الرأسمالي، فإنه يهتم بالجانب الاقتصادي فقط، ولا يهتم بالأخلاق والروح والقيم، بل يضعها على جانب ولا يفكر فيها، بينما النظام الإسلامي يقول: كما أن الإنسان يقوم بدراسة موازنة بين الإنتاج والتوزيع وبين العرض والطلب، كذلك لا بد من أن يقوم بموازنة أيضًا بين السوق والروح، بحيث لا تكون السوق على حساب الروح، ولا الروح على حساب السوق، ولذلك يقول الإمام الحسن المجتبى  : ”اعمل لدنياك كأن تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا“.
: ”اعمل لدنياك كأن تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا“.
للأسف الكثير منا له شخصيتان: في السوق له شخصية، وفي المحراب له شخصية أخرى، فهو في المحراب رجل عابد متضرع إلى الله، وفي السوق رجل مشاكس مرابي غشاش يختلس الأموال من أي طريق كان، فهو يعيش ازدواجًا في الشخصية، فهو في السوق بشكل، وهو في البيت والمحراب بشكل آخر، بينما القرآن والدين يقول: أنت - أيها الإنسان - مركب من مادة وروح، فعليك أن تدرس المشاريع بما يضمن الموازنة بين المادة والروح. إذن فالنظام الديني هو النظام المنسجم مع تركيبة الإنسان.
مثال آخر: الكثير من الناس يقولون: ماذا أفعل؟! لا أستطيع الامتناع عن الربا! أنا عندما أودع مئة ألف درهم في البنك فكيف لي أن أقول: أنا لا أريد فائدة؟! لا أستطيع! لا بد من اشتراط الفائدة! وهذا ربا؛ لأن الإيداع قرض، واشتراط الفائدة في الشرط ربا، وقد اعترض المشركون في أول الإسلام على تحريم الربا، وهذا الاعتراض نفسه يطرحه بعض الناس الآن حتى من المسلمين، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. ما هو الفرق؟! أنا يجوز لي أن أشتري سيارة بمئة ألف ثم أبيعها بمئة وعشرين ألفًا، وكما أفعل ذلك كذلك أعطي البنك مئة ألف وآخذه منه مئة وعشرين! فما هو الفرق بين البيع والربا؟! كيف يمنعنا الإسلام من أخذ الفائدة؟! كيف يمنعنا الإنسان من الربا؟!
أنا عندما أقرضك مئة ألف درهم، وأنت تستسلمها وتستثمرها، فإنني أكون بذلك مخاطرًا بأموالاً، فقد ترجع وقد لا ترجع، وبما أنني خاطرت بأموالي فإن عنصر المخاطرة له قيمة سوقية، فلماذا يلغي الإسلام القيمة السوقية لعنصر المخاطرة ولا يحترمها؟! لماذا لا يضمن لي الإسلام القيمة السوقية لعنصر المخاطرة؟! هذا الإشكال يطرحه الكثير من علماء الاقتصاد، والجواب عنه:
أولاً: لو جوّزنا عنصر المخاطرة لجوّزنا القمار، إذ لا توجد مخاطرة أعظم من القمار، فإذا قلنا بأن عنصر المخاطرة له قيمة، فلا بد من تحليل القمار؛ لأن الإنسان في القمار يخاطر بأمواله أكثر مما يخاطر بها في الإيداع والقرض.
ثانيًا: الإسلام يقول بأن عنصر المخاطرة مضمون، وذلك من خلال الرهن، فإن أقرضتَ فلانًا مئة ألف فخذ سيارته أو صك بيته أو عمارته رهنًا، وأخذ الرهن هو الذي يؤمّن عنصر المخاطرة، فعنصر المخاطرة لا يتوقف تأمينه على الفائدة الربوية حتى يقال بأن الربا لا بد منه لضمان عنصر المخاطرة.
ثالثًا: الإسلام عندما يحرّم الربا ويشدّد في حرمته، ويقول: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾، فإنه يريد أن يربينا على روح البذل والعطاء، لا روح الأنانية والبخل والقبض، وعندما نقرأ الآيات القرآنية نجد أنها تقارن بين الربا وبين الصدقة، فتجعل الربا مقابل الصدقة؛ لأن تأثيرهما متعاكس، إذ أن الإنسان إذا تعود على الربا فقد تعود على الأنانية والشره والنهم نحو الأموال، فالربا يجعل الإنسان يختزن الأموال حتى يصبح طاغية، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾، بينما الصدقة تعوّد الإنسان على البذل والعطاء والغيرية والروح الاجتماعية، ولذلك القرآن الكريم يقول: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾.
الإنسان - كما ذكرنا - مركب من عنصرين: عنصر المادة الذي يقول: أعطني ربا، وعنصر الروح الذي يقول: إياك والربا حتى أتعود على العطاء والبذل، فمن أجل الموازنة بين الروح والمادة حرّم الإسلام الربا، فالنظام الديني نظامٌ فطريٌ؛ لأنه ينسجم مع طبيعة الإنسان المركّبة من الروح والمادة.
النقطة الثالثة: كيف نربي دوافعنا على ضوء الدين؟
الآية المباركة تقول: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ أي: اجعل خطك مستقيمًا مع خط الدين، بحيث لا تنحرف يمينًا ولا شمالاً، ومعنى ذلك أن نربي دوافعنا على ضوء الدين، وأن نجعل دوافعنا على نهج الدين، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان تقسيم يذكره علماء النفس، حيث يقسّمون إلى قسمين: دوافع أولية، ودوافع ثانوية، فما هو الفرق بينهما؟
الدوافع الأولية هي الدوافع العضوية الفسيلوجية التي تنبع من داخل الإنسان ومن ذاته، أي أنها الدوافع التي يحصل عليها الإنسان من دون تعلم ولا اكتساب، فلا يكتسبها من بيئة ولا من أسرة، كدافع الإنسان نحو الطعام والراحة والتنفس مثلاً. وفي المقابل توجد دوافع ثانوية، وهي الدوافع السكيلوجية، أي أنها الدوافع التي يكتسبها الإنسان من بيئته وأسرته، كدافع الإنسان نحو الأمن، ودافعه نحو الانتقام، ودافعه نحو الجاه الاجتماعي والشهرة الاجتماعية. وحتى تتضح كيفية تربية الدوافع على ضوء الدين نضرب بعض الأمثلة.
الدافع الأول من الدوافع الثانوية: دافع الإنسان نحو الأمن.
الإنسان وإن كان متغطرسًا فإنه يخاف، بل إن الإنسان يعيش الخوف منذ أن يفهم الحياة، ولذلك يقول القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾، فالإنسان يخاف بطبيعته، والخوف أمر داخلي عند الإنسان، فهو من الدوافع الموجودة عند الإنسان، لا سيما إنسان هذا الزمن، فإن إنسان هذا الزمن ليس أشجع ولا أقوى، بل هو أكثر خوفًا من إنسان الأزمنة السابقة، وذلك لأن الإنسان الآن يسمع عن الأمراض الخطيرة - كالسرطان والإيدز - فيخاف، ويسمع عن كوارث الطبيعة - كالزلازل والبراكين - فيخاف، ويسمع بالإشعاعات النووية التي تودي بالملايين فيخاف، ويسمع بالأسلحة الفتاكة والحروب الطاحنة فيخاف، ويسمع عن المجاعات التي تقتل الملايين في إفريقيا وغيرها فيخاف، فهذا العصر وإن كان عصر التقدم التكنلوجي، وإن كان عصر التعملق في الفضاء، وإن كان عصر الهيمنة على الكون، إلا أنه عصر الخوف والقلق والاضطراب.
الإنسان دائمًا ما يعيش في خوف وقلق، فبمجرد أن يسمع عن شيء يصاب بالخوف والقلق: كيف أؤمن حياتي؟ كيف أحفظ وجودي؟ كيف أضمن بقائي؟ الإنسان قلق على وجوده وبقائه واستقراره، فمن أين الضمان؟ ومن أين التأمين؟ ماذا تصنع الأنظمة؟! هل تؤمن حياة الإنسان؟! النظام الرأسمالية والنظام الاشتراكي وغيرها من الأنظمة الوضعية لا تؤمن للإنسان البقاء ولا توفر له الاستقرار النفسي، فكيف نحصل على الهدوء النفسي والطمأنينة النفسية؟!
هناك يأتي الدين: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، وعن الإمام الصادق  : ”من أعطى ثلاثًا أعطي ثلاثًا: من أعطى الشكرَ أعطي الزيادة؛ لأن الله يقول: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة؛ لأن الله يقول: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية؛ لأن الله يقول: ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾“.
: ”من أعطى ثلاثًا أعطي ثلاثًا: من أعطى الشكرَ أعطي الزيادة؛ لأن الله يقول: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة؛ لأن الله يقول: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية؛ لأن الله يقول: ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾“.
إذن فالتوكل على الله أمرٌ دينيٌ فطريٌ يؤمّن لنا الحاجة نحو الأمن ويؤمن لنا الاستقرار النفسي، وقد شاهدتُ مشاهد كثيرة ولعلكم رأيتم أيضًا.. إذا صعدنا على متن الطائرة مسافرين إلى بلد غربي يستغرق الذهاب إليه ساعات طويلة، فإن الناس بمجرد أن تهتز الطائرة وتتعرض لمطبات هوائية يدخلون في حالة الجزع والقلق وعدم الاستقرار، بينما المتدينون يكونون مطمئنين مستقرين منقطعين إلى الله «تبارك وتعالى»، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين  :
:
| رضيتُ بما قسم الله لي كما أحسن الله فيما مضى |
وأوكلت أمري إلى خالقي كذلك يحسن فيما بقي |
إبراهيم الخليل «عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام» لما كسّر الأصنام والأوثان ألقي في وسط النار.. الإنسان لا يستطيع حتى أن يضع عودًا شخاطًا ملتهبًا على يده، فكيف به إذا ألقي في وسط النار؟! أقبلت الملائكة زحفًا إلى نبي الله إبراهيم، فجاءه ملك الرياح وقال: يا إبراهيم، إن شئت طيّرت لك النار وحولتها إلى هواء، قال: ليست لي عندك حاجة، فجاءه مرض الأمطار وقال: يا إبراهيم، إن شئت أمطرت السماء على النار فأخمدتها، قال: ليس عندي إليك حاجة، فجاءه جبرئيل وقال: يا إبراهيم، إن شئت أخذت بيدك واقتلعتك نحو السماء، قال: ليس عندي إليك حاجة، قال: إذن حاجتك عند من؟! قال: حاجتي عند ربي، قال: إذن ادعُ ربك، قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ حتى اصطكت أسنانه من شدة البرد.
الدافع الثاني: دافع الانتقام.
علماء النفس يقولون بأن القوة الغضبية تجعل عند الإنسان دافع الانتقام، فبمجرد أن يُخْدَش في كرامته يثأر، وبمجرد أن يهان يغضب، وبمجرد أن يتعرض لإساءة ينفعل، فكيف نربي هذا الدافع؟ كيف نعالج هذا الدافع علاجًا فطريًا؟
الدين يقول: الغضب على قسمين: غضب شخصي، وغضب مبدئي. إذا أسيء إلى شخصك فحاول ألا تغضب، وحاول ألا تنفعل، وحاول أن تضبط أعصابك، فقد ورد أن جارية للإمام الحسين كانت تصب الماء من الإبريق على يدي الإمام، فانفلت الإبريق من يدها ووقع على الحسين وشجه، فرفع الإمام طرفه إلى الجارية، فقالت له: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، فقال: أنتِ حرة لوجه الله.
الإنسان عليه في المواقف الشخصية أن يضبط أعصابه، وأن يهدّئ من حالة الانفعال عنده، وعليه أن يحاول أن يعالج الغضب، فقد ورد عن الرسول  : ”الغضب جمرة الشيطان، توقد في قلب ابن آدم“، وعنه
: ”الغضب جمرة الشيطان، توقد في قلب ابن آدم“، وعنه  : ”الغضب نوعٌ من الجنون؛ لأن صاحبه يندم، وإن لم يندم فجنونه مستحكم“، ولأن الغضب جنون نجد الرجل عندما يغضب قد يصفع ولده أو يضرب زوجته، والمرأة عندما تغضب قد تشتم زوجها، بل قد يغضب الإنسان فيرتكب جريمة في الشارع، ولذلك على الإنسان أن يهدّئ الغضب الشخصي. وقد ورد عن الإمام الحسن الزكي
: ”الغضب نوعٌ من الجنون؛ لأن صاحبه يندم، وإن لم يندم فجنونه مستحكم“، ولأن الغضب جنون نجد الرجل عندما يغضب قد يصفع ولده أو يضرب زوجته، والمرأة عندما تغضب قد تشتم زوجها، بل قد يغضب الإنسان فيرتكب جريمة في الشارع، ولذلك على الإنسان أن يهدّئ الغضب الشخصي. وقد ورد عن الإمام الحسن الزكي  : ”إن لم تكن حليمًا فتحلّم“.
: ”إن لم تكن حليمًا فتحلّم“.
وأما إذا أهينت مبادئك، أو أهين دينك، أو أهينت عقيدتك، أو أهينت أرضك ووطنك، فعليك أن تغضب لمبادئك؛ فإن الغضب للمبادئ هو الذي يمدحه الإسلام، كما قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، أي أنهم يغضبون لمبادئهم ولكنهم لا يغبضون لشخصياتهم، وهذا هو علاج الغضب.
الدافع الثالث: دافع الإنسان نحو الجاه.
كل شخص منا يحب أن تكون له قاعدة اجتماعية، وأن يكون له جاه اجتماعي، وأن تكون له سمعة حسنة في المجتمع، فكيف نغذي هذا الدافع نحو الجاه والشهرة؟
الإسلام يعلمنا كيف نغذي هذا الدافع، فيقول لنا: ”خير الناس من نفع الناس“، فمن أراد أن يكوّن شهرة صحيحة، ومن أراد أن يكوّن جاهًا اجتماعيًا مبنيًا على أسس صحيحة، فعليه أن يخدم الناس وأن يقضي حوائجهم. مثلاً: إذا صار الإنسان موظفًا، وجلس على ذلك الكرسي والطاولة، فإنه لا يفكر في الناس! بل لا يهتم إلا بجيبه وبطنه، ولا يهتم إلا بوظيفته وراتبه، وأما قضاء حوائج الآخرين وإغاثة المؤمنين ومساعدتهم فلا تهمه أبدًا، والحال أن هذا خطر كبير؛ فإن القرآن الكريم والنصوص الشريفة تؤكد على خدمة المؤمنين.
ولذلك ورد عن الرسول  : ”من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى حاجته، ونودي من بطنان العرش: ثوابك الجنة“، فعلى الإنسان أن يستغل وظيفته في خدمة المسلمين، لا أن يستغلها في التكبر والغطرسة على الآخرين. وإذا أراد الإنسان أن يمتلك جاهًا اجتماعيًا، فعليه أن يقيم المشاريع الخيرية التي تنفع المجتمع الإسلامي، وتنفع الأمة الإسلامية، ولذلك صار علي بن أبي طالب عليًا، حيث خدم الإنسانية ببطولاته وبأخلاقه وقيمه وعلمه ومعارفه، وصار الحسين حسينًا لأنه فجّر صورة إنسانية خدم بها الإنسانية جمعاء، وصار مسلم بن عقيل مسلمًا لأنه تمتع بالإيثار، حيث آثر الحسين على نفسه، وضحى بنفسه في سبيل مبادئه وعقيدته.
: ”من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى حاجته، ونودي من بطنان العرش: ثوابك الجنة“، فعلى الإنسان أن يستغل وظيفته في خدمة المسلمين، لا أن يستغلها في التكبر والغطرسة على الآخرين. وإذا أراد الإنسان أن يمتلك جاهًا اجتماعيًا، فعليه أن يقيم المشاريع الخيرية التي تنفع المجتمع الإسلامي، وتنفع الأمة الإسلامية، ولذلك صار علي بن أبي طالب عليًا، حيث خدم الإنسانية ببطولاته وبأخلاقه وقيمه وعلمه ومعارفه، وصار الحسين حسينًا لأنه فجّر صورة إنسانية خدم بها الإنسانية جمعاء، وصار مسلم بن عقيل مسلمًا لأنه تمتع بالإيثار، حيث آثر الحسين على نفسه، وضحى بنفسه في سبيل مبادئه وعقيدته.